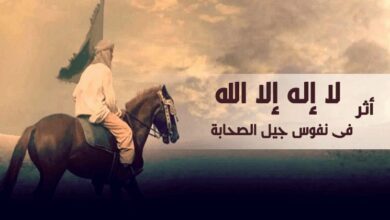كيفية ثبوت العقيدة عند المسلمين
العقيدة لغةً واصطلاحًا
ذكر في لسان العرب([1]) معنى عقد: وعَقَدَ العهد واليمين يعقدها عقدًا: أكدها أبو زيد في قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} ([2])، وعاقدت أيمانكم، وقد قرئ عقدت بالتشديد ومعناه التوكيد والتغليظ كقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}([3]) في الحلف أيضًا، وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم.
المعاقدة: المعاهدة والميثاق، والأيمان جمع يمين القسم. وقال عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد. والعقد: العهد، والجمع عهود وهي أكّد العهود. والمعاقدة: المعاهدة. وعاقده: عاهده وتعاقد القوم: تعاهدوا. وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}([4]). قيل هي العهود، وقيل هي الفرائض التي ألزموها، قال الزجاج: أوفوا بالعقود التي عقدها الله تعالى لهم.
لذا نجد أنّ لفظ العقيدة بمعنى الوفاء والعهد والمعاهدة ليس معناه التصديق. فالقرآن الكريم استعمل لفظ الإيمان ومثله في الحديث الشريف، بمعنى التصديق.
مصطلح العقيدة([5]):

لم يُذْكَر اسم العقيدة كعِلْم في القرن الأول الهجري، لذا قد سمي هذا العلم بأسماء كثيرة منها:
1 ـ الفقه الأكبر: كما سماه أبو حنيفة في الكتاب المنسوب إليه (الفقه الأكبر)؛ حيث ذكر أنّ الفقه في الدين هو الأصل حيث عاد إلى حديث رسول الله ﷺ: «من يُرِدْ الله بِهِ خيرًا يُفَقِّهه في الدين»([6]).
2 ـ علم الكلام: وقد ظهر هذا العلم حين ظهور فرقة المعتزلة([7]) التي اشتهرت في عهدهم فكرة أنّ القرآن الكريم مخلوق، وقد أخذت هذه الفكرة من مسألة كلام الله تعالى، وهل كلام الله تعالى أزلي قائم بذاته أم مخلوق حادث؟؟ فسمّي هذا العلم بعلم الكلام.
3 ـ أصول الدين([8]): كما سماه البزدوي([9]) والبغدادي([10]). وسمّي هذا العلم بعلم أصول الدين لأنّ الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، فالإيمان هو أصل المعارف الدينية الذي يرتكز عليه الدين، ومسائله هي القواعد التي لا يصح الإيمان بدونها، وهذا اسم يصحّ أن يكون مقابل أصول الفقه الذي يبحث في قواعد الاجتهاد وأحكامه وما يتعلّق بمصادر التشريع.
4 ـ علم التوحيد: كما سمّاه ابن تيمية([11]) ومحمد بن عبدالوهاب([12]). وسمّي هذا العلم بعلم التوحيد؛ لأنّ أصل معنى التوحيد اعتقاد أنّ الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم جعل هذا الاسم «علم التوحيد» علمًا لهذا العلم تسمية له بأهم مباحثه وأشرف قضاياه، وهي التوحيد والصفات الإلهية.
5 ـ علم العقيدة أو علم العقائد: كما سمّاه النسفي([13]) والبيهقي([14]). وسمّي هذا العلم بعلم العقائد أخذًا من عقد الحبل وغيره إذا أحكم بشدة.
وقد وضع العلماء عدة تعريفات للعقيدة في الاصطلاح، منها:
أنّ هذا العلم (علم الدين) يتطلّب إقامة الدليل عليه من القرآن الكريم أو السنة النبويّة (الأدلّة النقلية)، أمّا علم التوحيد في الاصطلاح السائد في عصر النبوّة فهو كالتالي:
أفرد الإمام البخاري بابًا في الصحيح بعنوان كتاب التوحيد ، قال فيه: (باب ما جاء في دعوة النبي ﷺ أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى). ثم عقّب بحديث ابن عبّاس رضي الله عنه يقول: لما بعث النبي ﷺ معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له: «إنّك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلّوا فأخبرهم أنّ الله تعالى قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فتردّ على فقيرهم، فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم، وَتَوَقَّ كرائم أموال الناس»([15]).
وفي رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنّ النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن، فقال: « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله ، فإذا هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم»([16]).
وقد ذكر ابن خزيمة([17]) في كتابه التوحيد([18]) وكتاب إثبات صفات الربّ عز وجل مما أثبت فيه أن توحيد الله عز وجل هو بتوحيد صفاته وأسمائه.
وبذلك عرّفوا التوحيد على أنّه أوّل واجب للمعرفة هو توحيد الله، وللرسول ﷺ هو الرسالة والنبوّة. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله ﷺ على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له جلّ جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما جاء على لسان رسول الله ﷺ، وعليه كانت عقيدة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة .
فالمقصود بعلم التوحيد في الاصطلاح: هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية، وإثبات العقائد الإيمانية بأدلّتها النقليّة والعقليّة، والردّ على المبتدعين في العبادات، والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية([19]).
وعرّفها أبو بكر الجزائري فقال: العقيدة هي مجموعة من قضايا الحقّ البدهيّة المسّلمة بالعقل والسمع، والفطرة، يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازمًا بصحتها، قاطعًا بوجودها وثبوتها، لا يرى خلافها أنّه يصح أن يكون أبدًا([20]).
وعرفها عمر سليمان الأشقر فقال: «والعقيدة ليست أمورًا عمليّة، بل أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأنّ الله أخبره بها بطريقة كتابه، أو بطريق وحيه إلى رسوله ﷺ»([21]).
وعرّفها غيرهم من علماء عصرهم؛ فقد اصطلحوا عدة معان للعقيدة منها:
العقيدة هي ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، أو هي الجانب النظري -العلمي- الذي يطلب الإيمان به إيمانًا لا يرقى إليه الشك، ولا تؤثر فيه شبهة كعقيدة واجب الوجود الله واتصافه بالكمالات، وتنزيهه عن النقائص، ونزول الوحي، وإرسال الرسل ونحو ذلك([22]).
أركان العقيدة الإسلامية

أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوحيد والعقيدة لأنّها قضايا تتعلق بالقلب. حيث صنّف التوحيد إلى نوعين بناء على النصوص القرآنيّة والأحاديث النبوية جملة وتفصيلًا.
ويذكر علماء السلف الصالح أنّ حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر بما جاء به رسول الله ﷺ من وحي السماء؛ إمّا في القرآن الكريم أو بأحاديثه الصحيحة المنقولة عن العدول، وتنفيذ الأمر بما جاء به رسول الله ﷺ من عند الله .
وقد بيّن ذلك ابن القيّم وغيره من علماء السلف أنّ جماع الدين: تصديق الخبر وطاعة الأمر، وأنّ أساس التوحيد والهداية التي منّ الله بها على الموحّدين، يترتّب على تصديق خبر الله، من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله.
ثم قال: «وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه، المانعة من كمال التصديق، وأن لا يخمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغيّ الواردة عليه، المانعة من كمال الامتثال»([23]).
لذا ما ورد في حديث جبريل عليه السلام مع رسول الله ﷺ حين سأله عن الإيمان أجابه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشرّه. ولقد فسر علماء السلف أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان .
وفسرت أركان الإيمان: ومعنى أركان: جمع ركن، وركن الشيء جانبه الأقوى، وكما أنّ كل بناء لا يقوم إلا على أسس قويّة ثابتة، كذلك فإنّ بناء هذا الدين لا يقوم إلا على تلك الأركان.
وقضيّة الإيمان هي القضية الأولى التي جاء النبيون والمرسلون لأجلها، والتي نزل الوحي الكريم لتثبيتها، والتي كانت محور الرسالات كلّها، كما كانت محور رسالة رسول الله ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، فلقد جاء القرآن الكريم وجاءت السنة الشريفة لتعالج هذه القضية الكبرى، وتوضحها وتبينها بيانًا كاملًا، بيانًا للبشرية كلّها، بيانًا خاتمًا لا بيان بعده. وجاءت سائر القضايا التي يعرضها منهاج الله ـقرآنًا وسنةـ مرتبطة بهذه الحقيقة الأولى الكبرى، وتقوم عليها قيامًا كاملًا، فلا استقرار لها بدونها، ولا قوة ولا كيان.
ولقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة هذه القضيّة في كل سورة من سوره، وألحّ عليها إلحاحًا شديدًا في كل سورة كذلك، حتى تظل هذه القضيّة هي أهم قضيّة في حياة الإنسان على الأرض. قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ *}([24]).([25]).
ولقد أفرد البخاري في أوّل صحيحه عن كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *}([26]). وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *}([27]).
أمّا في صحيح مسلم فقد ورد في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرّي ممّن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقّه في رواية عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد، حتى جلس إلى النبيّ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت، إن استطعت إليه سبيلًا»، قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه». قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: «أن تلد الأمة ربّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال ثم انطلق فلبثت مليًّا، ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم.»([28]).
والشاهد من الحديث هو أنّ أركان الدين ثلاثة ومن ضمنها معرفة أشراط الساعة، وأنّ أركان الإيمان ستّة أقسام من ضمنها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرّه. ولقد ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين، هم الذين يؤمنون بالغيب {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ *}([29]). أمّا في أواخر سورة البقرة فقال الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *}([30]).
وقد فسّر ابن كثير (يؤمنون بالغيب) في تفسيره فقال([31]): قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولًا واعتقادًا وعملًا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل.
والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل (قلت) أمّا الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك. كما قال تعالى: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}([32])، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}([33]).
وكذلك إذا استُعمل مقرونًا مع الأعمال كقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}([34]). فأمّا إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعيّ المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملًا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيده وغيرهم قولاً واحدًا إجماعًا: «أنّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص».
أمّا الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أنّ مراد الجميع: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله([35]).
والغيب هو كل شيء غاب عن حواسنا. فمثال على ذلك أرواحنا السارية في أجسامنا، لا نسمعها ولا نراها ولا نلمسها ومع ذلك هي موجودة فينا حقًا، نؤمن بها ونحرص عليها كل الحرص، وغيرها الكثير من العوالم الغيبية التي لا نراها ولكن يجب الإيمان بوجودها. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يحدّث به قول رسول الله ﷺ عن جبريل عليه السلام، أن نؤمن بأركان الدين ومن أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، أي يجب أن نؤمن بكل أمر غيبيّ أخبر عنه رسول الله ﷺ.
لقد أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن الغيب فقال: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ}([36]). وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}([37]).
ومن هذه الغيبيّات التي أخبر عنها رسول الله ﷺ، فقد روى البخاري في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: «لقد خطبنا النبي ﷺ خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه، وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه»([38]).
فالإيمان بالغيب أساس الاعتقاد الديني. بل إنّه يُعدّ من أبرز خصائص التوحيد لله سبحانه وتعالى، والإيمان بالغيب دعا إليه جميع الأنبياء والرسل، من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد ﷺ. فالغيب هو الذي أخبرت به الرسل الكرام هو كل أمر يمكن مشاهدته والإحساس به بعد الموت وفي الدار الآخرة، ومن الأمور الغيبية ما قصّه الله علينا من قصص الأولين، قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}([39]).
وقال تعالى في قصّة يوسف عليه السلام: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ}([40]). ومن الأمور الغيبية ما سيحدث في يوم الساعة وهو يوم القيامة، وقد ثبت أنّ جميع الرسل والكتب السماويّة جاءوا لإنذار أقوامهم باليوم الآخر. قال تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ}([41]). وقال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى *صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}([42]).
الإيمان باليوم الآخر رأس هذه المقاصد، وأصل من أصول الإيمان وأركانه كما قال تعالى: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}([43]). فالحصول على البرّ، لا يتحقّق إلا بالإيمان باليوم الآخر؛ ولذلك فإنّ للإيمان أثرًا عظيمًا على الإنسان في الدنيا والآخرة. فإنّ الإيمان باليوم الآخر والإكثار من ذكره، والتصديق الجازم بوقوعه، يزيد إيمان الإنسان ويجعله من المتّقين، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب ، فقد رتّب الله عز وجل حصول التقوى والفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون (3) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون (4) أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (5)} ([44]). ولمّا كان الإيمان باليوم الآخر من الأمور الغيبيّة، أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على الإيمان به بأمور كثيرة، ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة، فإنّ الغيب إذا ربط بالأمور المحسوسة سهل به على الإنسان، ومن هذه الأمور المحسوسة التي تعين على الإيمان باليوم الآخر، أشراط الساعة.
وأهميّة معرفة هذه الأشراط والأمارات، تظهر من أهميّة الإيمان باليوم الآخر، ولذلك فإنّ الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر، والذي هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب.
والحديث عن أشراط الساعة مهمّ، ولا سيّما إذا ابتعد الناس عن تذكّر الآخرة وانشغلوا بالدنيا وملذاتها، فإنّ في أشراط الساعة المحسوسة التي تظهر ويراها الناس بأعينهم كما أخبر النبي ﷺ، ما يعيد الناس إلى ربّهم ويوقظهم من غفلتهم([45]).
يقول القرطبي: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في تقديم الأشراط ، ودلالة الناس عليها، تنبيه الناس من رقدتهم وحثّهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة، قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدّوا للساعة الموعود بها والله أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها([46]).
وقيام الساعة قد أخفي وقت وقوعه، ولكن لها أشراط وعلامات، قال تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}([47]). قد شرحها ابن حجر العسقلاني: المراد بأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة . ومن هذه الأشراط في حديث عمر بن الخطاب حين قال رسول الله ﷺ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». وقد ذكر السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار» عن علامات الساعة: الآيات في ذلك كثيرة، وأمّا الأحاديث فلا تكاد تحصى.
ولما كان أمر السّاعة شديدًا وهولها مزيدًا وأمرها بعيدًا؛ كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها. ولهذا أكثر النبي ﷺ من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عمَّا بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة، ونبَّه أمّته وحذّرهم ليتأهبّوا لتلك العقبة الشديدة. واعلم أنّ أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي يعقبها الساعة، وأنّها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها([48]).
لذا حاجة الناس خاصّة في هذا العصرـ إلى معرفة أشراط الساعة؛ أوّلًا: تسهم في توجيه سلوكهم إلى سبيل الخير والاستعداد ليوم المعاد. ثانيًا: وجود بعض الكتّاب في هذا العصر، الذين أخذوا يشكّكون في بعض الأمور الغيبيّة، التي أخبرنا رسول الله ﷺ عنها، ومنها أشراط الساعة ، زاعمين أنّ هذا ينافي العقل ويصادمه. وهذه حجّة واهية تدلّ على عدم الإيمان بالغيب وعلى عدم تعظيم أمر الله وأمر رسول الله ﷺ.
مناط الحكم في الاعتماد على الأدلّة النقلية في إثبات الأمور الغيبية

الإيمان بالغيب
علم الغيبيّات من الأمور التي استأثر الله تعالى بها، واختصّ بها نفسه جلّ وعلا، دون سواه من ملك مقرّب أو نبيّ مرسل. وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى شاء وإذا شاء. وبذلك جاءت الآيات والأحاديث، قال سبحانه وتعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا *إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا}([49]). {وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}([50]). {وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ}([51]).
وقوله تعالى لنبيّه محمد ﷺ: {قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ}([52]). يقول الإمام الطبري([53]) في تفسيره هذه الآية: «قل لهؤلاء المنكرين نبوّتك، لست أقول لكم إنّي الربّ الذي له خزائن السموات والأرض، فأعلم غيب الأشياء الخفيّة، التي لا يعلمها إلاّ الربّ الذي لا يخفى عليه شيء فتكذبوني فيما أقول من ذلك، لأنّه لا ينبغي أن يكون ربًّا إلا من له ملك كلّ شيء، وبيده كلّ شيء، ومن لا يخفى عليه خافية، وذلك هو الله الذي لا إله غيره»([54]).
وبما أنّ الإيمان بالأمور الغيبيّة هو من عند الله، فلا بدّ من الإيمان والتصديق أنّ كل ما يأتي من غير هذا المصدر هو طرق الدجّالين والمنجّمين والعرّافين والكهّان، حين يُحدّثون عن الأحداث المستقبليّة من عند أنفسهم. فما القواعد التي نتّبعها في مناط الحكم على الأدلّة النقليّة في إثبات الأمور الغيبيّة؟
أثبتنا أنّ أشراط الساعة وعلامات الساعة هي من مسائل التوحيد وهي صلب الدين الإسلامي وأصله الأصيل وبها يميّز المؤمن من الكافر، ويميّز أصحاب الجنّة من أصحاب الجحيم، وممّا ابتلي به الإنسان في هذه الدنيا هو معرفة الشبهات، وتشكيك النّاس بما أخبر به رسول الله ﷺ، فهذا الابتلاء ليميّز الخبيث من الطيّب، والمصدّق من الكاذب، والمخطئ من المصيب.
ـ {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ}، فما القاعدة الأصيلة التي سار عليها هؤلاء المؤمنون ليصدّقوا بأمور غيبيّة ذكرها رسول الله ﷺ؟
قبل البدء بمعرفة هذه القواعد، أوّد توضيح أمر مهمّ، وهو: كيف يدرك الإنسان ما حوله؟ ومِمَّا يتكون هذا الإنسان؟ وما المقوّمات التي مُنِحت له لمعرفة ما سخرّه الله له؟
«كان الله ولم يكن شيء معه»([55])، خلق الله الكون لحكمة عظيمة، لتظهر آثار أسمائه وآثار رحمته، وآثار قدرته، وآثار حكمته، وآثار جبروته، فلم يشهد أي مخلوق، ولا أي أحد كيف خُلِقَ هذا الكون.
لم يشهد أحد خلق السموات والأرض، ولا يستطيع أحد في هذا الكون أن يدّعي أنّه شهد خلق السموات والأرض أو ما بينهما. قال تعالى: {مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}([56]). وذلك لكي لا يكون هناك حجّة لمن يتّخذ نفسه إلهًا فيعبده الناس، فالله سبحانه هو الخالق وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن… الأول ليس له بداية والآخر ليس له نهاية وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو ندّا أو مثيلا أو شبيها([57]).
روى البخاري([58]) في حديث عن عمران بن حصين: قال: قال أهل اليمن لرسول الله ﷺ: جئناك لنتفقّه في الدين ولنسألك عن أوّل هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء([59]) وكتب في الذكر كلّ شيء وخلق السموات والأرض.
قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ}([60]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل([61]).
وخلق الله عز وجل كل هذه الأصناف تهيئة وتجهيزًا للحياة على وجه الأرض([62]). خلق الله عز وجل جميع المخلوقات، وهيّأ الأرض لاستقبال الخليفة، فجميع الخلائق تعبد الله عز وجل، خلق الملائكة وفطرهم على طاعته، وجميع المخلوقات تصلّي وتسجد، وتسبّح الله عز وجل، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَآفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}([63]). وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}([64]).
وبعدما كتب القلم وجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة كما أمره الله. ومن علم الله أنّه سيخلق آدم عليه السلام وأنّ ما يميّز هذا المخلوق عن باقي المخلوقات أنّه أعطاه بعض الصفات التي يستطيع بها أن يعمر الأرض ويكون فيها خليفة يحفظ النعم ويعترف بفضل الله، ومن هذه الصفات العلم والقدرة والإرادة كما ميّزه عن غيره بالحريّة والمسؤوليّة وجعل له الحساب والتكليف في دار الابتلاء([65]).
ذلك أن الله عز وجل قد خلق آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض على وجه الابتلاء، فيحيا مستخلفًا فيها: يتقلّب بين قدرة الله وحكمته، وفضله ورحمته، وعدله وقوّته، فالغاية من خلق الإنسان تتمثّل في عبادته لله من خلال أفعاله في الأرض والتزامه بمراد الله الشرعي، أي فيما استأمنه الله فيه واسترعاه وخوّله وابتلاه([66]).

فما المقومات التي منحها الله عز وجل لآدم عليه السلام ولذريّته من بعده؟
- أوّلاً: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام في أحسن تقويم.
- ثانياً: علّم آدم عليه السلام الأسماء كلّها.
- ثالثاً: سلّحه بالفطرة هو وذريّته من بعده حين أخذ الميثاق على ذريّته وهم في عالم الذرّ.
قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}([67]). هذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان. فالفطرة التي فطر الله الخلائق عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوّة عليا عند ضعفها، وتطلب غنيًّا أعلى عند فقرها، وتوّابًا رحيمًا عند ذنبها، وسميعًا قريبًا بصيرًا عند سؤالها. وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد والإسلام، والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام .
قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *}([68]).
ثم عرض الله عز وجل الأمانة لحملها، وتحمّل المسؤوليّة عنها، على السموات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن يحملنها وأشفقن من حملها ومن تحمّل المسؤولية عنها ثم عرضها على آدم عليه السلام، فحملها واستعدّ أن يتحمّل المسؤولية عنها. وهذا يدلّ على أنّ معرفة حقّ الأمانة والإقرار بهذا الحقّ، والاستعداد للوفاء به، أمر مغروز في عمق فطرة الإنسان كما جاء في الحديث الذي ورد عن رسول الله ﷺ: «إنّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال… »([69]). لكن الإنسان كان عند تنفيذ رحلة الامتحان في الحياة الدنيا، ظلومًا جهولًا، فلم يؤد من الأمانة التي حملها، واستعدّ أن يؤدّي حقوقها ما يجب عليه فيها([70]).
لذا نتساءل ممّا يتكوّن الإنسان؟ هذا الإنسان الظلوم الجهول؟ وبعد التأمل في الدراسات المتعلقة بمكونات الإنسان لاحظت أنه مركب من الأجزاء الآتية([71]):
1 ـ الجسد: هو ما خلقه الله عز وجل من تراب، فكان طينًا، وبعدها صار طينًا لازبًا، ثم تُرك ليجفّ في الهواء فكان صلصالًا من فخّار. {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ}.
2 ـ الرُّوح: وبها تكون حياة الإنسان وبخروجها يكون الموت. قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}([72]).
3 ـ الحواس: وَهي منافذ المعرفة للإنسان يتعرّف بواسطتها إلى ما يحيط به من حاجات وأشياء ومخلوقات.
4 ـ العقل: وَهو ذاك الفكر والإحساس الذي يجعل الإنسان العاقل يحبس نفسه ويردّها عن هواها. والتعقّل ضدّ الحماقة وسمّي العقل عقلًا، لأنه يعقل (يحجز ويمنع) صاحبه. والعقل في اللغة: هو الحِجر والنهي، وهو ضدّ الحمق والجهل([73]).
أمّا العقل في القرآن: فقد قال تعالى فيه: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}([74]). وضع الله عز وجل العقل في قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيّته، ولكنّ نتعرّف على وجوده من قول اللسان وأفعال الإنسان([75]).
5 ـ القلب: من الجانب المحسوس فهو الآلة الخارقة التي لا تعرف التعب، فهو الذي تتحقّق فيه إحدى مقوّمات الاختيار في الإنسان. فقد قال الغزالي: «والقلب هو الجانب المدرك من الإنسان، وهو محلّ العلم، والتقوى والإخلاص والذكر والحبّ والبغض والخطرات، وهو موضع الإيمان والكفر، والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب»([76]).
وفي القلب مركز الخواطر وحديث النفس، حيث في القلب مصدر الخواطر والأفكار، ومحل الإلهام في الإنسان. وقد وصف الله عز وجل القلب بأنّه يمرض ويقسو بالنفاق، وأنّه يصحّ بالصدق والإخلاص والتوحيد، وقد يبدو القلب كالبيت المقفل، فهو لا ينفتح لواردات الخير والهداية، إلاّ بمفاتيح خاصّة، وقد يشتدّ الأمر حتى يختتم ويطبع عليها، وقد تعمي البصيرة عماءً تامًّا. قال تعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًْا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ}([77]).
6 ـ النفس: بمعنى الإنسان كلّه روحًا وجسدًا. قال تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ}([78]).
قوّة الإنسان الإدراكيّة: ـ النفس الإنسانية من حيث النوع واحدة، وإنّ ما يختلف فيه النّاس هو نفسيّاتهم المكتسبة. أي أنّ ما فطره الله تعالى في بني آدم واحد عند الخلق، وإن اختلفوا في الدرجة لا يختلفون في النوع، وأنّ هذا الاختلاف في الدرجة هو رحمة بالعباد لكي يستخدم بعضهم بعضًا سخريًّا، والذي بغيره لا تستقيم الحياة الإنسانية. ثم لا يختلف العلماء أنّ البدن هو وعاء هذه النفس. وهذا اتفاق في ترابيّة الجسد الإنسانيّ وفي نوع النفس البشريّة عند جميع النّاس -رجلًا كان أم امرأة-([79]).
أمَّا منافذ النفس([80]) فهي: في داخل الإنسان قوّة إدراكيّة كبيرة، ولكن مدركاتها لا تنبع من داخلها وإنّما تأتيها من العالم الخارج عنها. ولهذه القوّة الإدراكيّة في الإنسان منافذ تطلّ منها على العالم الخارجيّ (الحواس مثل: البصر والذوق واللمس، كما لها صلات أخرى تطلّ منها على عالم النفس وتتمثّل بحاسة الانفعالات كالرّضا والغضب، والحبّ والكراهية، وحاسة الألم، وحاسة التوازن، وحاسة الشهوات… إلخ.
فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوّة الإدراكية، تستطيع أن تتخيّل وتدرك وتركّب وتستنتج القواعد العامّة، وتقيس الأشباه والنظائر على بعضها البعض ولا تستطيع شيئًا غير ذلك.
ونستخلص من ذلك، أنّ النفس إنّما تدرك الأشياء المنتشرة في هذا الكون الكبير عن طريق منافذها التي منها تطلّ على العالم، ولولاها لما أدركت من الوجود الخارجي شيئًا ولبقيت في جهل كامل.
الخيال وحدوده

وجعل الله لدينا في مركب (موضع) قدرة الإدراك زاوية خاصّة قادرة على تخيّل أشياء غير موجودة أمامنا وفق هذا التركيب التخيّليّ. لكننا مهما حاولنا أن نتخيّل صورة ما من الصور الغريبة، أو الجديدة أو الإبداعية، ومهما سبحنا فيها من الأوهام الخرافيّة، فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئًا جديدًا أكثر من أن نضمّ أجزاءًا موجودة نعرفها، ونميّزها، ونراها فعلًا في الكون نضمّها بعضها إلى بعض، لنصنع منها شيئًا جديدًا ندّعي أنّه من ابتكارنا ومن صنعنا واختراعنا.
لكن في الواقع هذه الأجزاء قد أدركناها فعلًا عن طريق حواسّنا، وبواسطة هذا التخيّل الموجود في داخلنا ضممنا هذه الأجزاء الموجودة بشكل متباعد فتخيلناها على شكل وحدة متماسكة في صورة جديدة. لذا فإنّ خيالنا محصور حصرًا تامًّا فيما تدركه حواسنا، فنحن مهما أوتينا من قدرة خياليّة لا نستطيع أن نتخيّل حقيقة ما من الحقائق ما لم نلامس أو نر أو ندرك نموذجًا عنها بحواسنا، ومن ذلك يستحيل علينا تخيّل الأمور الغيبيّة مهما وصلت بنا القدرة على التخيّل. ومن أجل ذلك يصعب علينا بل يتعذّر أن نتخيّل حقيقة تكوين الملائكة والجنّ، وأمثال ذلك من مخلوقات بعيدة عن مجال حسّنا.
العقل وحدوده
العقل مقيّد بعالم الحسّ، ولا عمل له على عالم الغيب، ذلك لأنّ القوّة العاقلة فينا تجمع بين المصوّرة والذاكرة والمخيلة والذكاء([81])، و(العقل) مصدر لفعل (عَقلَ)، أي هو اسم لا وجود لذات له في الخارج، فالحدث هو الأمر الذي يقع به الفاعل. إذن لغة هو شيء اسمه (العقل)؛ لأنّه ليس له ذات يقع في دائرة الحواس الخمس، ولا كيان له يعرف به؛ إنما يظهر أثره من خلال العناصر المكوّنة لهذا الحدث. من هنا ندرك أنّه ليس للعقل كيان ذاتيّ يمكن أن تقع عليه حواسّنا، ولكي نرى أثره لا بدّ أن تتم عملية العقل (التفكير)، وبالتالي لا بد من توافر العناصر المكوّنه لهذه العملية. ألا وهي:
- أوّلًا: لا بدَّ من (واقع) يكون موضوعًا للتفكير.
- ثانيًا: لا بدَّ من انتقال هذا الواقع إلى الإنسان، وذلك عن طريق حاسّة أو أكثر من الحواس الخمس عبر قنوات الإحساس.
- ثالثًا: لا بدَّ من دماغ يستقبل الواقع المحسوس.
- رابعًا: لا بدَّ من معلومات سابقة مخزونة في الدماغ لتفسير هذا الواقع الجديد، لكي يتمكّن الإنسان من إصدار حكم ما حول هذا (الموضوع).
وما لم يتحقّق وجود هذه العناصر الأربعة فلن يتمكّن الإنسان من إتمام عمليّة التفكير التي بانتهائها يتمّ (العقل) الذي تميّز به الإنسان عن سائر العجماوات. ولا يستطيع المرء أن يفاضل بين هذه العناصر الأربعة. فالدماغ الذي يبدو -للوهلة الأولى- أنّه العنصر الأهم والأساس، يفقد قيمته ولا يتمكّن من القيام بدوره إن لم تزوّده الحواسّ بموضوعات العقل ووقائعه([82]).
الحواس وحدودها
حينما نتحدث عن الحواس الخمس كواحد من عناصر العقل فإنما نعني الحواس الخمس التي تشكّل نوافذ الاتصال بين الإنسان وبين محيطه الخارجيّ؛ إذ هي نوافذ المعرفة الإنسانيّة التي يشترك فيها النّاس كلّ النّاس -أسودهم وأبيضهم، أحمرهم وأصفرهم، المؤمن منهم والكافر- أمّا الإحساس الداخليّ المتمثّل بالشعور المتّصل بالحاجات العضويّة أو المشاعر الغريزيّة فلا دخل له في هذا الشأن، لا من قريب ولا من بعيد، لأنّها ليست عنصرًا من عناصر التفكير. ولا تعدو أن تكون شعورًا ومشاعر تطلب الإشباع ليس غير([83]). وأمّا حواسنا التي هي السبيل الوحيد لنتعرّف على الوجود من حولنا، فهي منافذ محدودة كمًّا وكيفًا([84]).
ومما سبق تتلخّص لدينا الحقائق التالية([85]):
- الحواسّ محدودة.
- قدرة التخيّل فينا محدودة.
- عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق.
وبما أنّ العالم من حولنا، مقسوم إلى عالم ماديّ مشهود ومحسوس، وعالم غيبيّ مجرّد لا يمكن أن تراه العيون -ومع ذلك لا يمكن أن ننكره لعدم رؤيتنا له ولا يمكن أن نتصورّه كما نريد ولا يمكن أن نتفكّر به من خلال الخيال أو العقل لأجل ذلك-؛ فإنّ الوحي هو الطريق الوحيد لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب، ومن أجل ذلك أرسل الله جلَّ وعلا الرسل، الذين اتصلوا بالوحي من عالم الغيب، فالوحي يُبلّغهم بعض الحقائق المغيّبة عنّا، وهم يبلّغوننا ما نقلوه عن الوحي بشكل يقينيّ واضح. وما علينا إلا أن نصدّقهم بما أخبروا به من عند الله تعالى.
لذا يجب أن نؤمن جازمين ومتيقّنين بما جاءنا عن الوحي الصادق، دون أن نزيد عليه شيئًا من التخيّلات أو التصوّرات، ودون أن نتلاعب فيه بتأويلات. وبهذا ندرك أنّه لا يمكننا معرفة الأمور الغيبيّة إلا عن طريق الخبر الصادق، المرسل من الله عن طريق الوحي والمثبّت في كتاب الله تعالى، والمؤيد والمؤكّد عن طريق سنّة رسول الله ﷺ.
المنهج في إثبات الأمور الغيبيّة

أمّا المنهج في إثبات الأمور الغيبيّة فهو المنهج القرآني والحديث النبويّ، وهو منهج جميع الرسل والأنبياء. وهو منهج الله تعالى في خلقه؛ لأنه أعلم بهم وبأحوالهم، وبحاجاتهم. هذا المنهج يقف العقل الإنسانيّ فيه عند حدّ التصديق بالله، ثمّ بعد ذلك يتلقّى هذا المنهج عن الله تعالى، والتوحيد ضرورة اليقين بالله الواحد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر.
والعقل الإنسانيّ هنا يتدبّر وحي الله ويفقهه، ولا يخوض في هذه القضايا بعيدًا عمَّا أوحى الله تعالى به إليه. وعلى المسلم في هذه الحال أن يتأكّد من صدق نسبة النصوص إلى رسول الله ﷺ، فإن كانت صادقة، فعليه أن يترك رأيه وهواه، ويحكم يقينًا بما أوحى الله تعالى.
ومن ذلك أشراط الساعة لأنَّ فيها حثَّ النفس على طاعة الله، والاستعداد ليوم القيامة، ففيه إيقاظ للغافلين، وحثّهم على التوبة، وعدم الركون إلى الدنيا، وهذا ما فعله المصطفى ﷺ. عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبيّ ﷺ من النوم محمرًّا وجهه يقول: «لا إله إلا الله»، ويل للعرب من شرّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه». قيل: «أَنَهلك وفينا الصالحون؟» قال: نعم، إذا كثر الخبث»([86]). وفيه أيضًا عن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ قالت: استيقظ رسول الله ﷺ ليلة فزعًا، يقول: «سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات ـ يريد أزواجه لكي يصلين-، ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»([87]).
والأهمّ من ذلك أن من أشراط الساعة الحديث عن الفتن وما يحدث في آخر الزمان، مما يدفع الإنسان ليتّقي هذه الفتن([88]).
ما القواعد التي اتبعها السلف الصالح في معرفة الأمور الغيبيّة، ومتى بدأ السلف الصالح يقعد لهذا العلم؟
لقد ثبت لديّ بعد التدقيق في مراجعة بعض كتب أصول الفقه ومناهج التشريع الإسلامي([89]) -والبعض من كتب العقيدة- ما يحيّر الحليم من كيفية اتخاذ هذا المنهج الذي يسير عليه أكثر المسلمين اليوم في أصول الفقه الإسلامي ومناهج التشريع الإسلامي، من «قطعيّ الدلالة» و«ظنيّ الدلالة» ما لم أجد له أثرًا فيما علَّمنا إياه رسول الله ﷺ، ولست بصدد الشروع في كتابة هذا العلم في بحثي، سوى ما سأتطرق إليه من الأخذ بأحاديث الآحاد في الأمور الغيبيّة التي غابت عنَّا وأخبرنا عنها رسول الله ﷺ. ولن أدخل في قول السلف الصالح، ومن هم السلف الصالح، أو لماذا اتخذ هذا العلم، الذي سأتحدث عنه حين الحديث عن الفرق، التي خرجت بعد وفاة رسول الله ﷺ.
لذا، إن تتبّعنا التاريخ لمعرفة أول من سنّ هذا العلم نجد أنّ، في تاريخ التشريع الإسلامي ، الشافعي هو أول من سجّل في وضوح، وتفصيل خطّته التشريعيّة في استنباط الأحكام. ولكن للملاحظة فقط، أنّه يرجع السبب في أنّ الشافعي أوّل من وضع هذا التشريع، لأنّه لم يكن قد ابتدأ بعد عصر تقعيد قواعد للعلوم الشرعيّة، وتأصيل أصول منهجيّة لها، وتدوينها بطرق علميّة منظّمة. بل إن مجرّد تدوين العلوم العربية كلّها قد نشأ في القرن الثاني، ولم يزدهر ويأخذ صورة جماعيّة إلا في النصف الثاني منه. وقد أشار إلى ذلك أيضًا أستاذنا محمد أبو زهرة حيث ذكر أن زيد بن عليّ لم يدوّن منهجه في الاجتهاد، ولم يفعل ذلك أيضًا أبو حنيفة، ولا الأوزاعي، ولا مالك، وبذلك يكون الشافعي» هو أوّل إمام بيّن منهجه، لأنّ التدوين وتأصيل العلوم كلّها قد ظهرت على عهده؛ وما يهمّنا هو المنهج الذي اتبعه الصحابة، رضوان الله عليهم، في التصديق بالأمور الغيبيّة. بالعودة إلى الفترة الزمنية الواقعة في القرن الأول والثاني الهجري، نرى أن من الائمة الذين عاصروا هذه الفترة وفق ميلادهم:
- الإمام أبو حنيفة النعمان (80 ـ 150هـ).
- الإمام مالك (93 ـ 179هـ).
- الإمام سفيان الثوري (97 ـ 161هـ).
- الإمام سفيان بن عيينة (107 ـ 198هـ).
- الإمام عبدالله بن مبارك (118 ـ 181هـ).
- الإمام الشافعي (150 ـ 204هـ).
- الإمام أبو القاسم بن سلَّام (150 ـ 224هـ).
- الإمام أحمد بن حنبل (164 ـ 241هـ).
- الإمام البخاري (194 ـ 256هـ).
- الإمام الدرامي (200 ـ 280هـ).
- الإمام أبو داود (204 ـ 261هـ).
- الإمام مسلم (204 ـ 261هـ).
- الإمام الترمذي (209 ـ 279هـ).
- الإمام ابن ماجه (209 ـ 273هـ).
- الإمام النسائي (215 ـ 303هـ).
أمّا القرن الثاني والثالث فقد جاء:
- أبو بكر بن خزيمة (223 ـ 311هـ).
- أبو جعفر الطحاوي (238 ـ 321هـ).
- أبو الحسن الأشعري (260 ـ 324هـ).
- أبو عبدالله بن منده (310 ـ 395هـ).
هؤلاء تابعو التابعين ساروا على درب الصحابة الكرام في فهمهم للتوحيد والعقيدة الإسلامية بفطرتهم النقيّة، وحازوا على مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين، بتصديق خبر رسول الله ﷺ، لأن علم اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله.
ترى هل فرَّق الصحابة بين أحاديث رسول الله ﷺ؟ فالمعروف أنّ الصحابة والتابعين كانوا يتلقّون نصوص القرآن الكريم وما ثبت في السنة بالتصديق والتسليم ويقابلونها بالخضوع والحب والتعظيم، فلا يفرّقون فيها بين المتواتر والآحاد، بل أيقنوا بفطرتهم السليمة أن جميع ما صحّ وما ثبت عن رسول الله ﷺ هو وحي من الله عز وجل إلى سائر العباد، ولا بدّ لهم أن يصدّقوا خبره بشرط اليقين، ولا بدّ من تنفيذ أمره بكمال الانقياد([90]).
وقد أفرد البخاري في صحيحه كتابين يدلَّان على صدق هذا الكلام: كتاب أخبار الآحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فجاء في الباب الأول: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، أما كتاب الاعتصام والسنة فوضَّح اهتمامه في الأبواب إلى الأخذ بأحاديث رسول الله ﷺ من غير كثرة السؤال والغلوّ في الدين والبدع، وذمّ الرأي وتكلّف القياس([91]).
واتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد، وهو كما عرفنا: ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة، وعمل الصحابة به في وقائع لا تُعدّ ولا تحصى. ويقول ابن أبي العزّ الحنفي: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول عملًا به وتصديقًا له يفيد العلم اليقينيّ عند جماهير الأمّة، وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمّة في ذلك نزاع»([92]).
وفي رواية مسلم: كل ما ثبت عن النبيّ ﷺ أنّه أخبر بوقوعه فالإيمان به واجب، وذلك من تحقيق الشهادة بأنّ محمدا رسول الله ﷺ، تحقيقها من أصول الإيمان، ولا يكون المرء مؤمنًا معصوم الدم والمال حتى يحقّق الشهادة بالرسالة، لقول النبي ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على الله»([93]).
لذا كل ما أخبر به رسول الله ﷺ، الإيمان به متعلّق بالعقيدة، لأنّه لا يتمّ الإيمان بالرسول ﷺ إلاّ بالإيمان بأخباره .
أمَّا ابن حزم المتوفى 456هـ فقد ذكر في كتابه الإحكام في أصول الأحكام قال: قال أبو سليمان والحسين عن أبي علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم، إنّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ﷺ يوجب العلم والعمل معًا. وبهذا نقول: ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله ﷺ وجب العمل به، ووجب العلم بصحّته أيضًا([94]). والبرهان على صحّة وجوب قبوله قول الله عز وجل: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}([95]) وقال أيضًا: فصحّ أنّ كلام رسول الله ﷺ كلّه في الدين ووحي من عند الله عز وجل، لا شكّ في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أنّ كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزّل، فالوحي كلّه محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفّل الله بحفظه فمضمون ألَّا يضيع منه وألَّا يحرّف منه شيء أبدًا تحريفًا لا يأتي البيان ببطلانه([96]).
أمّا ما أثبته ابن قيم الجوزية في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة قال عن خبر الواحد: إذا صحّ الخبر عن رسول الله ﷺ، ورواه الثقات والأئمّة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي ﷺ، وتلقته الأمّة بالقبول، فإنّه يوجب العلم فيما سبيله العمل. هذا قول عامّة أهل الحديث والمثقفين من القائمين على السنة[97].
وقد نقل السفاريني في كتابه لوامع الأنوار([98]): عن الإمام إسحاق بن راهويه. قال في المسوّدة إنّ جحد أحد أخبار الآحاد كفر، فالآحاد كالمتواتر عندنا فإنّه يوجب العلم والعمل به. أمّا الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله([99]) قال: وإننا إن لم نقل بكفره، نقول: لقد سلك هذا الذي ردّ أحاديث الرسول ﷺ الصحاح في الاحتجاج بها في العقائد مسلكًا بيّن الخطأ، ويخشى عليه أن يزيغ بسبب ردّه لهذه الأحاديث وأن يبتليه الله بالمضلات {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}([100]).
وذكر ابن الصلاح في مقدمته : «أنّ ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث مقطوع بصحّته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافًا لقول من نفى ذلك محتجًّا أنّه لا يفيد في أصله إلاّ الظن، وإنّما تلقّته الأمّة بالقبول، لأنّه يجب عليهم العمل بالظنّ، والظنّ قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًّا، ثم بان لي أنّ المذهب الذي اخترناه أوّلًا هو الصحيح لأنّه ظن من هو معصوم من الخطأ». وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم، مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمّة كل واحد من كتابيهما بالقبول»([101]).
ويقول الشوكاني : «ولا نزاع في أنّ خبر الواحد، إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنّه يفيد العلم، لأنّ الإجماع عليه صيّره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول»([102]).
وبذلك نرى أنّ أئمة السلف وتابعيهم يحتجّون بالأخبار الصحيحة دون النظر إلى قضية القطع والظنّ، ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين ما تعمّ به البلوى وما لا تعمّ به البلوى، وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، وبين ما زاد على القرآن وما كان مبينًا له أو موافقًا له، وبين ما يقال إنّه مخالف للقياس أو موافق له، بل كانوا يأخذون بالحديث متى صحّ ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له([103]).
أمّا السبب في عدم الأخذ بأخبار الآحاد فهو كالتالي:
يقسم العلماء العلم الذي جاء به رسول الله ﷺ من ربّه إلى ثلاثة أقسام:
- قسم إخباري وهو يتعلّق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله سبحانه وتعالى وأعماله والرسالات والملائكة والجنّة والنار والحساب، وغير ذلك مما يدخل في مسائل الغيب.
- وقسم يتعلّق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التي كلفنا بها فمنها ما يتعلّق بالصلة بين العبد وربّه فتسمّى العبادات وأعظمها الصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنها ما يتعلّق بين الناس بعضهم مع بعض كالزواج والطلاق والبيع، والهبة والميراث وهكذا كافة الشؤون المالية والسياسية.
- وقسم ثالث يتعلّق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكية، وهذا القسم يتعلّق بكلا القسمين الآنفين. فهو من ناحية عمل قلبي، كسلامة الصدر من الغلّ والحسد، وهو من ناحية ثانية عمل ظاهريّ تشريعيّ، كالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك من أعمال ظاهرية.
والقسم الأوّل: العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل، ولا زيادة أو نقص؛ فهو ثابت في الرسالات جميعها وعلى لسان الأنبياء جميعًا.
وأمّا القسم الثاني: فهو خاضع للظروف والملابسات والزمان والمكان بل هو في حركة دائمة كما قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}([104]). ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض، ولا يعني هذا الاختلاف من جميع الوجوه، بل أصول الشرائع أيضًا متّفقة.
وبالرغم من أنّ شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبي ﷺ فإنّ المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه الشريعة أحكامًا لقضاياهم ومشكلاتهم المتجدّدة بتجدّد الزمان والمكان والحوادث. ولذلك كان تشريع حياة متحرّكة متجدّدة بتجدّد الحياة. وهذا يعني أيضًا وقف التشريع للوقائع المتغيّرة، هو عزل الشريعة عن حياة الناس لأنّ الحياة مستمرّة، وللتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة مستمرّة. وإذا تخلّفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة، وهذا ما حدث تمامًا بالنسبة للشريعة الإسلاميّة حيث عزلت عن حياة الناس، وعن التقنين لهم بجمود الحركة الفقهيّة التشريعيّة أوّلًا، ثم بالعزل السياسي والاجتماعي للتشريع الإسلامي.
القسم الثالث: وأمّا الأخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادئ والأصول، فالجانب العملي فيها يتغيّر تبعًا للظروف والملابسات، فالصبر والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلي فيها ثابتًا باقيًا، إلاّ أنّ المواقف التي تقتضي ذلك متغيّرة أيضًا.
لذا الأخذ بحديث الآحاد هو من الأحاديث التي تستلزم الأخذ بها وإلا ردّت مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ ﷺ لمجرّد كونها في العقيدة([105])، ولقد ذكر د. عمر الأشقر في كتابه العقيدة؛ العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد الصحيحة منها:
- أفضلية نبينا ﷺ على جميع الأنبياء والمرسلين.
- شفاعته العظمى في المحشر.
- شفاعته ﷺ لأهل الكبائر من أمّته.
- معجزاته كلّها ما عدا القرآن.
- كيفيّة بدء الخلق، ووصفه الملائكة والجن، ووصفه الجنّة والنار، ممّا لم يذكر في القرآن الكريم.
- سؤال منكر ونكير في القبر.
- ضغطة القبر للميت.
- الصراط، والحوض، والميزان ذو الكفّتين.
- الإيمان أنّ الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته، ورزقه وأجله وهو في بطن أمّه.
- خصوصيّاته ﷺ، التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص الكبرى» وإسلام قرينه من الجن.
- القطع بأنّ العشرة المبشرين بالجنّة من أهل الجنّة.
- عدم خلود أهل الكبائر في النار.
- الإيمان بكلّ ما صحّ في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر ممّا لم يرد في القرآن الكريم.
- الإيمان بأشراط الساعة، كخروج المهدي، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدجّال، وخروج النّار، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وغير ذلك.
والصواب من القول أنّ أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا احتفت بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم. فالأحاديث التي وردت في كتب السنة، وصححها أهل العلم، ولم يطعن في صحّتها واحد منهم تفيد اليقين لإجماع الأمّة على صحّتها. ومن ذلك ما اتفق عليه صاحبا الصحيح أو ورد في واحد من الصحيحين، ولم يطعن في صحّته واحد من أهل العلم. ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورًا أو مستفيضًا أو رواه الأئمّة الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر.
خلاصة القول في المسألة: إنّ علماء أهل السنّة يقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك، يدلّك على هذا تخريج أئمّة أهل السنّة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم، الأحاديث المثبتة للعقائد في مدوّناتهم، والمتواتر منها قليل، ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا أنفسهم في روايتها وضبطها وتدوينها. ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنّه قد افترى عليهم، ولا دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظنّ الراجح أو اليقين في المسألة([106]).
المصادر
- ابن منظور، لسان العرب، 3/301 – 303.
- النساء: 33.
- النحل: 91.
- المائدة: 1.
- محمود سالم عبيدات، العقيدة الإسلامية، عمان، الأردن، دار الفرقان، د.ط، 1998، 12 – 13.
- صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، حديث رقم 71 وتتمة الحديث: “وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله”.
- فرقة المعتزلة: المعتزلة اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء (البصري الغزّال المتكلم، كان من أجلّاء المعتزلة، سمع الحسن البصري)، وسلك منهجًا عقليًا صرفًا في بحث العقائد، وقرر أنّ المعارف كلها عقلية حصولًا ووجوبًا قبل الشرع وبعده. وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل، والتمييز، والاستنباط على من خالفهم. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي، الجزء الرابع، 329، الذهبي، الإمام الحافظ شمس الدين، المتوفّى سنة 806هـ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: عبد الفتّاح أبو سنة وعلي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1429هـ/2008م.
- السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: محمد السّود، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالث، 2009م، 32، هذا المصطلح قد اشتهر بين السلف مرتبطًا بالفقه، إلّا أن اقترانه بالدين كان جهمي المنشأ والتكوين، فالمعتزلة أطلقوه على أصولهم الخمسة، وجعلوا تلك الأصول أساسًا للدين، أمّا أغلب الذين استعملوه من متكلمي الأشعرية فكانوا يرغبون أن تكون لهم أصولهم العقلية متميزة عن الأصول الخمسة عند المعتزلة، حيث اعتبروا أنفسهم أهل السنة والجماعة، انظر: كتاب الأصول العقيدة، د.محمود عبدالرزاق الرضواني، القاهرة، مكتبة سلسبيل، الطبعة الأولى، 1430هـ/2009م، 1/242 – 243.
- البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم فخر الإسلام البزدوي فقيه أصول من أكابر الحنفية ومن سكان سمرقند نسبته إلى بزده قلعة بقرب نسف. له تصانيف منها: كنز الوصول في أصول الفقه ويعرف بأصول البزدوي توفي سنة 482هـ. انظر: أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، للكاتب علي بن محمد البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد برس، كراتشي. وانظر: سير أعلام النبلاء (18/602 – 603).
- البغدادي: أبو منصور المتوفّى سنة 429هـ، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، د.ط، 1413هـ/1993م. عالم رياضيات عربي عاش بين 980م وعام 1037م.
- ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الخضر بن تيمية النمري الحرّاني، جمع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها، ومذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق. ولد عام 671هـ وتوفي عام 728هـ بعد مرض نزل به في السجن في دمشق. الإمام محمد، أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية، لندن قبرص، دار الحديث 1987م، 627.
- محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد ابن راشد، الذي يعود نسبه إلى آل مشرف من قبيلة تميم عريقة النسب والشرف، حيث ينحدرون من مصر فمن نزار فمن عدنان [محمد أحمد درنيقه: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رائد الدعوة السلفية في العصر الحديث ص27]، كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كعائلته متتبعًا منهج السلف الصالح.
- النسفي: ميمون بن محمد النسفي الشهير بأبي المعين النسفي المتوفى سنة 508هـ، له كتاب بحر الكلام يتحدث عن تاريخ علم الكلام، وهو من علماء القرن الخامس الهجري وأوائل السادس. سكن بخارى وهو حنفي المذهب، روى عنه شيخ الإسلام محمود بن أحمد الساغرجي، وعبد الرشيد الولوالجي، وكان من العلماء الأعلام المشهود لهم بغزارة العلم، وكان أصوليًا فقيهًا متبحرًا في العلوم والمعارف، ويعد من علماء الكلام. انظر: بحر الكلام، ميمون بن محمد النسفي، دمشق، دار الفرفور، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1997م، 34.
- الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفّى سنة 458هـ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، حققه أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.
- البخاري، في كتاب التوحيد، باب دعاء النبي ﷺ إلى توحيد الله، حديث رقم 7372. وزاد في رواية: “واتق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب”، أخرجه البخاري في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي الزكاة: باب وجوب الزكاة، وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. وفي المظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. وفي التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأخرجه مسلم في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
- البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث رقم 1395.
- هو محمد بن إسحاق السلمي، أبو بكر إمام نيسابور في عصره، كان فقيهًا مجتهدًا عالمًا بالحديث، إمام الأئمة وصاحب التصانيف. ولد سنة 223هـ بنيسابور ونشأ بها، فسمع من محدث وعالم خراسان الإمام إسحاق بن راهويه، كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم، له كثير من المصنفات من ضمنه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزَّ وجلَّ، توفي رحمه الله سنة 311هـ وعمره يناهز 89 سنة. من ترجمة المؤلف في كتاب التوحيد، 5.
- وهو كتاب أثبت فيها ابن خزيمة صفات الرب عزَّ وجلَّ التي وصف بها نفسه في تنزيله على نبيه المصطفى ﷺ وعلى لسان نبيه، نقل الأخبار الثابتة الصحيحة، نقل العدول عن عدول، من غير انقطاع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1425هـ/2004م.
- الجوزية، ابن قيم، مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، حققه وضبط نصه أحمد فخري الرفاعي وعصام فارس الحرستاني، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1991م، الأوّل، 454، والجزء الثاني 365.
- الجزائري، أبو بكر، عقيدة المؤمن، مصر، القاهرة، دار السلام، د.ط، لا.ت، 15.
- الأشقر، عمر سليمان، العقيدة في الله، الأردن، عمّان، دار النفائس، الطبعة العاشرة، 1415هـ/1995م، 12.
- عبد الحميد السائح، عقيدة المسلم وما يتصل بها، وزارة الأوقاف الأردنية، عمان 1979م، 27.
- ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، حققه أبو عبد الله زهوي، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، د.ط، 1424هـ/2004م، 1/55.
- الشورى: 13.
- عدنان علي رضا النحوي، التوحيد وواقعنا المعاصر، الرياض، دار النحوي للنشر والتوزيع، ط2، 1413هـ/1993م، 18 – 19.
- البقرة: 177.
- المؤمنون: 1.
- صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث 8.
- البقرة: 3 و4.
- البقرة: 285.
- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/43 – 44.
- التوبة: 61.
- يوسف: 17.
- الشعراء: 227.
- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/43.
- الحشر: 22.
- الرعد: 9.
- صحيح البخاري، كتاب القدر، باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38] رقم الحديث (6604).
- آل عمران: 44.
- يوسف: 102.
- الزمر: 71.
- الأعلى: 18 و19.
- البقرة: 177.
- البقرة: 1 – 5.
- عبد الله بن سليمان الغفيلي، أشراط الساعة، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1422هـ، 7. ومحمد بن عبد الرحمن العريفي، نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى، الرياض، دار التدمرية، الطبعة السابعة، 1431هـ/2010م، 19 – 20. محمد بن إسماعيل المقدم، فقه أشراط الساعة، الإسكندرية، مصر، دار الخلفاء الراشدين، الطبعة الأولى، 1430هـ/2009م، 17 – 21. وأحمد مصطفى متولي، صحيح الدار الآخرة، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 426هـ/2005م، 88.
- القرطبي، شمس الدين عبد الله، المتوفى 671هـ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، بيروت، دار الكتب العلمية 1987، الطبعة الثانية، ص709. هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، أبو عبد الله القرطبي، الإمام المفسر، كان زاهدًا عابدًا حسن التصنيف، رحل إلى مصر واستقر فيها، من كتبه الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي سنة 671هـ.
- محمد: 18.
- محمد السفاريني (188هـ)، لوامع الأنوار وسواطع الأسرار، بيروت، المكتب الإسلامي، 1991، الطبعة الثالثة، 2/65 – 66.
- الجنّ: 26 – 27.
- هود: 123.
- يونس: 20.
- الأنعام: 50.
- هو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام البارع المفسر، قال الذهبي عنه: أكثر من الترحال ولقي كثيرًا من الرجال، وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاءً وكثرة تصانيف. من مصنفاته: جامع البيان في تفسير القرآن، توفي ببغداد سنة 310هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 14/267 – 282.
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 310هـ)، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: صلاح عبدالفتاح الخالدي، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م، المجلد الثالث، 417.
- رواه البخاري عن عمران بن حصين، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} حديث رقم: 3190.
- الكهف: 51.
- صلاح عبد الفتّاح الخالدي، سيرة آدم عليه السلام، الأردن، مؤسسة الورّاق، د.ط، 2003م، 9.
- رواه البخاري، عن عمران بن حصين، حديث رقم 7418، كتاب التوحيد، باب: (وكان عرشه على الماء).
- لا نسأل عن كيفيّة ذلك ولا مكان الماء، ولا أين خلقه، فكل ما نعرفه أنّ الماء مخلوق وأنّ عرشه على الماء، وأنّ هذا كان قبل الإنسان وخلق السماوات والأرض.
- يونس: 3.
- أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، حديث رقم: 2789.
- صلاح الخالدي، سيرة آدم عليه السلام، 14.
- النور: 41.
- الحج: 18.
- صلاح عبد الفتاح الخالدي، القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاوية، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م، 13.
- محمود عبد الرزاق الرضواني، منّة القدير، القاهرة، مكتبة سلسبيل، الطبعة الأولى، 1430هـ/2009م، الثاني، 490/493.
- الأعراف: 172.
- الروم: 30.
- رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، حديث رقم 6497.
- حسن حبنّكة الميداني، روائع من أقوال الرسول، دمشق، دار القلم، الطبعة الخامسة، 1412هـ/1991م، 335.
- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1413هـ/1992م، المجلد الأول، 229 – 265 – 327.
- الإسراء: 85.
- ابن منظور، لسان العرب، 11/458.
- الحج: 46.
- محمود عبد الرزاق الرضواني، منة القدير، 2/250.
- أبي حامد محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، تحقيق: عبد الله الخالدي، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م، 3، 3.
- التوبة: 124 – 125.
- الذاريات: 21.
- نايف معروف، الإنسان والعقل، بيروت، دار سبيل الرشاد، ط1، 1995، 153.
- عبد الرحمن الميداني، العقيدة الإسلامية، 15 – 22.
- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية، 19.
- نايف معروف، الإنسان والعقل، 178.
- المصدر نفسه، 182 – 183.
- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية، 19.
- المصدر نفسه، 21 – 22.
- صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ويل للعرب من شر قد اقترب، حديث رقم: 7059، ورواه مسلم بحديث رقم: 2880.
- صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشرّ منه، حديث رقم: 7069.
- محمد بن عبد الرحمن العريفي، نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى، السعودية، طبعة أولى، دار التدمرية، 1431هـ/2010م، 4 – 5 بتصرف.
- الشافعي (204هـ)، الأم، بيروت دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1426هـ/2005م – الشافعي (204هـ)، الرسالة، بيروت دار الكتاب العربي، د.ط، 1426هـ/2006م – ابن حزم الظاهري (456هـ) الإحكام في أصول الأحكام، بيروت، دار الفكر، د.ط، 1427هـ – 1428هـ – 2007م – أبي حامد الغزالي (505هـ) المستصفى في علم الأصول، بيروت، المكتبة العصرية، د.ط، 1430هـ – 2009م – ابن قيم الجوزية (751)، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، بيروت، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 1424هـ – 2003م – أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي (790هـ)، الاعتصام، القاهرة، دار الحديث، وله أيضًا الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، الطبعة السادسة، 1425هـ/2004م – محمد بلتاجي، مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري، دراسة أصولية مقارنة لمصادر الأحكام عند الأئمة، القاهرة، دار السلام، الطبعة الأولى، 1425هـ/2004م.
- صلاح عبد الفتاح الخالدي، القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاوية، 131. ومحمود عبد الرزاق الرضواني، أصول العقيدة، 2/923. ويوسف عبد الله الوابل، أشراط الساعة، الرياض المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، الطبعة التاسعة، 1418هـ/1997م، 41.
- صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 1387.
- علي بن علي ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، حققه بشير محمد عيون، دمشق وبيروت، مكتبة المؤيد ومكتبة البيان، ط3، 1413هـ/1992م، الثاني، 394.
- رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث رقم 34.
- الخبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ﷺ في أحكام التشريع يوجب العلم، ولا يجوز فيه البتّه الكذب ولا الوهم.
- التوبة: 122.
- ابن حزم الظاهري، المتوفى 456، الأحكام في أصول الأحكام، بيروت، دار الفكر، نسخة منقّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، د.ط، 1427هـ/2007م، الأول، ص80.
- ابن قيّم الجوزية، المتوفى سنة 728هـ، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق سيد إبراهيم، القاهرة، دار الحديث، لا.ط، 1425هـ/2004م، 551.
- محمد السفاريني، لوامع الأنوار، 1/19.
- عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، عمّان – الأردن، دار النفائس، ط10، 1415هـ/1995م، 63.
- النور: 63.
- الحافظ زين الدين العراقي (806هـ)، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، بيروت، دار الحديث، ط2، 1405هـ/1984م، 28.
- الحافظ محمد بن علي الشوكاني، المتوفى 1250هـ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، تحقيق أد. شعبان محمد إسماعيل، القاهرة، دار السلام، ط3، 1430هـ/2009م، 1/176.
- أبي عبد الله محمد الشافعي (204هـ)، الرسالة، تحقيق خالد السبع العلمي، زهير شفيق الكبي، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ط، 1426هـ/2006م، 296 – 297.
- المائدة: 48.
- محمد ناصر الدين الألباني، وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، دمشق، مكتبة دار ابن عبدالرحمن بن علي الجريسي، د.ط، 1974م، 19 – 20 بتصرّف. وله أيضًا: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1425هـ/2005م، 49 – 50.
- عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، 56 – 57 – 58.