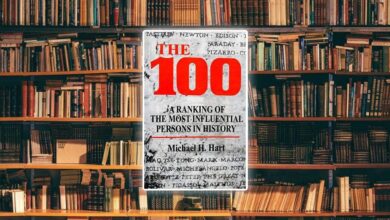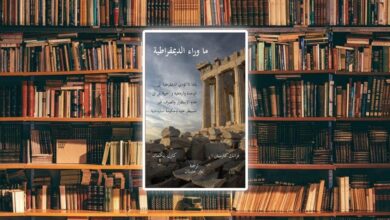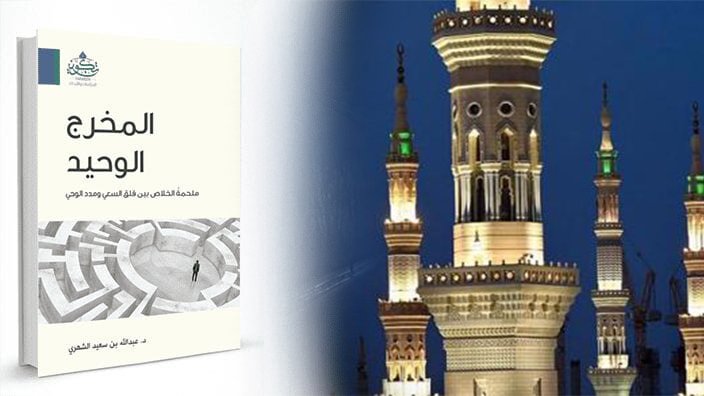
كتاب المَخرج الوحيد.. لماذا الإسلام هو المَخرج الوحيد؟
يقول “د/ عبد الله الشهري” مُؤلِّفُ كتاب “المَخرَج الوحيد” عن رؤية الحقيقة وكيفيَّتها: “تتطلَّب رحلتُنا صوب الحقيقة التخفُّفَ لأقصى حدٍّ من ذاتيَّتنا الضئيلة والانتباهَ إلى المَشهَد الأعظم للوجود. لِتُشاهِدَ الغابةَ؛ أوَّلاً توقَّفْ بعيدًا عن آحاد الأشجار، ثُمَّ اقصدْها بعد ذلك وقُمْ بالاستكشاف”. فهو مع كثيرين يرون أنَّ الإنسان تمنعه عن رؤية الحقيقة العُظمى تفاهاتُ الحياة والأمور اليوميَّة التي تشغله عن حاجته الحقيقيَّة إلى الهداية. الحاجة إلى الاهتداء إلى مرفأ سلام داخليّ نفسيّ يُبدِّد عنه أمواج الطيش الهوجاء التي تسيطر على مَساره الضَّليل. ومن هذا المُنطلق تنتهي رحلتنا مع كتاب “المَخرَج الوحيد” مع المَخرَج الوحيد نفسه؛ وهو الإسلام.
الإسلام الذي يبسط نوره على ظلام رحلة الإنسان، الذي يُخرج التَّائِهَ من المتاهة، الذي يُنهي قلق السعي بمَدد الوحي. لقد تناول الكاتب الإسلام في فصلَيْن -الرابع والخامس- تناولاً مُتباينًا بين كُليَّات الإسلام وجُزئيَّاته. وسأكتفي في هذا المقال وما يليه بالكُليَّات فقط دون الجُزئيَّات ودون الرد على بعض الشبهات -مثل قضيَّة المرأة في الإسلام- لأنَّ الكُليَّات بمجالها الفسيح تفتح رؤى الإنسان على الفكرة، وتُلهمه مزيدًا من دفء اليقين. وسأحاول صناعة نسق مُحدَّد المَعالم من كثير من الشتات حتى أعزِّز من الفائدة.
الطريق التي لمْ تُسلَك

تحت هذا العنوان دعا الكاتب أبناء الثقافة الغربيَّة في نسخة الكتاب الأولى التي صدرت بالإنجليزيَّة. دعاهم إلى طريق الإسلام التي لمْ تُسلَك منهم، والتي لمْ يعدُّوها بين الطُّرق. لكنَّنا إذا نظرنا لأنفسنا في حالتنا الراهنة -نحن المُسلمين العرب- فسنجد أنَّ هذه الدعوة تليق بنا كما تليق بالغربيِّين غير المُسلمين؛ فكمْ ابتعدنا عن الإسلام! وكمْ أبعدناه عن حياتنا ومسارنا، وعن قلوبنا ووعينا! .. ما عاد بعض المُسلمين يستهدون بالإسلام نهجًا، بل اختاروا التخبُّط في طرقات التِّيْه مع الآخرين، كأنْ لمْ يهدِهم الله بالدين سليقةً. فصرنا نشبِه هؤلاء المقصودين بالدعوة بعدما استبعدنا الإسلام مَخرجًا؛ فهيًّا نراه مخرجًا، ونعلم لماذا هو “المَخرَج الوحيد”؟
البحث عن الحقيقة

في وسط التِّيْه العظيم الذي يلمُّ بالفكر الغربيّ والذي يجعل الفرد فيه غارقًا في شتات لا نهاية له من الأفكار الجزئيَّة العَرَضيَّة التي تمتزج بصورة الحقيقة وتحاول التشبُّه بها، وفي وسط ضياع معايير تقييم الأمور والأخلاقيَّات؛ تبرز الحاجة إلى الوصول إلى الحقيقة المُطلقة.
تلك الحقيقة التي أتى الإنسان من حيِّزها وإليها يعود، والتي لا ينضبط سلوك الإنسان إلا بها ولا يهدأ الهدوء الحقَّ إلا من خلالها. وقد طرح الكاتب مثالًا من البحث عن الحقيقة المُطلقة في الفكر الغربيّ ببحث علماء كُثُر عن نظريَّات أقلّ تحكُم الأشياء، وتضبط رؤيتنا إليها، بل بحثهم عن “نظريَّة كلِّ شيء”، أيْ هذه النظريَّة النهائيَّة التي بها يفسِّرون جميع الأشياء.
وبالقطع هذه النظريَّة التي تشمل كلَّ شيء بهذا المستوى من العُموميَّة المُطلقة لا يليق إلا بالحقيقة المُطلقة. ذلك المستوى من الحقيقة الذي يلهث وراءه الإنسان بعد النَّصَب الذي يُصيبه من تقلُّب وجهه بين المذاهب والمعايير طالبًا الحقيقة. قد يُذكِّرنا الموقف هنا بقصَّة سيدنا “إبراهيم” -عليه السلام- حينما تقلَّب بين الحقائق الجُزئيَّة ورأى عجزها عن الوفاء بدور الحقيقة، ولهث ليدرك الحقيقة التي ليس وراءها من حقيقة.
ميزات الإسلام كحقيقة مُطلقة

الإسلام الذي يمثِّل الحقيقة المُطلقة بصفته الدين الحقّ من الإله الحقّ يمتاز بالسمات التي يجب لكُلِّ حقيقة مُطلقة أنْ تمتاز بها. فيجب أنْ تكون الحقيقة المُطلقة واحدةً بسيطةً شاملةً، هذه السمات لا تقع تحت حدود التفاوت، بل هي أيضًا سمات إطلاقيَّة. لهذا الإسلام واحد بنظامه العقديّ وتصوُّره للكون بدايةً ونهايةً، ولا يقبل أيّ تصوُّر آخر في هذا المستوى العُلويّ الذي يقوم عليه الدين (فلا يمكن للإنسان أنْ يعتقد شريكًا لله في الخَلق أو تدبير الكون مثلاً).
كذلك الإسلام بسيط تلك البساطة المُطلقة التي تجعله يدخل قلب الإنسان أيًّا كانت ثقافته وحضارته التي عاش فيها -ونحن نرى ذلك مُحقَّقًا أمام أعيننا كلَّ يوم- ولا يُقصد بالبساطة هُنا أنَّه غير مُعقَّد أو غير مُتراكب، أو أنَّه لا يستطيع تفسير التعقيد، بل يُقصد بها تلك البساطة التي تفسِّر كلَّ الأشياء لأنَّها جاءت من أصل كلّ الأشياء. هذا المستوى من البساطة هو قلب التعمُّق.
وللتوضيح فالقانون الرياضيّ أو المبدأ العلميّ -كهذا الذي نقرأه في كتب العلم أو ندرسه في المدرسة- يكون بسيطًا في هيئته لكنَّه في الوقت نفسه يُفسِّر كمِّيَّة ضخمة من المسائل الجزئيَّة أو الفرعيَّة. ولعلَّنا هنا نعلم لماذا هو بسيط بينما يحلُّ ما يبدو أعقد منه! لأنَّه ذلك المِفتاح البسيط الذي توصَّل إليه أهل العِلم بعد طول نظر في جزئيَّات وبحث وتجربة في دقائق لا حصر لها؛ ثُمَّ خرجوا بهذا المِفتاح الذي هو بسيط في صورته مُستوعِب لكلِّ جُزئيَّاته مهما كثرت وتعقَّدتْ. هذا ما قصده الكاتب من فكرة أنَّ سمة الحقيقة المُطلقة البساطة.
والسمة الثالثة للحقيقة المُطلقة هي الشُّمول وهذا ما يتوفَّر في الإسلام بل لا يتوفَّر إلا به. وهنا يجب أنْ نُوضِّح أنَّ سمات الحقيقة المُطلقة الثلاث تعتمد كلُّ منها على الأخرى. فالبساطة تأتي من الواحديَّة، والشمول يأتي من عنصر البساطة السابق؛ فبساطة القانون العلميّ في المثال السابق هي التي أهَّلته لشمول جزئيَّاته. وكذا هذا الإسلام بعقائده الواضحة البسيطة المُتماشية مع العقل البشريّ وشرائعه وأخلاقيَّاته المُتماشية مع النفس البشريَّة هي ما تحقِّق شموله للإنسان ومُدرِكاته -أيْ قواه المُدرِكة- مهما اختلفتْ لغته أو تباعد مكانه. ونُكرِّر هنا أنَّ كون الإسلام الحقيقةَ المُطلقةَ أتى من أنَّه الدين والنظام الذي ارتضاه الله الإله الحقّ الواحد الأحد.
ويرتكز الفكر الإسلاميّ على سمة تفرَّدَ بها دومًا عن بقيَّة الأفكار والنظريَّات؛ وهي سمة الشمول والتضافُر. ففي الوقت الذي يُعاني العِلم الحديث والفكر العلمانيّ من فقر في هذا الجانب -حيث يميل هذا الفكر إلى الفرديَّة والحلول الآنيَّة التي تستبعد النظر ذا الأفق الواسع- يقدِّم الإسلام دومًا التصوُّر الشامل المُتضافِر الذي يشمل الكون تفسيرًا، ولا تجد أيًّا من جُزئيَّاته تناقض الأخرى بل جميعها مُتضافر مُتكامل. كما يقول الله في كتابه: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) -النساء 82-.
وهُنا يطيب لي أنْ أنقل كلمات “ويليام تشيتيك” التي يصف فيها عُمق الأزمة الغربيَّة:
إنَّ العصر والفكر الحديثَيْنِ يُعانيانِ من عدم وجود مَركزٍ واحدٍ، أو اتجاهٍ واحدٍ، أو هدفٍ واحدٍ، أو أيِّ غرضٍ واحدٍ على الإطلاق.
وبعبارة أخرى ليس ثَمَّةَ “إله” واحد. الإله هو الذي يعطي معنى واتجاهًا للحياة. والعالَم الحديث يستمدُّ المعنى من العديد والعديد من الآلهة. فمِن خلال عمليَّة تكثير لا تنفكُّ عن التزايُد ضُوعِفَ عددُ الآلهة بما يفوق الحصر؛ ليعبُدَ الناسُ ما يروق لهم من الآلهة”.
ميزات الإسلام دينًا حقًّا

تناول الكاتب في بحثه الأديان الزائفة أو المُحرَّفة -التي سمَّاها الدين التقليديّ- ومعايير تمييزها عن الدين الحقّ من خلال كتابات كثير من المُفكِّرين الغربيِّين. وخلص إلى أنَّ الدين الحقَّ يمتاز خاصَّةً بميزات ثلاث سأُنزِلها على الإسلام مُباشرةً دون تجريد:
- الإسلام يردُّ الإنسان عن الكِبْر المَعرفيّ والأخلاقيّ، ويجعله مُتواضِعًا. ويجب أنْ أوضِّح مُراد الكاتب؛ فهذه الخاصيَّة التي قد تبدو في عين القارئ هيِّنةً بسيطة لا تستحقُّ أنْ تكون معيارًا للدين الحقّ هي أَوْلَى المعايير بالمُراعاة.
فما حمل الإنسانَ الغربيّ -وها نحن نقلِّده ونتبعه الآن- والإنسانَ عمومًا في كلّ زمان على البؤس الذي هو فيه إلا هذا الكِبْرُ المعرفيُّ والكونيُّ؛ فكُلَّما أحسَّ في نفسه قوَّةً فجَرَ وتعالى في الكون صائحًا بإنكار الإله وتثبيت نفسه إلهًا لكونه وزمانه، وكُلَّما اعتقد في نفسه معرفةً وعِلمًا رأى نفسه معيار الكون والأزمان وراح يُشرِّع هو، ويكشف هو عن الصواب والخطأ، ويُعرِّف هو ما الحقيقة وما الوهم، ويُنظِّر هو ما الخير وما الشَّرّ.
ثُمَّ بعد هذا الكِبر ينقلب السِّحرُ على الساحر كما يُقال وتنهار كلُّ الأشياء من حوله بفعل هذا الكِبر المُهلِك. ولنا في التجربة الشيوعيَّة خير مثال فقد توافرتْ فيها كلُّ هذه الخصائص؛ وهُنا نسأل أنفسنا: ثُمَّ ماذا حدث؟!
- الإسلام له قابليَّة التطبيق على كلِّ أحدٍ وفي كلِّ زمان. وهُنا يُنبِّه الكاتب إلى الفارق بين عالَميَّة الدين وشموليَّته؛ فالمقصود بالشمول هو قدرة الإسلام على الإحاطة بكافَّة مظاهر ومُتطلَّبات الحياة البشريَّة تفسيرًا وتوجيهًا. أمَّا العالَميَّة فتتعلَّق بالمُخاطَب به والاتساع المكانيّ.
- الإسلام يمتاز بعنصر الأصالة. ويقصد بالأصالة هو ثباته أمام الأزمان وقُدرته على الحفاظ على مُكوِّناته ومُقوِّماته الذاتيَّة وعقائده العُظمى مهما تداخلتْ عليه الأفكار والنظريَّات، ومهما تقادَمَ عليه الزمن. وكذلك قدرته على استيعاب الأفكار الجُزئيَّة التي كانت مسيطرةً على ثقافة مَنْ أسلم -في حال عدم مُخالفتها للعقائد العُظمى- وإعادة هيكلتها وتطويعها للإسلام، وليس العكس. هذه القدرات كلُّها تثبت أنَّ الإسلام هو الدين الراسخ الثابت الذي يمتاز بالأصالة الحقَّة؛ لأنَّه الدين الحقّ. هذا ما كان يقصده المفكِّرون والكاتب بهذه السمات.
سمات تجعل من الإسلام مَخرَجًا فاعلًا في الحياة شاملًا لها
يحتاج كلّ نظام شامل يُطالب أصحابُه بتطبيقه إلى كثير من السمات والخصائص. لكنَّ أهمَّها في نظر كاتبنا ثلاث:
- المُرُونة العمليَّة الذي به يستطيع الإسلام أنْ يكون مُنتِجًا وفاعلاً في حياة كلِّ الناس على تباعُد الأماكن. هذه المرونة بين مصادر الإسلام وتشريعاته وبين التطبيق الفعليّ على كافَّة الظروف المُتباينة بتبايُن أماكن وحضارات تطبيقه. هذه السمة قادرة على فكَّ ثُنائيَّة المُقدَّس والدُّنيويّ في الفكر العلمانيّ، والتي يُسبب بها إشكالاً عظيمًا يملأ به الدنيا ضجيجًا، لكنَّه إشكال فارغ أقرب للوهم منه إلى الحقيقة.
- طابع الإسلام المُوحِّد الذي ينبع من الاعتقاد في التوحيد المُطلق لله -عزَّ وجلَّ-. هذا الطابع نراه في تلبية الإسلام لحاجات الإنسان الرُّوحيَّة والماديَّة، وإضفاء التكامُل بينهما في ضوء رؤية توحيديَّة لقوى الإنسان وتركيبه. بغضّ النَّظر عن أديان كثيرة -ومنها المسيحيَّة على سبيل المثال- تَقسِمُ الإنسان وقواه وتجعل إشباع الجانب الرُّوحيّ دائمًا على حساب الجانب الماديّ، بل تمقت الأخير وتعدُّه شرًّا. هذا ما يقصده الكاتب بهذه السمة.
- استنارة الأحكام الفقهيَّة والأخلاقيَّة الإسلاميَّة بدلالات ومعاني أسماء الله وصفاته. وهذا ما يُفرِّق مجتمع الإسلام عن المجتمع القانونيّ العلمانيّ؛ فهذه الأحكام القانونيَّة الإسلاميَّة ليستْ أحكامًا تُفرض على الناس فرضًا وينصاعون لها كي لا تصيبَهم طائلةُ القانون وعقوباتُه. بل أحكام الإسلام تُؤسِّس حياةً أخلاقيَّةً يسعى فيها الإنسان إلى تطبيق هذه الأحكام لا إلى الهروب منها كُلَّما استطاع ذلك كما يفعل الناس مع القانون. ومثلاً يُمثِّل به خُلُق الصِّدق بين الإسلام والعلمانيَّة. فالمُسلم يَصدُقُ لإرادتِه الصدقَ نفسه كقيمة ذات احترام آتٍ من منظومة الإسلام، بينما يطبِّق العلمانيّ الصدق لأنَّه سلوك له عائد إيجابيّ وقيمة عمليَّة.
وفي مُقارنة بين أُسس الإسلام ورؤيته للإنسان وللمُجتمع يُورد الكاتب تجربة لأستاذ فقه القانون “روبرت جورج” الذي خلُصَ منها إلى أنَّ أيَّ مُجتمع سليم قويم يجب أنْ تتوفَّر له هذه الأركان: احترام الإنسان وحقوقه وكرامته، ومُؤسَّسة زواج ناجحة مُثمرة، ونظام حُكم وقانون عادلانِ وفعَّالانِ. ثُمَّ يُعلِّق الكاتب بأنَّ هذه الأركان التي تعدُّ حُلمًا للمُفكِّر الغربيّ هي من المُسلَّمات الأولى في الإسلام وتعاليمه، وكلُّ مُسلم بحقٍّ يطبقها ويعتقد بها.
لماذا الإسلام هو الحلّ لكلّ البشر؟
هُنا -وقد وصلنا إلى الرمق الأخير من النقاش- سأنفرد برأي لأجمع شتاتًا عظيمًا من الكمّ المعرفيّ الذي ساقه الكاتب في كتابه، وأمحور السمات والمزايا التي تجعل الإسلام المَخرَج الوحيد في دعائم هي:
- وضوح العقائد الإسلاميَّة أو المنظومة العقديَّة في الإسلام وقابليَّتها للإقناع العقليّ والإشباع الرُّوحيّ للإنسان.
- انطباق الإطار الكُلِّي للإسلام والإطار المرجعيّ به على الكون وطبيعة الإنسان.
- مفهوم العبادة في الإسلام وشموله لحياة الإنسان كُلِّها.
وسأُرجئ الدعامة الأولى للمقال الأخير عن عقائد الإسلام، وسأتناول هُنا باختصار شديد الدعامتَيْن الثانية والثالثة في الآتي.
استهداف التشريع في الإسلام لتحقيق مصالح الإنسان والكون

ينقل الكاتب أغراض التشريع الخمسة المَعروفة، ويزيد عليها غرضًا. ومعروف أنَّ التشريع الإسلاميّ في بنيانه الكُلِّي والجُزئيّ يهدف إلى الحفاظ على: الدين والعقل والمال -وسمَّاه الثروة-، والنَّسب أو العِرض، والنَّفس -وسمَّاه الحياة-، ثُمَّ أضاف إليها الحفاظ على البيئة والحياة البرِّيَّة والكون عامةً.
ولعلَّنا نلحظ أنَّ مُستهدَفات التشريع الإسلاميّ تمتاز عن جميع مُستهدفات التشريعات الدينيَّة في أنَّها تنطبق على حياة كُلّ البشر في جميع الأزمان، ومع مُقتضيات العقل السليم لاستمرار الحياة. ومن هُنا يمتاز الإسلام بلا مُناظرة من أيّ دين آخر.
ويضيف إليها مُستهدَفات جُزئيَّة أخلاقيَّة أهمُّها إطلاقًا أنَّ الإسلام سعى إلى احترام الكيان الإنسانيّ عمومًا، والبُعد الكُلِّيّ عن المُسكِرات بكلِّ أصنافها وتنويعاتها، وطلب العِلم وتعظيمه، والحثّ على العمل وطلب الرزق، وغيرها من السمات العُظمى لأيَّة حياة سليمة.
سلاسة وشمول الإطار المرجعيّ في الإسلام
ركَّز الكاتب على بنية التشريع الإسلاميّ حيث نجد المصادر الأربعة للتشريع المُتفق عليها والتي تُؤسِّس البنية الصُّلبة للتشريع الإسلاميّ. هذه المصادر هي: القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة الصحيحة والإجماع المُعتمَد والقياس المُنضبط.
ثُمَّ ركَّز في الأمور الحادثة والجديدة في حياة المُسلمين أنَّ التشريع لها يتمُّ عن طريقَيْن: القياس والمصلحة المُرسَلَة (هذا العنصر الأخير وغيره به تفصيلات كثيرة جدًّا، وليس كلام الكاتب فيها إلا على العموم لا على الخصوص. وأنا هنا أنقل كلامه دون فحص له لضيق السياق).
مع تركيزه على مفهوم “الوسطيَّة” وأنَّه حاكِم عامّ في الإسلام. وكلُّ هذه التفاصيل تصنع إطارًا مرجعيًّا يجعل الإسلام ذا قابليَّة للتطبيق الزمانيّ والمكانيّ.
مفهوم العبادة الشاملة في الإسلام

يؤكِّد الكاتب على الاختلاف التامّ والكامل في مفهوم “العبادة” في الإسلام عن مفهوم العبادة المُعتاد بين التصوُّرات الدينيَّة الأخرى. فالعبادة في الإسلام ليستْ صلوات تُؤدَّى في كنيس كما عند أديان أخرى بل هي كلّ الحياة الإنسانيَّة. فالمُسلم يعبد ربَّه في كلّ فعل من أفعاله، يعبده بمُمارسة حياته مُمارسةً صحيحةً كما أمره الإسلام. وبذلك يغاير الإسلام هذا التصوُّر العلمانيّ للدين وللعبادة فلا يُمكن تطبيق ثنائيَّة الدين الذي في المسجد والدنيا التي خارج المسجد تحت أيّ تصوُّر صحيح للإسلام.
كذلك بهذا المفهوم الشامل للعبادة في الإسلام يتناقَضُ الإسلامُ مع تلك التصوُّرات التي ترى دُونيَّة العمل أمام الإيمان. فالإسلام يجمع بين العمل والإيمان، أيْ بين المستويَيْنِ التنظيريّ والتطبيقيّ في المُمارسة نفسِها والتصوُّر عينِهِ. ومن هنا نرى أنَّ الإسلام ليس مفهومًا أجوف عاريًا عن العمل والمُمارسة الحياتيَّة الفاعلة.
وهنا نضيف جُزءًا آخر من تركيز الكاتب وهي تجربة “الإحسان” بمفهومه الأشهر من حديث (الإحسان أنْ تعبد الله كأنَّك تراه). إنَّها تجربة “مُراقبة الله” في كلِّ الحياة -تعني مُراقبة الله أنْ يدرك المُسلم أنَّ الله مُطلع عليه في كلّ حين، وأنْ يجعل المُسلمُ اللهَ معيارًا أوَّل في كلّ فعل يفعله-. هذه التجربة النفسيَّة الشعوريَّة الشاملة تُغيِّر الإنسان تغييرًا كاملاً، وتقضي على مفاهيم مسمومة مثل العبثيَّة والقلق الوجوديّ وضياع الوجهة في الحياة، وتُرشِّد من أيّ فعل ضارّ قد يُقدم عليه الإنسان.
الإسلام طريق الحياة وليس طريقة حياة
نختم هُنا بهذه الجُملة التي أثارتْ انتباهي وإعجابي من حديث الكاتب، وهي تُلخِّص الكتاب من حيث الدعوة المطروحة فيه. الإسلام طريق الحياة وليس طريقة حياة؛ يقصد الكاتب أنْ يصحح هذا الفهم القاصر الذي شاع بيننا -بفعل عوامل كثيرة أبرزها الآلة الإعلاميَّة العربيَّة- الذي يُصوِّر الإسلام وكأنَّه طريقة حياة (lifestyle)، أيْ مُجرَّد طريق من بين طُرق ومُجرَّد أمور جُزئيَّة نؤديها وحسب.
لكنَّ التصوُّر الصحيح للإسلام وأُطُره يجعلنا نرى أنَّه الطريق الصحيحة للحياة السلمية، وأنَّه المَخرَج الوحيد للبشريَّة.