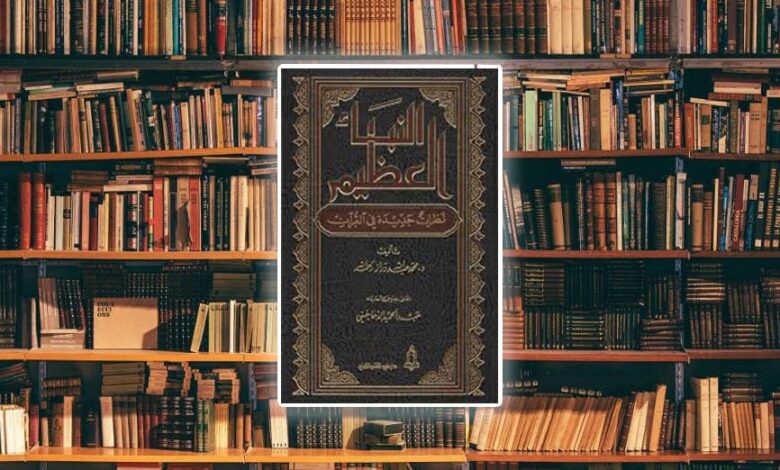
مراجعة كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز
مما جاء في ترجمته في الكتاب: هو الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز، وُلِدَ عام 1894م، وتوفي عام 1958م. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية، وتحصّل على الشهادة الثانوية فيها. تحصل على شهادة العالمية النظامية. عيِّن مدرّسا بالمعهد الديني بالإسكندرية عقب تخرّجه. اختير للتدريس بالقسم العربي بالأزهر الشريف، ثم بقسم التخصص، ثم بالكليات الأزهرية، ثم في قسم التخصص فيها.
اختير مبعوثًا من الجامعة الأزهرية إلى فرنسا للالتحاق بجامعة “السوربون” بباريس. حصل على شهادة الليسانس من السوربون. مُنح مرتبة الشرف عن دراستين للدكتوراه: “مدخل إلى القرآن الكريم”، و”دستور الأخلاق في القرآن”. حصل على عضوية جماعة كبار العلماء بمصر. انتُدِب لتدريس علم تاريخ الأديان بجامعة القاهرة، وإلى تدريس التفسير بكليتَيْ “دار العلوم” بجماعة القاهرة و”اللغة العربية” بالأزهر، وتدريس فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالأزهر.
اختير عضوًا للجنة العليا لسياسة التعليم، وفي المجلس الأعلى للإذاعة، واللجنة الاستشارية للثقافة، إلى جانب اختياره في المؤتمرات الدولية والعلمية مُمثلًا لمصر والأزهر. عُرِف بحسن الخلق والحلم والتواضع، إلّا أنّه كان جريئًا صلبًا قائمًا بالحق.
له عدّة مؤلّفات منها كتاب النبأ العظيم، وفيه يبحث صدق الرسالة من جهة المُخبر بها: أخلاقه وإمكانية أن يأتي به بناءً على علمه وقدراته وظروفه، ثم من جهة القرآن نفسه: إعجازه اللغوي. مُقدِّمًا فيه عملًا عقليًّا رصينًا ودقيقًا. جئت هنا بأفكاره الكُبرى. وفي عودتك للكتاب مزيد إفادة (طبعة دار طيبة، 298 صفحة)؛ من حيث التفصيل والاستطراد، والتمثيلات، والتطبيقات على خصائصه البيانية، إضافةً إلى التمتّع بلطف حسّه وسلاسة أسلوبه الكتابي.
القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينها

يذكر الكاتب أن لفظ القرآن مصدر على وزن فُعلان كالغُفران، نقول: قرأتُه قراءةً وقُرآنًا، ثم صار عَلمًا على كتاب الله. وسُمِّي بالقرآن والكتاب في القرآن نفسه، لكونه مَتلوًّا بالألسن ومكتوبًا في الصحف، وفيه إشارة إلى وجوب حفظه بالطريقتين. وبذلك اختُصَّ بالحفظ لأنه نزل ليبقى أبدًا.
ولا يُعرّف القرآن بالتّعاريف المنطقية للكليات؛ لأنّه جزئي حقيقي، يحدد بالإشارة إليه حاضرًا في الحس أو الذهن. وما ذكره العلماء من التعاريف الكليَّة ليس إلّا تقريبًا وتمييزًا عن أنواع الوحي كالحديث القدسي وبعض الأحاديث النّبوية وسائر كتب الله. فقالوا: القرآن كلام الله تعالى المُنزَّل على محمد ﷺ، المتعبّد بتلاوته.
أمّا الحديث القدسي: فأظهر القولين أنّه منزَّل بمعناه دون لفظه؛ لأنه لو كان منزَّلًا بكليهما لكانت له قدسيَّة وأحكام القرآن، كما أن القرآن نزل به التحدي فكان ذلك موجبًا لإنزال لفظه.
أما الأحاديث النبويّة فنوعان:
توفيقي: هُدِيَ إليه بفهمه في كلام الله أو بتأمّله في الحقائق الكونية. وتوقيفي: تلقى ﷺ معانيه عن الله، وصاغه بكلامه. ويُنسَب إلى النبي ﷺ؛ لأن الكلام يُنسب إلى واضعه وقائله.
والفرق بين الحديث القدسي والنبوي التوقيفي أن الأول معناه مُنزَّل على النبيّ؛ فنُسِب إلى الله بقوله ﷺ: “قال الله تعالى كذا”، أما التوقيفي فلم يُميّز عن التوفيقي.
البحث عن مصدر القرآن
القرآن نفسه شهد أنَّه ليس من قول البشر، وأنه مُنزَّل على النبيّ بلسان عربيّ مبين. ويرى الكاتب في تبرُّؤ النبي ﷺ من نسبة القرآن إلى نفسه؛ دليلًا كافِيًا على صدق تبرُّئه نفسِه، لأنه إقرارٌ يؤخذ به، إذ لا يصحّ تصوّر أن يتبرّأ طالب الزعامة من أنفس جهوده التي توجبها له بلا منازِع، فينسبها إلى غيرِه.
ويردّ على الاعتراض القائل: أنه نسبها إلى الله لبسط نفوذه أكثر من جهتين:
أنّه فاسد في ذاته: لأنه لم يجعل كل أقواله منسوبةً إلى الله. فإذا كان يكتسب بها زعامةً وسلطانًا فلِمَ لمْ ينسبها كلَّها إلى نفسه؟!
وفاسد في أساسه: لأنه يقوم على افتراض أنه لا يُمانع أن يتوسّل إلى الغايات الإصلاحية بالكذب والخداع؛ وهذا خلاف ما كان عليه بشهادة الواقع التاريخي من لزوم الصدق في الدقيق والجليل.
السِيَر وبيان حقيقة أصحابها

يذكر الكاتب أن الإنسان لا يملك حملَ ظاهره على خلاف باطنه باستمرار، فلا بد من أحيانٍ تكون غلبة لحقيقته؛ والنظرُ في سيرته ﷺ يزيدنا يقينًا بصدقه، لِتجلّي أمارات صدقه وإخلاصه.
نماذج من سيرته بإزاء القرآن
استعرض الكاتب مظاهرَ من سيرَته تُدلّل على خروج الوحي عن سلطة نفسه، منها:
- امتناعه عن الكلام عند بعض النوازل التي يتأخر نزول الوحي في شأنها، مع حاجته الشديدة إلى الكلام والقدرة عليه، ومثّل لها بحادثة الإفك.
- نزول الوحي بالتخطئة والعتاب الشديد، حتى في المسائل المباحة، وإعلانه ذلك على ما فيه من حرج وثقل، ونزول الأمر بالشيء الذي لا يحب إظهاره -إنْ كان هو الكاتب-، ومثّل لهذا بآيات عدّة منها أوائل سورة التحريم.
- تمايز شخصية الوحي عن شخصية النبي ﷺ. ومثّل لهذا بالآيات من سورة الأنفال: [مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (69)]. حيث نزلت في شأن إطلاقه أسرى بدر وقبول الفداء منهم. واعتبر الوحي ذلك خطأً وعاتبَه عليه، ثم عفى وأقرّه مباشرةً، بل صيَّرَ عمله قاعدة لما بعده، فلو كان الوحي من عنده لَما تكلّم بالتخطئة والعتاب، وإلّا فما الحاجة لذكر ذلك وقد استقر الأمر إلى الإقرار؟
- توقُّفه عند غامض الأوامر، ومثَّل لها بأمثلة عدّة منها قضية صلح الحديبية.
- تلقّيه الوحي بتعجّل قراءته طلبًا لحفظه، خلاف ما يكون عند اختلاق الأقوال من تَؤَُدَة التحضير، ولم يكن ذلك من عادته قبل النّبوة وبعدها، وكان ذلك أول عهده بالوحي.
بيان عدم إمكان أن يكون من نفسه

يذكر الكاتب أن من معاني القرآن ما لا يُستنبط بالعقل لغياب مقدِّماته، ولا يدركه الوجدان والشعور، وليس مما عاينه حضورًا، ولا سبيل له إليها إلا بإلهام الوحي. منها: أنباء المستقبل؛ وقد شهد على كثير منها وقوعًا، وصدرت بلهجة التأكيد رغم غياب مقدِّمات اليقين والظنّ. هذا مع ما قامت به الشواهد من انتفاء عصمة ظن النبيّ ﷺ في غير شأن الوحي.
ومنها: دقيق أنباء الماضي، وبعض الحقائق الدينية الغيبية (باستثناء وجود خالق خلق الكون لغاية؛ إذ هو مما يستنبطه العقل بمقدماته، ومن مدلولاتِ الفطرة). وهذان شهدت عليهما كتب أهل الكتاب بمجيئها موافقة لها، ولا سبيل له إليها إلا بنقل. فإما أن يُقال: نقلها مباشرةً من الكتب، وهذا متعذّر بأميّته. وإمّا أن يُقال: علّمه أحدٌ من قومِه: وهو متعذّر أيضًا بأميَّة قومه. هذا فضلًا عن كونهما دعوتين لم يدِّعِهما قومه أنفسهم.
وإمّا أن يُقال: علّمه عالم من أهل الكتاب: وفي هذا يردّ الكاتب من أربع جهات:
- أوّلًا: أن خلو التّاريخ من الشهادة به شهادةٌ على عدمه؛ لأنه ليس هيّنا في حقه فيُفوّت، مع إحاطة قومه علمًا به قبل النبوة وبعدها، وحرص الأعداء على إسقاطه.
- ثانيًا: أن القرآن اصطفى من علومهم وأعمالهم بعضًا فوافقها، وفنّد بعضًا، وجاء مبيّنا لمُختَلَفاتهم، وفاضحًا لمخفيّاتهم، ولا يصحُّ مع ذلك أن يكون معلّمه منهم. كما أنّ العلماء الرّاسخين منهم قد آمنوا به.
- ثالِثًا: أن هذا العلم كان محصورًا في قلّة منهم تضنى به إضناءً من أشدّ ما يكون، استدامةً لسؤددِهم أو طمعًا في النّبوة.
- رابعًا: أن اضطراب الطاعنين في القرآن -قديمًا وحديثًا- بين نسبته إلى نفسه وإلى معلّم من البشر، دليلٌ على أن القول ببشرية المعلّم دعوى لا تَقرُّ العقول بها.
ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها
وهنا يتحدّث الكاتب عن الحال الخاصة للنّبي ﷺ أثناء نزول الوحي: كان يحمرُّ وجهه فجأةً، ويعلوه نور، وتأخذه شدة الكرب حتى يتفصّد جبينه عرقًا، ويثقل جسده، ويُسمع قرب وجهه صوت كدويَّ النحل، ثم يُخفف عنه فيتلو علمًا وحكمة.
وبنظر بسيط يُعلم تمامًا أنها عوارض غيرُ اختيارية، ولا تشبه حالات الاضطراب الطبيعية، ولا الطبيعية الشاذّة كاضطراب القوى العصبية. وبذلك يتعيَّن أنّه انفعال ناتج عن قوى خارجيّة، ذاك هو رسول الوحي.
البحث في جوهر القرآن الكريم نفسه عن مصدره
يذكر الكاتب ثلاثة أوجه للبحث في مصدر القرآن من جهة القرآن نفسه: إعجازه اللغوي، والعلمي، والإصلاحي الاجتماعي. وفي هذا الكتاب تناول الوجه الأوّل.
إعجازه اللغوي

يبدأ الكاتب بإجابة بعض أسئلة محتملة للمشكك، ثم يعالجها كالآتي:
أوَّلًا: هل يعتقد نفسه قادرًا على الإتيان بمثله؟
هذه دعوى من نال شيئًا من علم البيان لكن لم يحِط به، وعلاجه إما أن يجدَّ في طلبه فكلما ازداد علمًا عرف إعجاز القرآن، أو أن يجرّب فتؤدّبه العاقبة، أو أن يعتبرَ بمَن حاولوا عبر التاريخ فآلوا إلى سخافة.
ثانيًا: هل يرى غيرَه قادرًا؟
إذًا فعلاجه إما أن يرجع إلى أدباء عصره؛ فيسألهم عن إمكان الإتيان بمثله. فإن قالوا: نعم، طلب البرهان. وإما أن يعود إلى التاريخ خاصّة زمن نزوله؛ حيث بلغت اللغة أشدَّها، فيعتبر بعجز السابقين.
ثالثًا: هل يرى أنَّهم ما عارضوا لانصراف همهم؟
الحقيقة أن هممهم استثيرت حتى كان هو همَّهم الأكبر، فقد كان التقريع البليغ المتكرر الذي رُموا فيه بالعجز علنًا عن مجاراة شيء هو من صنتعهم التي خبِروها ويفاخرون بها، مع رميهم بالسفه والضلال، وهم المجبولون على الأنفة والحميّة، على أن فوزهم في التحدي يعني إسقاط دينه الجديد.
رابعًا: هل يرى أنهم عجزوا لتعطُّل وسائلهم، لا لأن نفس القرآن معجزٌ؟
لو كان كذلك وكان القرآن من جنس مقدوراتهم لما عرفوا عجزهم عنه؛ لأنّ العجز لا يتبيّن إلا بعد التجربة، لكنهم اختاروا عدم التجربة إلّا أقلّهم عددًا وأسفههم رأيًا، لعلمهم ابتداءً بعجزهم.
خامسًا: هل يرى أن القرآن ليس معجزًا لتألُّفه مما أَلّفت به العرب كلامها؟
إن مثل أهل اللغة كمثل مهندسي البنيان، يشتركون في المواد وقواعد البناء العامّة، لكنّهم يتفاضلون في الصنعة سواءً من جهة فنون الزينة أو جودة المواد والبنية، كذلك أهل اللغة يشتركون في مواد اللغة والقواعد، لكنهم يتفاضلون في أداء الغرض بها، والجديد في القرآن أنه ارتقى في الصنعة إلى حدّ الإعجاز. ولا سبيل لمن لا يعرف التفريق بين درجات الكلام إلى معرفة الإعجاز، وإنما يتلقى الشهادة عن أهل الصنعة.
سادسًا: هل يرى تفرُّد أسلوب القرآن من قبيل تفرُّد كل شخص بأسلوبه؟
ليس المطلوب في التحدّي الإتيان بنفس أسلوب القرآن وصورته، بل المطلوب كلام أيًّا كانت صورته؛ بحيث إذا قيس بمقياس الفضيلة البيانية ساواه أو قاربه. فإن قال أيضًا: محمد ﷺ كان أفصح العرب وأبلغهم، وهذا يعني عجز العرب عن مجاراة أسلوبه؛ فلماذا لا نعدّ هذا قدسيَّةً لأسلوب محمد ﷺ؟ جوابه أن التباين بين أسلوبه ﷺ وأساليب العرب هو داخل حد القدرة البشرية، أما القرآن فقد تجاوزها.
تأليفه الصوتي
قدّم الكاتب نظرتين في تأليفه الصوتي كالآتي:
الجمال التوقيعيّ في شكله: يتمثّل في النظام التوزيعي المتّسق للحركات والسكنات، وتوزيع المدود والغُنَّات خلاله باعتدالٍ في حق النَّفَس. وما تنتجه هذه المجموعة من لحنٍ بديعٍ متفرّدٍ متجدّدٍ لا يُمل.
وقد كان العرب يتغنّون بشعرهم، وأقلّ منه إجادةً بنثرهم؛ لكنّهم لم يبلغوا هذا الكمال القرآني في أشعارهم، فضلًا عن أن يبلغوه في نثرهم، ولما كان القرآن جامعًا بين مُتعةٍ لا يجدون شيئًا منها إلا في الشعر، وبين جلال يجدون شيئًا منه في النثر، قصُرت بهم الحيلة عن تحديد ماهيّته، فقالوا أخيرًا: سحر.
الجمال التنسيقي في جوهره: ويتمثّل في نظم حروفه ورصفها وترتيبها، في مجموعةٍ مؤتلفة مختلفة؛ أحدها ينقر وآخر يصفر، وآخر يهمس، وآخر ينزلق عليه النَّفس، وهلمَّ جرًا. لا تجد فيها تكرارًا ولا تخليطًا، ولا رخاوةً ولا تعقيدًا، ولا تنافرَ بينها. وبهذا جمع بينَ جزالة وفخامة البادية، ورقّة وسلاسة الحاضرة.
جانب من الخصائص البيانية

- البيان في القطعة منه
- الوفاء بالمعنى والقصد في اللفظ
الوفاء بالمعنى: إظهار عناصره ودقائقه دون زيادةٍ أو إغفال؛ حيث لا سبيل فيه إلى نقضٍ أو تحسين. وهذا يستحيل حصول كماله إلا نسبيًّا بحسب إحاطة العلم بالمعنى. والقصد في اللّفظ: الإضناءُ به دون الحَيْفِ على المعنى. وهي أيضًا غايةٌ يستحيل حصول تمامِها لأحد.
فكيف إذا كانت الغاية الجمع بينهما؟ هذه غاية تقصر عنها الفِطرة البشرية، ولا نجدها على أتمّها وبدون انقطاع إلّا في القرآن.
- ملاءمة الخطاب القرآني للناس على اختلافهم
قد جرت العادة واقتضت الحاجة أن يُفرَّق بين النّاس في الخطاب؛ فليس يستوي فيه الأذكياء والأغبياء، ولا الملوك والرعيّة، ولا البلغاء وغير البلغاء، إلا القرآن فهو واحدٌ يجده الجميع مقدّرًا بحسبه.
- إقناع العقل وإمتاع العاطفة
ومن تمام البيان وفاؤُهُ حاجة هذين الجانبين باعتدال. ولما كانا جانبين متنازِعين في التكوين البشري لا يصطلحان على الدّوام، كان لازمًا أن يغلب على البيان الإنساني مظهر الغالب منهما، كلّ بحسبه. فالحكماء يقصّرون في حق العاطفة، والشعراء يقصّرون في حق العقل، والقرآن يجمع بين الغايتين على أتمِّهما.
- إحكام ألفاظه واتِّساعها للتأويل
إذا حدّدَ البشر مقاصدهم فإنّها لن تتسع لتأويل، وإذا أجملوا كلامهم آلوا إلى الإلباس والإبهام. وفي القطعة من القرآن نجد -على الوضوح والإحكام- اتِّساعًا، يعود إليها المتدبّر فيهتدي إلى معان أخرى كلها صحيح أو محتمل للصحة، ويهتدي غيره إلى ما لم يهتدِ هو إليه. وبذلك فهو كتابٌ مفتوح على الزمان يهتدي منه كلٌّ بحسب ما يُسّر.
- كله إيجاز
والقرآن إيجازٌ كلّه؛ سواء مواضع الإجمال أو التفصيل، لا يحيد عنه ولو قليلًا، ولا تُؤدَّى معانيه بأقل مما حدّده من اللفظ. ولكل كلمة فائدة جليلة، ولكل حرفٍ معنى. وقد بلغ القرآن من الإيجاز حذفَ شيء من أصول الكلام وأركانِه التي لا يتمُّ عادةً إلّا بها، ويحذف الكلمات والجمل المتلاحقة والمتفرّقة في القطعة، ثم يوظّف الباقي من اللّفظ للقيام بالمعنى بوضوح وعذوبة، حتى يُخال من سهولة تخلُّل المعنى أنَّ ألفاظه أوسع منه قليلًا.
- القرآن في السورة منه
- الكثرة الموضوعية والوحدة المعنوية
ومن كمال البيان -زيادةً على الثراء المعنوي في لفظ مقتصَد- وِحدتُه المعنوية. وتكون بالتنسيق والتأليف بين عناصره. وهذه غاية عسيرة في القطعة ذات الموضوع الواحد؛ إذ تتطلَّب حذقًا وذوقًا في توثيق صلة كل عنصر بروح المعنى، وتوزيع مواقع عناصره بين الأصل والتكميل، والابتداء والتوسُّط والانتهاء، واختيار وسيلة المزج بينها بالإسناد، أو بالتعليق، أو بالعطف، وغيرها.
إن انتهاج القرآن منهج الإيجاز، جعله أكثر الكلام وأسرعه تنقُّلًا بين موضوعاته وأحواله الكلامية من وصف، وتشريع، وقصص، وجدَل، وغيره. وهنا يظهر نوع آخر عجيب من الوِحدة المعنوية: الوحدة الجامعة بين المعاني المختلفة في جوهرها في السورة الواحدة؛ بحيث تنتهي معًا إلى معنًى خاص.
وهذه الغاية على أنّها عزيزةٌ في نفسِها على البلغاء، قد اقترنت بقرائن زادت في الإعجاز، وهي:
- أن أجزاء السور نزلت على تباعد زماني بحسَب دواعي الأحداث، وهذا موجب لفقد الصلة المعنوية بينها.
- أن النبّيّ -صلى الله عليه وسلَّم- كان يتخيَّر مواضع الأجزاء؛ لا بطريقة تتابعية حسب سبق النزول، بل قد يؤخّر ما سبق، ويقدّم ما تأخّر، قبل تمام معرفتها كلّها. وهذا خلاف ما تقتضيه الضرورة العقلية من معرفة مجموع الأجزاء قبل تنظيمها داخل هيكلها الواحد، ولا يجرؤ على ذلك إلا جاهلٌ اعتمد على ظنونه وحدسه؛ فلم يلبث طويلًا حتى كذَّبه الدهر، وإما عليمٌ بصير لكنّه ليسَ من البشر.
وختاما مثّل الكاتب لهذه الخاصيّة بنموذج تطبيقي تحليلي على سورة البقرة في عرضٍ مطوَّل لم يتّسع لي المجال لذكره ها هنا.




