
شرح مختصر لـ الوصية الصغرى للإمام ابن تيميَّة
من أبرز سمات الأمَّة الإسلاميَّة أنَّها أمَّة تشارُكيَّة؛ حثَّها الدينُ على الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر، وجعل النصيحة بين المؤمنين من الركائز التي ترتكز عليها. وفي الحقِّ أنَّ الثقافة العربيَّة على تاريخها المُمتدّ تستجيب لهذا المرتكز؛ فهناك كمٌّ ضخمٌ من آداب القوم يدور حول الحِكمة؛ التي تهدف بدورها إلى إيصال خُلاصة التجربة الإنسانيَّة إلى الغير، وهناك غرضٌ كاملٌ في الشِّعر العربيّ يُسمَّى الوعظ. وواصلت الثقافة العربيَّة هذا السلك -على وجه أكمل- بجعل الإسلام النصيحة رُكنًا في حياة مُتَّبعِيْهِ، في كُمُوم هائلة من النصائح تستعصي على الحصر.
ومن هذه النصائح رسالة “الوصية الصغرى” للإمام “ابن تيميَّة”. وهذه الوصيَّة تنتمي شرعًا إلى أبواب الآداب الشرعيَّة، وأدبًا تنتسبُ -من حيث الشكل- إلى فنّ الرسائل الإخوانيَّة (وهي الرسائلُ غيرُ الرسميَّة، والقسم الآخر من فنّ الرسائل يُسمَّى الرسائل الدِّيوانيَّة، وهي الرسائل الرسميَّة ومُكاتبات الدولة الإسلاميَّة، وكلاهما مُدوَّن في دواوين الأدب العربيّ). وتنتسب إلى فنِّ النصيحة والوعظ -الذي سبق التنويه عنه- من حيث المضمون.
وهنا سأشرح هذه الوصيَّة شرحًا مُختصرًا كاشفًا عن أهميَّتها؛ مُحاولًا التأمُّل فيها، مُنوِّهًا لكُلِّ سمات المنهج الذي سلكه الإمام. وبالعموم تمتاز الوصيَّة بالقصد المُباشر للمعاني، وبالسهولة في الفهم، وكذا تحمل أهمَّ ملامح منهج الفكر عند الإمام “ابن تيميَّة”؛ من اعتماد على المأثور (القرآن والسُّنَّة، وأقوال السلف)، وكذا الاجتهاد الواصل بين النصوص والمُستَقِي منها (من الممكن تحليل النص على هذا الأساس لكنْ سيَخرج هذا التناولُ عن هدفي).
علمًا بأنَّ السهولة التي في الرسالة ليستْ مُطردةً في كتب “ابن تيميَّة”؛ ومراجعة الكُتب الفكريَّة (“درء تعارض العقل والنقل” مثلًا) يُعلمنا بهذا؛ ممَّا يدلُّنا على سمة منهجيَّة للشيخ هو التنوُّع والتدرُّج على حسب مُقتضى الخطاب المُوجَّه، والمادةِ التي يتناولها هذا الخطاب؛ فمناقشةُ الفكر مع غير المُسلِّم به غيرُ تقرير الأصول مع سبق التسليم بها. وسأمضي مع الوصيَّة مُعيدًا تركيبها على أصل فكريّ يبلور ما أودعَهُ الإمامُ فيها، بترتيبها الذي ارتضاه مُؤلفها لها، حتى إذا أدرك إجابةً لسؤال وضعت عليه عنوانًا. والله الموفِّق.
ما هي الوصية الصغرى لابن تيميَّة؟
هي رسالة من الإمام “ابن تيميَّة” يردُّ فيها على سُؤالات تلميذه “أبي القاسم المغربيّ” التي وَجَّهَها له. وهي مُدرَجَة في المُجلَّد العاشر من “مجموع الفتاوى”، طبعة “عبد الرحمن بن محمد بن قاسم”، إصدار “مَجْمَع الملك فهد”؛ وقد عُنونت “سؤال أبي القاسم المغربيّ”. وتَقَعُ في اثنتَيْ عشرةَ صفحةً. وقد اطلعتُ على نسخة منها في كُتيِّب طبعة دار الكتاب والسنة ومكتبة دار الحميضي، إصدار 1996م. مثبت عليها اسم المحقق “صبري بن سلامة شاهين”. وقد شابها الكثيرُ من العوار، وهي محاولة على كل حال. فعدتُ للاطلاع من النسخة المُدرَجة في “مجموع الفتاوى”.
ما هي سُؤالات أبي القاسم المغربيّ لابن تيميَّة؟

إنَّ درجة صعوبة السؤال تأتي قياسًا على عدد من المعايير؛ منها مدى عُمُوميَّة السؤال؛ لأنَّ عُمُوميَّة السؤال تزيد من مسالك الإجابة عنه، ومدى اعتماديَّة السؤال وتأثيره على السائل. وقد توافَرَ في سؤالنا هنا هذانِ الوصفانِ. فقد طلب “أبو القاسم” من الشيخ الوصيَّة بما فيه صلاح الدنيا والآخرة، والتنبيه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، وتبيين أرجح المكاسب، وإرشاده إلى كتاب عليه الاعتماد في علم الحديث، وفي غيره من العلوم الشرعيَّة. رابطًا الإجابة بسمة الاختصار والإيماء أيْ الإشارة وحسب، والدلالة على لُبِّ المعاني لا التفصيل فيها.
فهذا سؤال من أعمِّ ما يُسأل؛ فهو عن محيط واسع يسمَّى “صلاح الدنيا والآخرة”، وهذا سؤال يستهدي الإرشاد من شخص قدَّم وصفًا للإمام “ابن تيميَّة” في بدايته: “يتفضَّل الشيخُ الإمامُ، بقيَّةُ السَّلَف، وقُدوةُ الخَلَف. أعلَمُ مَن لقيت ببلاد المشرق والمغرب”. وهذا الوصف يدلُّ على القبول لما سيُوصي به، واستلهام ما سيأتي عنه. مِمَّا يضع أحمالًا فوق المُستوصَى منه. فكيف تعرَّض الإمام لهذا السؤال الضخم؟
الاستهداء بالكتاب والسُّنَّة في توصية الغير
وقد لجأ الإمام إلى ما يؤدي إليه العقل الصريح؛ وهو الاستقاء من الغطاء الفكريّ والسياق العقديّ الذي يضمُّنا جميعًا “الإسلام”. فبدأ بآية واحدة من القرآن هي: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ) -النساء 131-، وبحديث حمَلَ وصيَّة النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى سيِّدنا “مُعاذ بن جبل”:
يا مُعاذ: اتَّقِ اللهَ حيثما كُنتَ، وأتبِعْ السيِّئةَ الحَسَنَةَ تمحُها، وخالِقْ الناسَ بخُلُق حَسَن.
ثمَّ وصف هذه الوصيَّة النبويَّة بأنها “جامعة” أيْ شاملة لا يخرج عنها شيء. وقد استدلَّ الإمام على كون هذه الوصيَّة جامعةً بمنزلة “معاذ بن جبل” -رضي الله عنه-؛ فأورد أنه كان من النبيّ بمنزلة عَليَّة، وأنَّ النبيّ صرَّح بحُبِّه له، وتشبيهه إيَّاه بإبراهيم الخليل -عليه السلام-، وقول “ابن مسعود” عنه: “إن مُعاذًا كان أمَّةً قانتًا لله حنيفًا”. وهذا يُطلعنا على ملمح من منهج الشيخ في الاستدلال النُّصُوصيّ العقليّ أيضًا.
ولعلِّي هنا أنوِّه على بعض شوائب تشوب هذا الاستدلال؛ حيث البرهان على عُلُوِّ قدر المُوصَّى إليه لا يدلُّ على أهميَّة الوصيَّة هنا في مقام النبوَّة. لسبب واضح أشدَّ الوضوح: أنَّ مقام النبوَّة هو مقام إرشاد عُموميّ، لا يدخل فيه حبُّ شخص من عدمه. وهذا يُخالف الشخوص العامَّة؛ حيث التوصيَّة لأحب الناس غيرُ التوصية للغرباء عنهم. فالنبيّ حالة خاصَّة تَستثني هذا الموقف من الاستدلال بخصوصيَّة المُوصَّى إليه. والأصحُّ هنا في إيراد الاستدلالِ الاستدلالُ بخُصوصيَّة الغرض من الوصيَّة؛ حيث أوصاها النبيّ لمُرسَل من قِبَله إلى “اليَمَن” ليحلَّ في مقام الهداية والإرشاد للناس هناك. فالاستدلال بأنَّها “جامعة” يأتي من خصوصيَّة الموقف، لا خصوصيَّة الشخص.
ولعلَّ الإمام أدرك هذا وعبَّر عن أنَّه ليس استدلالًا بالمعنى المخصوص، بل هو استئناس؛ بقوله: “فعُلِمَ أنَّها جامعة، وهي كذلك لمَن عَقَلها، مع أنَّها تفسير الوصيَّة القرآنيَّة”. فهو هنا يردُّ صحَّة كونها جامعةً إلى العقل وإعماله فيها، وانضوائِها تحت راية المعنى المُرشَد إليه في الآية القرآنيَّة. وبهذا نجمع ملامح منهج الشيخ الإمام.
الفهم التأصيليّ للوصيَّة
إذا نظرنا فيما سبق من حيث المنهج؛ سنجد أنَّ الإمام قد وضع الآية القرآنيَّة إطارًا عموميًّا مُوجِّهًا للتقوى، ثمَّ اعتمد على السُّنَّة في غرض “تفصيل المُجمَل” وتعديد هذا الإطار -أيْ تحويله لبنود تنفيذ-. وهي (سيأتي تفصيل كُلِّ منها):
- معنى “اتَّقِ الله”.
- إطار التقوى في “حيثما كنت”.
- إتْبَاع السيِّئة الحسنة.
- مُخالقة الناس بالخُلُق الحسن.
ثُمَّ اعتمد على الفكر الإسلاميّ ليقول: “أمَّا بيان جمعها؛ فلأنَّ العبد عليه حقَّانِ: حقٌّ لله -عزَّ وجلَّ-، وحقٌّ لعباده. ثمَّ الحقُّ الذي عليه لا بُدَّ أن يخلَّ ببعضه أحيانًا: إمَّا بترك مأمور به، أو فِعل منهيّ عنه”. وهذا اعتماد على النظر في السلوك البشريّ بالإدراك المُباشر. وهو هنا حقَّق كمال الاستدلالات.
ولأنَّ أصغر العناصر هو “حيثُما كنت” فلا داعي لإنشاء عنوان لها؛ فهي تتعلَّق بالتزام التقوى في كلّ الأحوال: سرًّا وعلانيةً، مكانًا وزمانًا. والآن سأنتقل إلى العنصر الذي يليه.
معنى “إتباع الحسنات بالسيِّئات”
وسبب التقديم في الحديث “أتبع السيِّئةَ الحسَنَةَ تمحُها”؛ لأنَّ المقصود هو محو السيِّء لا فعل الحسن. وتنويه الشيخ هنا صادر من فهم للأُطُر العُمُوميَّة لإيراد المعنى في اللغة العربيَّة، والتي أُدرجَتْ -بعده على يد “السكَّاكيّ”- ضمن مُصطلح “علم المعاني”، في باب التقديم والتأخير. وكذلك قرَّر أفضليَّة أنْ تكون الحسنات من جنس السيِّئات لتكون أبلغ في محوها.
والذنوب يزول مُوجبها (يقصد الفعل السيِّء، والأصلُ أثرُ هذا الفعل) بأربعة أشياء:
- التوبة.
- الاستغفار من غير توبة؛ فهذا سبب للغفران. وسببُ قول الإمام “قد يَغفرُ له إجابةً لدعائِهِ” أنَّ الاستغفار دعاءٌ مُوجَّه إلى الله. والأكمل اجتماع التوبة والاستغفار.
- الكفَّارات: وهي نوعانِ: كفَّارات مُقدَّرَة (يقصد مُقيَّدة بذنب مُعيَّن). مثل: كفَّارة الجِماع في نهار رمضان، وكفَّارة الظِّهار. وهي أربعة أنواع: هَدْيٌّ (وهي ذبائح يلتزم بها المُسلم)، وعِتقٌ (يقصد رقاب العبيد)، وصدقةٌ، وصيامٌ. والنوع الآخر “كفَّارات مُطلقة” (يقصد بها غير المرتبطة بذنب معيَّن)، وهي كثيرة ترتبط بلفظ الغُفران في نصوصها. مثل: “مَن قال كذا وعمِلَ كذا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه”، وكذا الصلاة والصيام والصدقة العامَّة.
- المصائب المُكفِّرة: وهي كلُّ ما يُؤلِم من جسد ونفس. (وقد أخَّرها الإمام عن الثلاثة الأُوَل بفاصل كلام عن الجاهليَّة حتى قد تضيع من انتباه القارئ).
إشارته لأزمان الجاهليَّة
وهنا معنًى يستحقُّ التوقُّف عنده؛ حيث يجعل الإمامُ الإسلامَ ضدًّا للجاهليَّة، أيْ أنَّ خروج الناس عن مقتضى سياق الإسلام يردُّهم إلى ما قد اصطلِحَ عليه بلفظ “جاهليَّة”، وهذا الاستخدام يجعل “الجاهليَّة” معنًى لا حقبة، ويُرمِّزها أيْ يجعلها رمزًا لكُلِّ مخالفة فكريَّة كبيرة للإسلام عقيدةً ورُوحًا. يقول: “خصوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تُشبه الجاهليَّة من بعض الوجوه”. ويؤكِّد الإمام على تقرير هذا معنى أنَّ الجاهليَّة ليست حقبةً من الزمن، بل ارتداد عن السياق؛ حينما يربط معناها بحديث:
لتتبعنَّ سَنَنَ مَن كان قبلكم حذو القذَّة بالقذَّة؛ حتى لو دخلوا جُحر ضبٍّ لدخلتُمُوه. قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمَن؟
يعني النبيُّ بسؤاله الاستنكاريّ التأكيد على أنَّهما المقصود. والقُذَّة هي الريش المأخوذ ليُدخل في صناعة السَّهم، والضبّ حيوان.
وراح يعيب على بعض المنتسبين إلى أهل العلم مُشابهتهم أحوال اليهود والنصارى. وإذا سألنا: ما وجه التشابُه المعيب؟ سنجده في وصف القرآن لهؤلاء القوم: أنَّهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، وأنَّهم لمْ يكونوا يتناهون عن مُنكَر فعلوه، وأنَّهم يرمون الله بالكذب؛ فيقولون: يد الله مغلولة، وأنَّهم يبتدعون في الدين ما لمْ يُنزله الله ولمْ يأمر به، وأنَّهم لم ينفِّذوا ما أُمروا به. هذه وغيرها أفعال السُّوء العظمى التي ذكرها الله بشأن اليهود والنصارى. ولعلَّ هذا تفصيل قول الإمام.
ولهذا يجب أنْ يمتنَّ المُسلم لأنَّ الله شرح قلبه للإسلام والإيمان، وأبعده بإيمانه عن كلّ سوء وكُفران. وعليه أنْ يُخالف أحوال الجاهليَّة وأحوال الأُمَّتَيْنِ: المغضوب عليهم والضالين. وفي هذه الأزمان التي يكثر فيها الشبه بالجاهليَّة يجب الإكثار فيها من مبدأ “إتباع الحسنات بالسيِّئات”.
جِماع المُخالقة الحسنة
أمَّا عن “خالِقْ الناسَ بخُلُق حَسَن”؛ فيكون بالتحلِّي بجِماع المُخالقة الحسنة من المسلم إلى غيره. ويأتي بها الإمام من حديث آخر مشهور في تفسير قوله (خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بِالعُرْفِ وأعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ) -الأعراف 199-. ويكونُ بأنْ تصِلَ مَن قطعك، ويبين أنَّ هذا الوصل لا يكون بالزيارة أو المحادثة وحسب، بل بالدعاء له غيبًا، والاستغفار له، والثناء عليه بين الناس؛ فكلُّها وسائل لوصل مَن قطعك، ويكونُ بأنْ تُعطيَ مَن حرَمَك، تعطيه المال والمنافع والعِلم، ويكونُ بأنْ تعفُوَ عمَّنْ ظلَمَك.
أمَّا أقصى ما قد يصل إليه المُسلم من سلوك قويم؛ فهو أنْ يقتدي بسيِّدنا “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- في إتيان جميع ما أمرَ اللهُ به مُطلقًا، ويستدعي الإمام هنا حديث “كان خُلُقُه القرآن”. ويتجسَّد هذا السلوك في طِيْبِ النَّفس وانشراح الصدر وهي تمتثل لما يُحبُّه الله -تعالى- لها أنْ تكون.
مفهوم التقوى عند “ابن تيميَّة”

وقبل أنْ يُنهي إجابته عن سؤال الوصيَّة؛ وقف الإمام لتعريف التقوى، ولمْ يسلك السلوك المُعتاد بالتعريف اللُّغويّ (وهي بالنسبة إليه من وقى، يقي، قِ. بمعاني اتخاذ الحذر، والخوف). بل عرَّفها بقوله:
اسم تقوى الله يجمع فعلَ كلِّ ما أمر الله به إيجابًا واستحبابًا، وما نهى عنه تحريمًا وتنزيهًا.
وهنا يُعلي “ابن تيميَّة” من التقوى؛ فلا يعدُّها سُلُوكًا أو خُلُقًا، بل يعدُّها قيمةً، بل يُجاوز هذا التصوُّر ويعدُّها قيمةً مُساويةً للدين نفسه. وهذا فهم عميق لمفهوم التقوى. ويؤكِّد هذا الإعلاءَ بقوله: “ومعلومٌ أنَّ الإيمانَ كلَّه تقوى الله”، وقوله: “وتفصيلُ أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضعُ؛ فإنَّها الدينُ كلُّه”.
وأكمَلُ مثال للتقوى ما عبَّر عنه في وصف حال العبد التقيّ: “بحيث يقطع العبدُ تعلُّقَ قلبه من المخلوقين انتفاعًا بهم أو عملًا لأجلهم، ويجعل همَّتَه ربَّه تعالى” وهنا أبيِّن الجملة الأخيرة حتى لا تختلط على أحد؛ فالأصل فيها: ويجعل همَّتَه في ربِّه أيْ في سبيل ربِّه، لكنَّه حذف حرف الربط، وحذفُ حرف الربط يصنع صورةً بلاغيَّةً، تزيد قوَّة الترابط في التعبير. ويُكمل: “وذلك بمُلازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقَةٍ -يعني فقرًا-، وحاجةٍ، ومَخافَةٍ، وغير ذلك، والعمل له بكُل محبوب -يقصد فعلًا محبوبًا من جهة الله-“.
رغم أنَّه يُنوِّه على التعريف الاعتياديّ للتقوى: “خشية العذاب المُقتضية للانكفاف -يقصد الكفَّ- عن المحارم”. وهنا يتخذ “ابن تيميَّة” حديث “مُعاذ” الذي استند عليه ابتداءً، وبعض الأحاديث الأخرى مثل “قِيْلَ: يا رسول الله! ما أكثرُ ما يُدخل الناس الجنَّة؟ قال: تقوى الله وحُسن الخُلُق”. وهذا الإيراد منه يدلُّ على عُدُوله عن التعريف الاعتياديّ. وبهذا يتنبَّه “ابن تيميَّة” للفكر الأخلاقيّ الإسلاميّ، وبُناءاته العُظمى.
أفضل الأعمال بعد الواجبات
وينتقل إلى إجابته عن سؤاله الثاني عن أفضل الأعمال بعد الواجبات؛ فيقرِّر أنَّ تحديد هذا بدقَّة غيرُ مُمكن، لكونه يختلف باختلاف العباد وما توفَّر لهم من قدراتهم وأوقاتهم. لكنَّ ما يُشبِهُ إجماعَ العلماء (وهنا لاحِظْ استدلال “ابن تيميَّة” بالإجماع أو ما يُشبهه إنْ لمْ يُوجَد، وهو إكمال منهج الشيخ من التزام الأصول وأقوال الأمَّة المُعتَبَرة) في هذا الأمر: هو مُلازمة ذكر الله. ثمَّ استدلَّ على ذلك بآثار منها حديث “سَبَقَ المُفرِّدون. قالوا: يا رسول الله! ومَن المُفرِّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات“، ونوَّه إلى كثرة الآيات في هذا المعنى (ولاحِظْ هذا السلوك الشائع بين علماء المُسلمين: فإذا كان الأمر المُستَدَلُّ عليه شائعًا جدًّا فلا يحتاجون إلى إتيان دليل بعينه؛ لاعتباره من المُسلَّمات).
ومن أنواع ذِكر الله التي أوردها:
- أذكار الصباح والمساء المعروفة.
- الأذكار المؤقَّتَة: يقصد الأذكار التي لها وقت مخصوص بها: عند الاستيقاظ، وأدبار الصلوات (أيْ عقبها مُباشرةً).
- الأذكار المُقيَّدة: يقصد التي لها موقف تُقال فيه. مثل: دخول المنزل، الخروج منه، نزول المطر.
- الذِّكر المُطلق: وأفضله “لا إله إلا الله”. وبقيَّتُه: “سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله”.
- كلُّ ما تكلَّمَ به اللسان وتصوَّره القلب ممَّا يُقرِّب إلى الله: مِن تعلُّم العلم النافع، والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر.
ويختم بفائدة الاستخارة المشروعة عند اشتباه الأمور على العبد، وكثرة الدعاء، مع عدم تعجُّل الاستجابة، وتحرِّي الوقت الأفضل: كآخر الليل، وأدبار الصلوات، ووقت نزول المطر، وعند الأذان.
أرجح المكاسب
وينتقل إلى إجابته عن سؤاله قبل الأخير عن أرجح المكاسب. والذي يتضح من الرسالة أنَّه يقصد أرجح ما يكسبه العبد ويفيد به نفسَه، ويكون عونًا له على الاستفادة في الدنيا مُراعاةً للآخرة. وعلى ذلك جاءت إجابة الإمام تدلُّ على أنَّ اكتساب اليقين الداخليّ في نفس العبد هو أفضل ما يكسبه وما يكسب به. قال: “التوكُّل على الله، والثقةُ بكفايته، وحُسنُ الظنِّ به”. وكذا التوجُّه إلى الله في كلّ حال:
ينبغي للمُهتمِّ بأمر الرزق أنْ يلجأ فيه إلى الله ويدعوه.
واستدلَّ بأحاديث وآيات، ولاحِظْ هنا منهجه في ربط الآثار بعضها بعضًا حتى تكتمل الصورة أمامه. وسأنقل هنا نصًّا طويلًا كي أدلِّلَ على المنهج: “وقال سبحانه (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّه) وهذا وإنْ كان في الجُمعة فمعناه قائمٌ في جميع الصلوات. ولهذا -والله أعلم- أمرَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- الذي يدخل المسجد أن يقول: “اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك”، وإذا خرج أنْ يقول: “اللهم إنِّي أسألك من فضلك”. وهذا ربط بين النصوص. وكذا نجد سمة التورُّع في التفسير في قوله “والله أعلم”.
ويُكمل: “وقد قال الخليلُ -صلَّى الله عليه وسلَّم- (فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ). وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب”. وهنا يشير الإمام إلى قاعدة أصوليَّة هي: “الأمر يقتضي الإيجاب” أيْ الوجوب في فعل الشيء المأمور به. وفي القاعدة تفصيل كثير عن مُخرِجات الأمر من حد الوجوب، ومن دلالة الأمر المفرد على مرَّة الفعل أو تكراره. تجدون تفصيله عند أهل “أصول الفقه“.
وينتقل إلى بعض تفصيلٍ في آداب كسب الرزق -غير التوجُّه إلى الله الذي سبق-؛ فيذكر ضرورة أنْ يكون العبد سخيَّ النفس في أمر الأموال، ويستحضر أنَّها رزق من الله، فلا يتهالك على اكتسابها، ولا ينظر إلى مال غيره بشهوة سيِّئة في قوله: “ولا يأخذه بإشراف وهلع”. بل المال رزق في يد المُسلم، لا يخرج من يده ليستقرَّ في قلبه. مستدلًّا بقول بعض السلف (لاحِظْ هنا أنَّهم لا يشترطون ذكر صاحب القول طالما كان المعنى المَقول عموميًّا ومُجمَعًا عليه): “أنت مُحتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج” أيْ أشدّ حاجةً.
وكلُّ كسب حلال هو كسب، ولا تفاضُل بين صناعة وتجارة وبناية (المقاولات في زمننا) وحراثة (يقصد فِلاحة) إلا باختلاف ظروف الناس أنفسهم. وليستَخِرْ العبدُ اللهَ متى حار في أمر هذا.
الكُتُب الذي يُعتمد عليها في العلوم الشرعيَّة

يأتي لإجابة آخر سؤال: ما هي الكُتُب المعتمدة في علم الحديث، وفي سائر العلوم الشرعيَّة؟ ليُقرِّر أنَّ هذا يختلف حسب الكُتُب الموجودة في كل قُطر، والشيوخ والمذاهب المتوفِّرة. وهذا يرتبط بعصر الشيخ الذي لمْ يكن فيه من طريقٍ لنقل الكُتُب إلا حفظها أو نسخها باليد -وكان أمرًا مُكلِّفًا مجهودًا أو مالًا للناسخ المُستأجَر-؛ وهنا نحمد الله على أنْ وفَّر لنا وسهَّل علينا.
لكنَّه ينصح بالجُهد في تلقِّي العلم الموروث عن النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-. وهنا أقف لتبيين لبس قد يحدث في وصفه العلم النبويّ قائلًا: “فإنَّه هو الذي يستحقُّ أنْ يُسمَّى علمًا، وما سواه إمَّا أنْ يكون علمًا فلا يكون نافعًا، وإمَّا ألا يكونَ علمًا، وإنْ سُمِّيَ به”. فهنا قد يُعاجِلُك الفهمُ فتفهم أنَّه ينفي صفة “العلم” عن كل الكُتُب في الدنيا إلا العلم النبويّ. وهذا خطأ تمامًا (وبعض لهجة الحسم في عبارات الشيخ تؤدي إلى بعض الفُهُوم الخاطئة).
فإنْ كان هذا الفهم صحيحًا لَانطبق على رسالتنا هذه، وعلى كل كتب الإمام وغيره. وهذا بيِّنُ الفساد؛ فلو كانت غيرَ نافعة ما كتَبَها ابتداءً. بل المُرتَكَز هنا هو تحرير معنى “علم” في عبارته؛ والتي تعني “الهداية الحقيقيَّة” في مُقابل الضلال والتخبُّط الذي قد يأتي من محاولة العقل البشريّ. وهو هنا يقصد الأمور التي لا يمكن حسمها إلا من جهة الله -الذي أرسل هذا العلم النبويّ-، والرجل هنا يتناول مُحاولة البعض لمُنافسة هذه الجهة الحصريَّة في تقرير الحقائق العُليا. ولعلَّ المعنى بعد هذا اتضح، كذا إذا أعدتَ النظر إلى عبارته فستستقيم لك.
ويدلُّ على المعنى المشروح هنا ما أردَفَ به:
ولئِنْ كان علمًا نافعًا فلا بُدَّ أنْ يكون في ميراث محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما يُغني عنه ممَّا هو مِثله وخير منه.
فالحديث هنا عن علم يُنافس العلم النبويّ، ويحاول الاجتهاد بعقله فيما استقرَّ من أمر الشرع على لسان الرسول. ولا يتناول هذا السياقُ كلَّ منظومة العلوم العربيَّة والإسلاميَّة التي قد قعد الشيخ لتعلُّمها وطلبها ليصير شيخًا وإمامًا، وكذا كلَّ منظومات العلوم النافعة الأخرى بصُنُوفها المُختلفة.
ويزيد هذا المعنى تأكيدًا قولُه فيما بعد: “وليجتهد أنْ يعتصِمَ في كلِّ باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وإذا اشتبَهَ عليه ممَّا قد اختلف فيه الناسُ فليدعُ….”. فها هو يتحدث عن الاستحضار والاعتصام بالموروث من الدين، ليفرِّق بينه وبين عنصر “الابتداع المذموم” الذي محوَرَ عليه القول قبله.
وينصح أن تكون همَّة الطالب مُنصبَّةً على فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه؛ حتى يطمئنَّ إلى أنَّه مراد الرسول ويثبت عليه (لاحِظْ أنَّه يُخاطب طالب العلم؛ فعموم المسلمين ليسوا المُطالبين بتحرير القُصُود والمفاهيم). وينصحه بدوام الاستهداء من الله، أيْ طلب الهداية منه.
أمَّا عن كُتُب بعينها فيقول: “فقد سمع منَّا في أثناء المُذاكرة ما يسرُّه” يقصد الإمامُ هنا أبا القاسم الذي وجَّه إليه السؤال؛ فقد كان طالبًا عنده كما ينصُّ الكلام. وأنفع الكتب “صحيح البُخاريّ“، لكنَّه لا يقوم وحده، بل بغيره من كُتُب الحديث، وكذا دراسة كلام أهل الفقه والعلم والاختصاص في كلّ علم وفنّ.
ويختم الشيخُ الإمامُ بدعوة الهداية لطالبه السائل وللجميع. وأختم بدعوته أيضًا، وبالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.


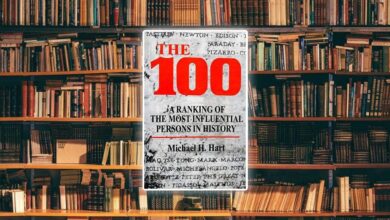
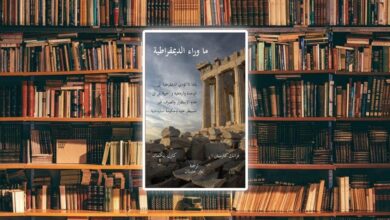

بارك الله فيكم ونفع بكم