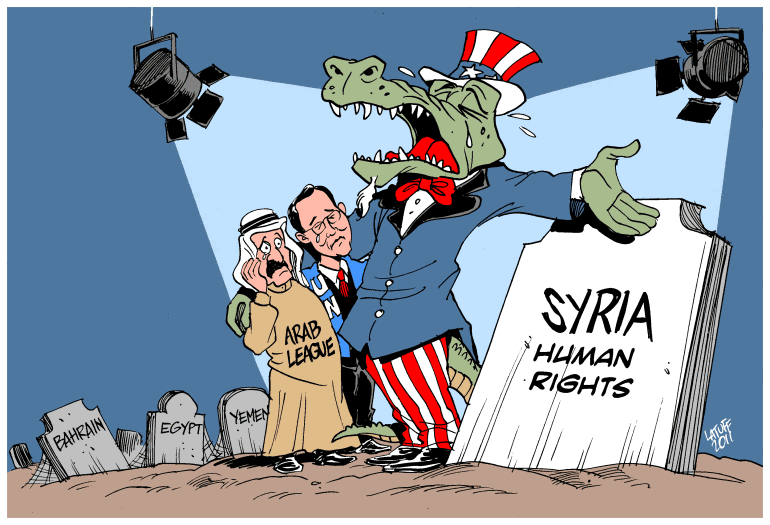فتنةُ قراءة النص.. الخوارج أنموذجًا
إنَّ أول فتنة فكرية حدثتْ في تاريخ الإسلام هي فتنة قراءة النص، ولا نعني به قراءة حروفه وألفاظه، فإن الخوارج ومن خرج من ضِئْضِئِ كبيرهم يُتقنون قراءة ألفاظ النصوص ربما أكثر من الكثير منا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في قراءتهم ((يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم))، كان خطأُ الخوارج الذين قال كبيرهم ذو الخويصرة عبارتَه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم -نبي العدل-: «اعدل يا محمد» فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: ((ويحك ومَن يعدل إن لم أعدِل))، والقصة بطولها مبسوطة في الكتب، وما يهمنا تناوله هنا هو أنه كيف لشخص مثل هذا الرجل، أن يزايد على رسول العدل ويجعل رأيه فوق رأي النبي، حتى يظن أو يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ربما ظلم في قسْمته الغنائمَ، وغاب عنه أنه عليه الصلاة والسلام وحيٌ فيما يقول ويفعل، وأن قسمته للغنائم في الجهاد هي مثلُ صلاته وصيامه وحجه فالكل أحكام شرعية {قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْي}، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر جيدًا، وهو كونه عليه الصلاة والسلام لا يتصرف أصالة إلا بالوحي، وإذا أشْكل عليهم موقفٌ هل تصرف فيه النبي بالوحي أم بالرأي سألوه، فربما أجابهم بأنه الرأي كما في بدر لمَّا سأله الحباب بن المنذر فكان أنْ أشار عليه رضي الله عنه بأن هذا الذي نزلت يا رسول الله ليس بمنزلٍ، وترك رأيه عليه الصلاة والسلام وأخذ برأي الحُباب، وربما أجابهم بأن هذا أمر الله ولن يضيِّعني كما في الحديبية لما ترك شروطًا تضمَّنها عقد الصلح مع قريش فكان أن ترك الصحابة آراءهم وجدالهم ونزلوا عند الوحي الذي يمثله رسول الله صلوات ربي عليه.
ونحن هنا إذ نُذكِّر بهذا فإننا نتناوله لأن أحفاد هذا الخارجي الذين يقرؤون النصوص على طريقته لمَّا يزاولوا يظهرون في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، تحت عباءات مختلفة وتحْويها أدْمغة في رؤوس أصحابها، هذه الكيفية في قراءة النص بل والمزايدة على أصحابه أو الذين جاءوا به لن تُعدم، ما دام في البشر نفَس، فأصحاب هذا التصور يظنون أن لهم الحق في إطلاق عقولهم ذات اليمين وذات الشمال دون رقيب أو حسيب، وذو الخويصرة مثال لذلك، وقبل أن نتحدث عن من خرج مِن ضِئْضِئِه نقول: لو لم يكن عند الرجل إشكال عقدي وخطأ في مدخلات العملية التفكيرية لما اتَّهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، وما أشبه الأمس باليوم، ذلك لو أن التفكير وعملية التفكير صحَّت عند ذي الخويصرة هذا، لَعلِم يقينا أن النبي عليه السلام ليس له أن يظلم أو حتى يبدو منه أي خطأ، ولو جاز خطؤه لجاز ذلك في التشريع كله، لأنه مبلِّغ عن ربه، وأفعالُه وأقواله وحيٌ من الله، والعقل يقضي بأنه إن أخطأ فإن خطأه ينسب لمن بعثه رسولا، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا.
فقراءةُ النص أو التجديد في فهم الخطاب ليس انفلاتًا من النصوص والثوابت عند من يحترم عقله ويعرف وظيفته، وإلا فإن صاحب هذا سيبقى يخبط خبْط عشواء دون أن يظفر بشيء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.

إن قراءة النص قراءةً صحيحة تستلزم من صاحبها أن يقبل ثوابت معينة تكون له بمثابة الركائز والأسس ليبني فوقها وإلا فإن بناءه سينهار، ويقع فوق رأس صاحبه، لأنه ليس بناء أساسًا، وصاحبه أسَّسه على جرف هار، وجدرانه لم تُبن على قواعد ثابتة وأسُس متينة، فالخوارج لم يقبل كبيرهم -ومن خرج من ظهره بعد ذلك- لم يقبلوا الوحي الذي يمثله النبي عليه السلام، وظنوا أن عقولهم مسموح لها أن تسير في كل اتجاه، ولو عقِلوا لعلموا أن النص -بل صاحب النص عليه السلام- فوق أدمغتهم وعقولهم، بل إن التفكير الشرعي الصحيح لا يكون إلا بهذا، وإذا كنا نقول هذا وصاحب النصوص عليه الصلاة والسلام كان مشاهَدا محسوسا أمام هذا الرجل، فإننا كذلك نقول هذا في سنته وما نُقل لنا من أقواله وأفعاله بعد وفاته عليه السلام، فكون السنة مصدرا من مصادر التشريع هي كذلك إلى قيام الساعة، وكل الآيات التي جاءت تعطف الرسول وأقواله وأفعاله على ربه تنطق بأن سنته بعد وفاته هي حجَّة كذلك، وإلا فإننا مأمورون بالأخذ منه في حياته وترك ما جاء به بعد وفاتِه، وهذا لا يقول به مَن آمن بالرسول وحيًا يوحى.

إن ثبات النص سواء كان آية من كتاب الله أو حديثا صحيحًا من أحاديث النبي عليه السلام لا يعطي مساحة كبيرة للمجتهد حتى ينْقلب على رأيه مرات ومرات، ويغيِّر ما غلب على ظنه أنه الصواب، وحتى لو حصل له ذلك فإنه لا يكون كثيرًا أو كبيرًا، وقد بين العلماء -علماء الأصول- في كتبهم الحالات التي يصح فيها تراجع المجتهد عن اجتهاده في المسألة التي له فيها رأي، وليس منها التشهِّي والهوى، إلا أن ذلك كما قلتُ قليل عند المجتهد عينه، وكل ذلك مردُّه إلى ثبات النص قرآًنا كان أو سنة، وليس ذلك مثَلا كالتفكير الذي يجري في النصوص السياسية والأحداث التي يقع عليها الحس، فإن السياسة مظنة التغيير فيها كبيرة، ولذلك فإن صاحب التحليل السياسي أو المجتهد في السياسة ربما تطلب منه الأمر أن يتراجع أو يغير قراءته لعدم ثبات الواقع السياسي والموقف الدولي ومكانة الدولة الأولى في العالم وطول يدها على عملائها، وهكذا…
وبالتالي فإن القول بتجديد الفقه أو باخْتراع مذهب جديدٍ على غرار المذاهب الأربعة أو الخمسة ليس قولًا ذا قيمة، بل هو من لغو الحديث، فالمذاهب ليست اختراعًا لأصحابها وإن نُسبت لهم وبرزت أسماؤهم بها، بل هي تراكمات فقهية واستقراءات شرعية تميز أصحابها بأنهم وضعوا لأنفسهم قواعد وموازين يفهمون النصوص على أساسها، فربما قبِل أحدهم المصالح المرسلة مصدرًا من مصادر التشريع ورفضها بعضهم، وربما قبل أحدهم التعليل بوصف المناسبة أو الشبه أو الطرد حتى لو لم يشهد للوصف دليلٌ متعيِّن وربما رفضه بعضهم، وهكذا فإن آراءهم الشرعية لم تكن تخرج إلا بناءً على قواعد عندهم معتبرة، لذلك اعتُبرت آراؤهم شرعيةً عند من استنبطها أو من قلدها وعمل بها، فالمذهب ليس فقط استنباطات وآراء واجتهادات تجري كيفما اتفق حتى يأتي أدعياء يريدون أن يؤسسوا مذهبًا خامسًا وسادسًا، وإن كنا لا نمنع أن يأتي اجتهاد يخالف المذاهب الأربعة ويكون رأيًا خامسًا أو سادسًا، وإنما المذهب هي طريقة وأسس وقواعد وضعها المجتهد بنفسه وبتلامذته تجري قراءة النصوص وفهمها واستنباطها وفق هذه القواعد والأسس.
وهنا لا بد لنا أن ننبه لأمر هو غاية في الخطورة، وهو أنه قد نبت في الأمة ناشئة علَّلت الشريعة بالمصلحة؛ ما دعاهم إلى جعل المصلحة التي وافقت هواهم هي المصلحة الشرعية، وادعوا أن هذا الأمر قال به أئمة كبار مثل مالك وغيره، مع أنه لا مالك -رحمه الله- ولا غيره يأخذ بالمصلحة أو يقبلها ويعمل بها إذا خالفت الدليل، فأين مالك رحمه الله مِن جَعْل الربا حلالا، وأين مالك من اتفاقية (كامب ديفيد)، وأين مالك من التطبيع مع اليهود، فهذه المصالح الملغاة من الشريعة لا يقول بها مالك ولا غيره وإنما هذه خرجت بالتشهي والهوى.
إن علماء الأصول المعتبرين رحمهم الله فرقوا بين النص الذي لا يحْتمل إلا معنى واحدًا ولا يصحُّ فيه الاجتهاد، وبين النص الذي من قبيل الظاهر فيرجَّح فيه رأي على رأي، وبين النص الذي يحتاج إلى تأويلٍ تحت باب المجاز أو الكناية، وكل ذلك بضوابط معتبرة من أصحاب الصَّنعة، ولم يُترك الأمر لكل من هبَّ ودبَّ أن يفتح هذا الباب ويلج فيه ويعبث بما في داخل البيت.
لقد حارب الإسلام فكرة الخوارج منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها طريقة تودي بصاحبها إلى المهالك، مع أنه يظن أنه صاحب النص والقيِّم على فهمه، وقد يحمل السلاح لأجل أن يحمل كل الناس رأيه، ولا أدل على ذلك من أن الخوارج الأُوَل، قد قتلوا عثمان «بالنص» وقتلوا علياً «بالنص» وكفروا الصحابة «بالنص»، وما زال يخرج علينا أحفادهم الذين استباحوا الدم والمال والعرض بالنص، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ظاهرهم ربما أغرى الكثير بالسير خلفهم والعمل على متابعتهم فهم يتقنون الصلاة والخشوع وقراءة القرآن وكأنها صَنعة لهم ومهنة أبدعوا فيها فيبيتون لربهم سجَّدا وقياما وبعد أن يصلُّوا الفجر يحملون سلاحهم فيقتلون أهل الإسلام نسأل الله السلامة.
أما الفتنة الفكرية الأخرى فهم أولئك الذي نشطت عقولهم حتى تصوَّروا أن الشرع تبَعٌ لعقولهم وأنه لا فرق بين كلامهم وبين كلام الوحي وأن التشريع ليس حصرًا بيد الشارع وإنما لا بأس من جعلهم الشرع كما يفهمون، ولعلنا إن شاء الله نجعل لهؤلاء مقالًا آخر نبين فيه مِن أين جاء الخلل الفكري عندهم وكيف لنا أن نعالجه بحول الله تعالى وقوته.