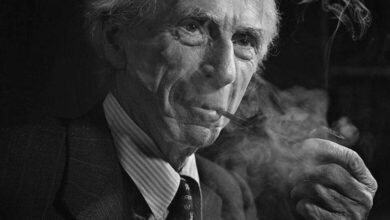وضع العربة أمام الحصان؟.. نداء من أجل تحقيق الديمقراطية في المنطقة العربية
هذا المقال ترجمة لمقالة بعنوان: Putting the Cart before the Camel? لكاتبه: Brian Stewart في موقع: quillette. الآراء الواردة أدناه تعبّر عن كاتب المقال الأصلي ولا تعبّر بالضرورة عن تبيان.
لطالما يُطلب من الحكومات الأمريكية التي تتعاقب على إدارة البيت الأبيض إصدار استراتيجية أمن قومي لها؛ وهي وثيقة رسمية تهدف إلى توصيل الرؤية الخارجية للسلطة التنفيذية الأمريكية إلى نظيرتها التشريعية. فعلى مدار عقود من الزمن، مثلت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي أشمل الجهود المبذولة لحكومات البيت الأبيض لوصف الاستراتيجية العليا لها.
ويُعد نشر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، بين المراقبين المقربين للشؤون العامة، بمثابة فرصة لإبرام نقاشات مكثفة حول الصواب والخطأ في السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة. ولا يعتبر التقرير الأخير الذي تأجل الشتاء الماضي بسبب الغزو الروسي المترقب لأوكرانيا استثناءً عن ذلك. حيث تكونت استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من 48 صفحة، تشمل الدور الكبير للولايات المتحدة الأمريكية حول العالم، وسعي الإدارة إلى الحفاظ على مكانتها بين مصاف الأمم، وكذا ضمان الأمن العالمي وتعزيز انتشار الديمقراطية.
ويلاحظ أن البند الأخير هو الأكثر جدارةً بالملاحظة. فعلى مدار التاريخ الأمريكي، كان إهمال القيم الديمقراطية هو القاعدة الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. وبعبارة أخرى، لطالما تلخص النهج التقليدي التي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة المضطربة، في تسليح الحلفاء أو مساعدتهم ومهاجمة الخصوم، وعدم توجيه أي نداء ذي مغزى لتحقيق الديمقراطية في تلك المنطقة على الإطلاق. حيث كانت سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال الفترات الزمنية التي أعقبت موجة النشاط السياسي التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ متسقة بشكل ملحوظ في التأكيد على استقرار المنطقة دون النظر إلى تحقيق الديمقراطية في بلدانها.
فعلى هذا المنوال تسير استراتيجية الأمن القومي الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حيث تهدف بأفعالها إلى تكرار النظام الحاكم المستبد الذي يُفترض فيه أن المواطن ملك للدولة. فعلى حد تعبير شارل موريس تاليران، وزير خارجية فرنسا الأسبق، حينما قال: “هذا الموقف المناهض للديمقراطية أسوأ من مجرد جريمة، لقد كان خطأ فادحًا”. فطالما كان الحكم الاستبدادي السائد في الشرق الأوسط خطًا للأعمال الوحشية والعدوان الذي غذى التطرف طيلة عقود من الزمان. فبتعهد الولايات المتحدة الأمريكية تقوية حلفائها وشركائها من دول الشرق الأوسط؛ كوسيلة لتعزيز السلام والازدهار الإقليمي، تدعي استراتيجية الأمن القومي أن هذه ليست القضية الأساسية لها.
فوثيقة الاستراتيجية تعطي القليل من الاهتمام لأي أفكار قد تبرز عن التطور السياسي في الأراضي العربية والإسلامية؛ فما بالكم بالاهتمام بتشجيع القوى المدنية والديمقراطية هناك! ينتج هذا الخوف من أن يكون بديل الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط انتخاباتٌ حرة تمكّن المتطرفين من الإسلاميين من الحكم تحت شعار “رجل واحد، صوت واحد، لمرة واحدة”. كما يكشف هذا الخوف أيضًا الرغبة القوية للطبقة الأمريكية الحاكمة في “التمحور” بعيدًا عن الشرق الأوسط والتركيز على قضايا أكثر إلحاحًا في مناطق أخرى من العالم؛ مثل العدوان الروسي في أوكرانيا أو العدوان الصيني الذي يلوح في الأفق في جزيرة تايوان. فأيًا كان الدافع الكائن وراء هذا الميثاق الاستبدادي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإنه يؤكد أسوأ التوجهات الدبلوماسية لهذه الإدارة من خلال تقويض قضية الديمقراطية في أكثر منطقة غير ديمقراطية في العالم؛ وهي الشرق الأوسط.
وجه شادي حامد (المحلل السياسي الذي يعتبر أحد الباحثين والمحللين البارزين في شأن الإسلام السياسي في معهد بروكنجز، وأحد الأصوات النادرة التي تدافع عن ضرورة الوجود الأمريكي في النظام الدولي دون التردد في التنديد بجرائمه وأخطائه المتعددة)، في كتابه الجديد بعنوان “مشكلة الديمقراطية” انتقادات حادة لهذا النفاق الصارخ في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. حيث فضح حامد التكاليف المتصاعدة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى إبقاء ديمقراطية الشرق الأوسط الإسلامي في وضع حرج.
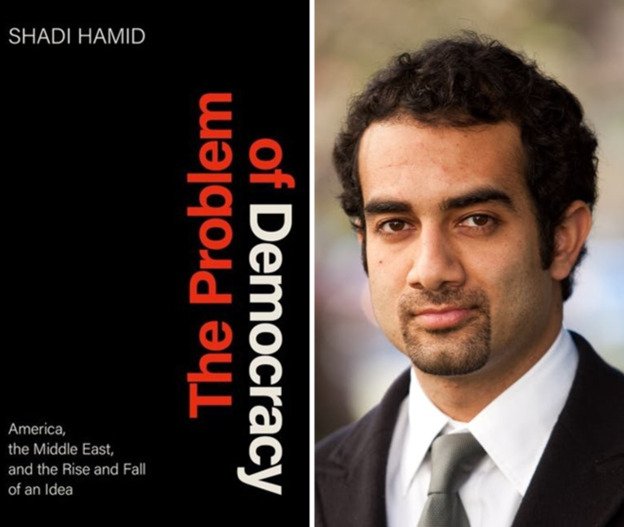
اعترف حامد أن العالم أصبح مكانًا مخيفًا وقاسيًا، وأن الولايات المتحدة لديها مصالح مشروعة في عدم الامتثال إلى مثلها العليا المعلنة. وبالتالي، ليس من الخطأ أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ تدابير وإجراءات خطرة من الناحية الأخلاقية، لحماية نهجها والتمسك بتحقيق نظام دولي جيد. فهذا هو مصير أي قوة عالمية جادة.
وعلى الرغم من ذلك، وكما أوضح في كتابه “مشكلة الديمقراطية”، أن المرء لا يحتاج إلى الاعتقاد أن أميركا قوة شائنة بشكل فريد من نوعه؛ لتشعر بالعار عند مراجعة سلوكها ونهجها الذي اتبعته في منطقة الشرق الأوسط. فأمريكا لا تعمل ولا يمكن أن تعمل كمنظمة إنسانية تجبرها الإساءات والانتقادات على إعادة التفكير في استراتيجيتها الكبرى وتغييرها. ولكن لا ينبغي عليها أيضًا أن تدعم القوى المستبدة دون قيد أو شرط. فلم يكن التناقض بين تصرفات الولايات المتحدة وقيمها المعلنة أكثر وضوحًا في أي مكان في العصر الحديث؛ مما كانت عليه في الشرق الأوسط. حيث انتقد حامد الولايات المتحدة، وقال إن “الولايات المتحدة الأمريكية تسخر من مثلها العليا على مرأى ومسمع من الجميع”.
وقد بدأت عادة تكريم القيم الليبرالية وإحياء إرثها؛ عندما دعمت أمريكا الحكومات الديكتاتورية غير الليبرالية شرق قناة السويس بشكل جدي خلال الحرب الباردة. وذلك كوسيلة لتقييد نفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة العربية والحفاظ على أمن الكيان المحتل والحفاظ على تدفق النفط، في الوقت الذي كان يبيع فيه السعوديون أكثر من 2 مليون برميل من النفط يوميًا للولايات المتحدة الأمريكية. فاستمرت منذ ذلك الحين السياسة الواقعية ذات الدم البارد التي تبنتها أمريكا مبررةً بالخوف الشديد من مطالبة الإسلاميين السيطرة على الحكم البلدان العربية من خلال انتخابات حرة نزيهة. وقد بلغت معارضة النظام التمثيلي ذروتها، عندما أعربت واشنطن رضاها عما يحدث خلال الثورات الشعبية التي اجتاحت الأراضي العربية في عام 2011.
حيث أعلن المسؤولون الأمريكيون، في خضم هذه الاضطرابات الذي تحدث مرة واحدة في الحياة، دعمهم للحركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع الحفاظ على علاقات وطيدة مع الأنظمة التابعة السقيمة التي تهدر مواردها الوطنية ومليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية على الأوليغارشية العسكرية الطفيلية.
كما تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما -الذي لم يقدم سوى القليل من الدعم للمتظاهرين وغرس القليل من الخوف بين الديكتاتوريين-، في كتاب شادي حامد لبعض الانتقادات والتوبيخات المستحقة، عندما صرح بأن هذا العالم يحتاج إلى “عدد قليل من المستبدين الأذكياء”. فلا يسع المرء إلا أن يتعجب من الموقف الضعيف والمتخاذل الذي اتخذه زعيم العالم الحر في هذه اللحظة الفارقة والخصبة لتنامي الإصلاح في العالم العربي.
لم يستغرق الأمر طويلًا قبل هذه الثورات الشعبية، حتى أصبحت المخاطر القاتلة للوضع الراهن واضحة بشكل مؤلم للجميع. حيث قامت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بإعادة توجيه الأجندة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز حق الاقتراع العام في الشرق الأوسط الكبير. هذا لا يعني أن الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت تهدف فقط إلى “تصدير الديمقراطية” إلى الدول التي شُنَّتْ عليها تلك الحروب؛ بل كانت للتدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق أهداف استراتيجية في المقام الأول، حيث كان تقديم تنظيم القاعدة إلى العدالة ومعاقبة النظام الذي آواه هدفًا للتدخلات العسكرية الأمريكية في أفغانستان؛ كما هدف الغزو الأمريكي للعراق إلى إنهاء الأعمال غير المنجزة مع الرئيس الراحل صدام حسين الذي لم يكتفِ باستفزاز رئيس أمريكي واحد، بل ثلاثة رؤساء متتاليين للقيام بعمل عسكري ضده. ولكن بمجرد اتخاذ قرار التصدي لهذه التهديدات، تقرر أيضًا أن السياسات التشاركية وحدها هي القادرة على معالجة هذه الأمور.
اعتقد البيت الأبيض في عهد الرئيس بوش أنه لا يمكن التخلي عن معركة الفكر في النضال ضد المجاهدين. فكان من الواضح أن ظاهرة الجهاد نشأت كحركة معارضة تحت مظلة وحكم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الهاربين. لقد برزت السياسة “الواقعية” المتمثلة في رعاية نظام منحط ومناهض للديمقراطية على أنها أكثر من مجرد خطأ أخلاقي، حيث أظهر انتشار الاستبداد الإسلامي وتعاظم قوته تلك السياسة على أنها فشل استراتيجي هائل.
فبدت الثورات من بعيد، بمثابة استجابة مناسبة للأمراض والتناقضات التي ولدها هذا النظام المهيمن. ففي خطاب ألقاه في نوفمبر من العام 2003 أمام الصندوق الوطني للديمقراطية. قال بوش: “إن تساهل الدول الغربية حيال انعدام الحرية في الشرق الأوسط، على مدى 60 عامًا، لم يحقق شيئًا لجعل الولايات المتحدة في مأمن”. كما قال: “إن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن أن يُشترى على حساب الحرية. وإن الشرق الأوسط سوف يظل مكانًا للركود والامتعاض والعنف الجاهز للتصدير إلى الدول الأخرى ما دام يتم فيها قمع الحريات. لذا، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة جديدة واستراتيجية مستقبلية تهدف إلى غرس الحرية والديمقراطية في دول الشرق الأوسط”.
ووفاءً بكلمتها، قامت الإدارات الأمريكية بدفع مبالغ طائلة للأنظمة العربية الصديقة وتضيق الخناق عليها لتقديم حكومات أكثر مسؤولية، وأسرع من ناحية الاستجابة إلى مطالبها. وقد أجرت مصر انتخابات حرة نزيهة عام 2005 نتيجة الضغوطات الأمريكية عليها، كما سُمح لحماس في عام 2006 بخوض الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث أرادت واشنطن في هذا الوقت تمكين الشعوب العربية وتحقيق الإصلاح في المنطقة بثمن بخس، دون تعريض المصالح الاستراتيجية الأميركية للخطر. ولكن أقل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد، إن نتائج هذا الأمر جاءت متفاوتة. حيث خضعت استراتيجية الحرية التي تبنتها الولايات المتحدة لاختبارها الأصعب عند شن الحرب على العراق؛ حيث تحولت هذه الاستراتيجية إلى عراك دموي غير متوقع وانتهت في النهاية بالدموع والأحزان. كما ضمنت المقاومة، التي برزت من داخل الحكومة الأمريكية حينها -جنبًا إلى جنب مع الأنظمة العربية المصممة على انتظار زوال تلك العاصفة-؛ موتَ استراتيجية الحرية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها في المنطقة العربية.

وبتراجع الولايات المتحدة عن طموحاتها الكبرى في هذه المنطقة العصيبة، سمحت مرة أخرى بتناقص المنافع الأمريكية، عن طريق السماح لتلك الأنظمة الاستبدادية للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي في المنطقة. ولا تزال المنطقة العربية إلى الآن عسيرة على قبول صناديق الاقتراع النزيهة. وقد تمثلت الديمقراطية الوحيدة التي برزت من احتجاجات الربيع العربي في هذه المنطقة في الجمهورية التونسية؛ حيث أدت الديمقراطية في تونس إلى أن يكون الوضع السياسي هناك أقرب للديكتاتورية منه للديموقراطية. حيث استمرت القوى غير الليبرالية في التفشي بينما تركت الدول التابعة القديمة دون رادع؛ مما يهدد حقوق تلك الدول في الديموقراطية.
ويؤكد شادي حامد في كتابه أن الفجوة بين المصالح والمثل الأمريكية قد تم سدها إلى حد كبير مع مجيء دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يتحقق ذلك نتيجة أن أفعالها تتماشى مع القيم التي تدعي أنها تحملها، ولكن لأنها لم تعد تكلف نفسها عناء التحدث نيابة عن حقوق الإنسان. وهذا الأمر يغفل أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هي التي أعلنت في عام 2009 الحاجة إلى تنحية “الأيديولوجية” جانبًا في السياسة الخارجية الأميركية، في إشارة مبطنة إلى “استراتيجية الحرية” وهي السمة المميزة التي تبنتها إدارة بوش.
إن الشكوك الأميركية -أيًا كان مصدرها- في السيادة الشعبية في الشرق الأوسط هي شكوك عميقة إلى حد كبير. حيث تتصور أن مخاطر الديموقراطية وحقوق الانتخاب في ترك المشاعر غير الليبرالية والسياسات الشريرة أكبر من أن يتم قبولها. وقد أعرب الكاتب الصحفي بريت ستيفنز، في كتابه الصادر عام 2014 بعنوان “أمريكا في تراجع“، عن تأييده للأساس النظري لهذا التحيز في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يحاج ستيفنز بأن الاستبداد الليبرالي يجب أن يكون مفضلًا على الديمقراطية غير الليبرالية، “لأن من المرجح أن يتطور النوع الأول إلى ديمقراطية، وأن الثاني أقرب إلى أن يتحول إلى ليبرالية”. فأنا لا أحمل أي ضغينة للأغلبية غير الليبرالية، لكن هذا الأمر يتجاهل نقطة حاسمة للغاية؛ وهي أن حلفاء أميركا في العالم العربي ليسوا ليبراليين ولا ديمقراطيين. فأين هي الثمرة الليبرالية بعد تلك العقود من الحكم الاستبدادي الوحشي؟
سيُقاس الارتقاء بالقيم الراسخة للسياسة الخارجية الأميركية بالأفعال الهادفة، وليس بالكلمات النبيلة. حيث إن الحاجة إلى تعزيز السياسة التعددية في الشرق الأوسط قد طال انتظارها. ولكن لا ينبغي أن يكون لدى الشعوب العربية أو الطبقة الحاكمة أي أوهام حول نوع السياسة التي سيسفر عنها ذلك. كما ينبغي دعم الانتخابات الحرة في المنطقة بشكل جدي، وليس على افتراض خسارة الإسلاميين لتلك الانتخابات. فمن المرجح أن ينتصر الإسلاميون في مثل هذه الانتخابات -مثلما حدث في غزة ولبنان-. فلا أحد له أن يتخيل أن يتخلص الإسلاميون من قناعاتهم ومعتقداتهم بمجرد وصولهم إلى السلطة، ويتحولوا إلى نسخة مسلمة من الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا.
عوضًا عن ذلك، ينبغي على الليبراليين التقليديين أن يضغطوا من أجل تحقيق انتخابات حرة نزيهة، بدلًا من أن يلجؤوا إلى توقعات أكثر دنيوية: ألا وهي أن الإسلاميين سوف يكافحون من أجل حكم البلاد بشكلٍ جيد. حيث إن المناقشات المؤلمة التي ستجري في هذه الظروف ستجلب قلقًا شديدًا للإسلاميين، الذين سيكتشفون أن فكرتهم التي يعتزون بها عن الله -باعتباره المشرع الوحيد للقوانين والأخلاق- ما هي إلا اقتراح مدمر. ومن المرجح أن يؤدي تنافسهم على المنصب إلى التقاتل فيما بينهم وتشويه سمعة أكثر المتحمسين منهم أمام الرأي العام. وسيكون صعبًا -إن لم يكن مستحيلًا- أن نتخيل وجود زعيم إسلامي ديمقراطي فعال على رأس برلمان منتخب يؤيد ويضع سياسة عدوانية ضد الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية على سبيل المثال، مع علمه التام بمدى التداعيات التي ستفرضها مثل هذه المغامرة في الشأن الداخلي قريبًا.
ويستشهد حامد براشد الغنوشي (زعيم حزب النهضة التونسي) الذي قال: “أخطر شيء بالنسبة للإسلاميين هو أن يحبهم الشعب قبل وصولهم إلى السلطة، ثم يكرههم بعد ذلك”. فمخاطر الديمقراطية في منطقة مضطربة مثل المنطقة العربية أكثر وضوحًا من فوائدها. لكن النقطة الفارقة في القضية التي يدافع عنها حامد هو أن الحفاظ على الديكتاتوريات؛ له الكثير من التداعيات الخفية التي تم الاعتراف بها على نطاق واسع في مطلع القرن؛ مثل عدم الاستقرار، والتطرف، وزيادة الامتعاض ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تعد كذلك الآن. ولا تزال هذه المخاطر في تصاعد مستمر.
يحاج حامد أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة مجموعة من الخيارات غير الجذابة، أن تقاوم عمليات منع الأشخاص من التصويت لتقرير مصائرهم. حيث دعمت الولايات المتحدة وفرنسا ضمنيًا قرار الجيش الجزائري بإلغاء نتائج الانتخابات، وقمع الأحزاب الإسلامية في عام 1991. ويقول حامد في هذا الصدد إن هذا الأمر ما هو إلا مثال على ما لا ينبغي فعله؛ حيث اندلعت في هذا البلد التعيس حرب أهلية وحشية بعد فترة وجيزة من الانقلاب. من غير المرجح أن يؤدي انتظار التغيير الثوري -بدلًا من التغيير الديمقراطي- إلى نتائج متجانسة، كما أظهرت كل من ليبيا وسوريا باختلاف الطرق التي أدت إلى ذلك.

ومن الأمثلة الأكثر تشجيعًا في هذا الصدد، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي في البداية، هي تجربة إيران الثورية. فعلي الرغم من كون الحكم الديني الشيعي في إيران خلال الأربعة عقود الماضية كان بمثابة كارثة على المصالح الأمريكية في المنطقة؛ إلا أن تجربة الحكم الديني هناك قد أنتجت نزعة ليبرالية عميقة وموالية للولايات المتحدة الأمريكية بين أبناء الشعب الإيراني. حيث قال المحلل السياسي رويل مارك جيريتشت: “على الرغم من تولي رجال الدين راية الحكم في إيران ونجاحهم في إحباط الجهود المبذولة لنشر الديمقراطية، إلا أن ذلك لم يوقف نمو الثقافة الديمقراطية بين الشعب الإيراني”. إن الثقافة الجهادية التي تقبع وراء النظام الفاشي لإيران قد فقدت شرعيتها بالكامل منذ عهد بعيد، حتى إن استمرت تهدد النظام الدولي بها. وهذا الأمر يتضح من التحريض شبه الدائم ضد الديكتاتورية الدينية في شوارع تبريز وطهران.
إن التناقض بين المُثُل والمصالح العليا للدول أمر لا بد من أن يحدث في السياسات الخارجية لها. ولكن ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها المنشودة، مع الحفاظ على مثلها العليا -قدر الإمكان-. فلا يوجد الكثير لنخسره من الانتخابات في الشرق الأوسط؛ لأن الوضع الاستبدادي الراهن هناك ما هو إلا فشل مثبت من وجهة نظر المبدأ أو الممارسة. وكما أوضح شادي حامد بطريقة مقنعة في كتابه “مشكلة الديمقراطية”، فقد حان الآن الوقت لإعطاء الشعب حقه في الحكم. وينبغي لاستراتيجية الأمن القومي المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم ذلك، كما ينبغي على الطبقة التي تتقلد مقاليد الحكم في أمريكا أن ينهجوا هذا النهج.
ترجم هذه المقالة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مركز ترجمة معتمد وهو فاست ترانس للترجمة المعتمدة المتخصصة في خدمات الترجمة الإسلامية.