
العلمويّ الملحد والهاتف الغريب
لا أعلم تحديدًا من أين جاء الاعتقاد بأن الإيمان هو عملية تسليم عمياء غير مبرهنة؛ قفزة عمياء غير مبنية على دليل. ما يظهر من كل جوانب الإسلام -بما فيها تلك التي يعلمها العامّة- أنها تدل على العكس تمامًا أن: الإيمان (بالتعريف الإسلامي) هو تصديق (أو إقرار وانقياد بعد تصديق) مبنيٌّ على براهين.
أو كما أحب أن أقول واثقًا: هو تصديق مبرهن علميًّا.
وقد يرتقي هذا التصديق بجملة من العوامل إلى اليقين الجازم وهو أعلى درجات الإيمان. وليس يعنينا في هذا المقام التفصيل في درجات الإيمان بقدر ما يهمّنا التأكيد على جذوره البرهانية العلميّة.
ألم يؤيّد الله الأنبياء بالمعجزات لإثبات دعوى النبوّة؟ منطق المعجزة هو أن المدّعي نبوّته يقول: أنا مرسل من الله، بدليل أنني أريكم خارقة لسنن الكون لا يأتي بها إلا خالق هذا الكون على سننه التي تعلمون. وفعلًا أوّل ما يتبادر لذهن مكذب بنبي هو أن يتحداه بالإتيان بآية لا يقدر عليها إلا الخالق، والقرآن يزخر بمثل هذه التحدّيات.

ويزخر القرآن أيضًا بالإشارات إلى المخلوقات، وجوانب العظمة والإعجاز فيها، وما يتبعها من دعوات للنظر والتدبر وإعمال العقل فيما يسميه (آيات) أي براهين وأدلّة.
بل حتى مقامات التسليم العالية التي تُمتدح في الدين مبنيّة على البرهان، وما كان لأصحابها أن يظهروا مثل هذا التسليم لولا استقرار اليقين استقرارًا لا يكون إلا ببراهين راسخة. وأجلّها موقف الصديق أبي بكر في مواجهته بحكاية النبيّ عليه الصلاة والسلام لواقعة الإسراء. يقول: “لئن قال ذلك لقد صدق”، تأمّل هنا كيف اشترط لتصديقه؛ أن يكون هو من قاله؛ أي هذا الشخص الذي أعلم صدقه وأعلم عقله بعينه، وإن أخبرني بما يُحيّر العقل (وتنبه هنا [يحيّر] لا [يناقض]).
قد يقول قائل: كيف لا يناقض العقل؟ فنقول: أولسنا نسافر اليوم إلى أبعد من القدس في سويعات قلائل بالطائرات، أين الاستحالة العقلية؟ قالوا لأبي بكر: أو تصدقه أنَّه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ فقال:
نعم، إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة.
وتأمّل كيف جعل القياس حجّة له عليهم، أن ما تحار فيه عقولكم فتُنكره، لم لا تحار فيما هو أبعد منه ولا تُنكره!؟ لله درّ الصديق ما أكبر عقله.
الإيمان هو تصديق مبرهن علميًا

عودًا إلى مقولة: “الإيمان هو تصديق مبرهن علميًا”، انتبه أن (علميًا) هنا لا تعني حصرًا ما يسمّى اختصارًا (وأحيانًا من باب التعصب العلمويّ -فيما يأتي تعريف للعلمويّ والعلمويّة-) بـ “العلم” ويُقصدُ به العلم الرصدي التجريبي.
العلم عندنا أوسع من العلم المحصور في قناة الحسّ. اقرأ إن شئت مثلًا قوله عز وجل: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [الإسراء (36)]
تأمّل كيف جعل الله للعلم قنوات ثلاثة: السمع وهو دليل الخبر الصادق، والبصر ويدخل فيه الدليل الرصدي التجريبي، والفؤاد ويشمل فيما أحسب باقة من الملكات من ضمنها العقل والفطرة والله أعلم.
والعلمويّ الذي سنناقشه ههنا هو المتبني للعلموية كمذهب، ونعني بها التعصب للعلم الرصدي التجريبي واعتبار أن الحسّ هو المصدر الوحيد للمعرفة. ويتصف غلاة العلموية عادة بإنكار الغيبيّات التي يعتبرونها ميتافيزيقية لا مادّيّة، ويختارون هذا الموقف بناءً على عدم إمكانية رصدها، فهي خارج حيّز ما يسمونه “علمًا”. وأظهر ما يستميت العلمويّون الغلاة في إنكاره على هذا الأساس هو الله، لذلك فقلّما تجد علمويًّا متناغمًا مع مذهبه إلّا وهو ملحد (أي منكر لوجود الله عز وجلّ).
فعندما يتهم العلموي المؤمنَ بالإيمان على تعريفه المشوه للإيمان على أنه الاعتقاد غير المبرهن “علميًا” بمفهومه الضيق للعلميّة، فإنه يصنع لنفسه خصمًا من القشّ.
على أن هذا العلمويّ نفسه يناقض نفسه واقعًا -حتمًا- بوقوعه في نفس ما عابه على المؤمن من الإيمان “اللا علميّ”. فلا يجد مثلًا غضاضة في الإيمان بوجود فيلسوف اسمه سقراط مثلًا في زمن غابر ما، وذلك بقبول الخبر المتواتر بوجوده وإن لم يعاينه بأم عينه ولم يرصده بأدواته العلمية. ويقبل خبر أبيه ببنوّته البيولوجية وإن لم يخض تجربة إثباتها بتحليل حمضه النووي بالضرورة (في غالب الأحيان).

بل ويلبس العلمويّ الملحد عباءة المؤمن -ويسرق من الله في وضح النهار- وهو يباشر عمله بالعلم الرصديّ التجريبيّ نفسه: فيُعمِلُ السببية غير المبرهنة وهو يُفسّر نتائج تجربته، ويؤمن بالانتظام والاطراد في قوانين الكون؛ ومبدأ التجربة أصالةً مبنيّ على هذه المسلّمة إذ يتوقّع أن ما يرصده في الواقع لا بدّ وأن يتكرّر في تجربته داخل مخبره، ويضع لذلك نموذجًا ينتفع به في عملية التوقع. ويؤمن كذلك بالرياضيات وقوانينها الضرورية برغم أنه قد يزعم أنها نتاج عقل تطوريّ تطوّر على عمًى بالانتقاء الطبيعي للأصلح للبقاء، وليس بالضرورة للأصح الأدق في معرفة الحقائق الكونيّة!
وإذا انقلب هذا العلموي الملحد إلى المؤمن يجادله، فإنه يجادله بكل ما أوتي من حجة على أساس أن هذه الآلة البيولوجية المحكومة بتفاعلاتها البيوكيميائية -على قوله هو نفسه- التي يخاصمها تمتلك (إرادة حرة) في مخالفة آلياتها الجبرية واختيار الاقتناع بقول العلموي ورأيه “السديد”!
مشكلة العلموي الملحد أعمق بكثير؛ إذ يزعم بإيمان عميق أن كل شيء في الكون لابد له من تفسير “علمي” (على المعنى الضيق للعلمية طبعًا ولا حاجة لتكرار ذلك) ولمّا يُفسّر بعدُ كلّ شيء “علميًّا” ليُثبت مُعتقده هذا. يقول: لا حاجة لنا بتفسيرات ما ورائية ميتافيزيقية أسطورية إلخ.
ويُغفل في الحقيقة أنه ما من تفسير علميّ إلا ويعود لا بدّ إلى معلومة أو معلومات أولية نعلمها سلفًا بدون إثبات ولا تفسير، إذ يمتنع أن تتسلسل التفسيرات إلى ما لا نهاية. لابد من أدوات أولى يعمل بها العلموي ليُنتج بمنهجه العلميّ شيئًا. لا يمكنه أن ينطلق من العدم وينتج علمًا بـ (كن فيكون). لابد إذًا أن يسرق من الله وإن كابر وتنكر لوجوده.
ضرورة المعلومات الأولية -أو سمّها المبادئ العقلية الضرورية إن شئت- تضعنا أمام معادلة لا حل لها إلا وجود ذات عليّة حكيمة عليمة أعطت الإنسان خلقه ثم هدته لينتج علمًا نافعًا:
إما أن الأدوات الأولية تفتقر لإثبات صحتها، وهو ممتنع لأننا بحاجة لنفس هذه الأدوات لإثباتها، وبغيرها فالإنسان واقع في شلل معرفي تامّ. أو أن هذه الأدوات فطرية مودعة في الإنسان سلفًا ليتمكن بها من خوض تجربة معرفية حقيقية.
قد يحتج العلموي الملحد هنا بأن هذه المعادلة غير مُلزمة قائلًا بأن المعارف الأولية يُمكن تحصيلها عبر أداة الاستقراء؛ أي برصد تكرر أنماط معيّنة وتعميمها إلى كلّيات. فيُردُّ عليه بأن عملية الاستقراء ذاتها وهذه القدرة المعرفية على طرد القواعد مسلّمة عقلية أوّلية! تأمّل حال العجز والافتقار في هذا الإنسان الجاهل لولا أن علّمه الله وإلا لكان أشبه بجهاز حاسوب بلا نظام تشغيل (مثال مقتبس من إحدى حلقات رحلة اليقين) هل يملك من تحليل أي معلومات مدخلة إليه من قدرة؟
ليس الغرض هنا التدليل على وجود الله بفطرية المسلمات العقلية المشتركة عند كل بني الإنسان، وإن كانت دليلًا حقيقيًا ضمن باقة واسعة من الأدلة الفطرية والعقلية والخبرية والحسية على وجوده عز وجلّ (ولعلنا نعرض بعضًا مما كُتب أو نُشر في مختلف هذه الأبواب في مقالات قادمة)، ولكن الغرض هو إلزام العلموي الملحد ومناقشة تصوّراته المعرفية المتناقضة.
لذلك سأسوق هنا مثالًا طريفًا ماتعًا لمشكلة علمية وكيف يكون التعامل “العلميّ” الصحيح معها، بقصد توضيح التصوّر الصحيح عن عملية إنتاج العلم وهدم الأوهام العلموية المتعصّبة، وكذلك بقصد تقريب بعض مفاهيم فلسفة “العلم” بالمثال وكيف ينبغي للعلم الرصدي التجريبي نفسه أن يعمل حتى يكون منتجًا ولا يقع في فخّ التعصب العلمويّ العقيم.
تخيّل معي أننا على جزيرة نائية يُعتقد أنه لم تطأها قدم إنسان من قبل، وجدنا هاتفًا ذكيًّا ملقى على الأرض. قلّبناه، ليس من أي نوع من الهواتف الذكية التي نعرفها. هاتف من نوع غريب لكنه في النهاية هاتف ذكيّ لأنه بشاشة ويشبه أي هاتف معروف، ولأننا توصّلنا لشحنه وتشغيله وبما أننا نمتلك هاتفًا ذكيًا من قبل ونعلم ما هو وكيف استخدامه، استطعنا نوعًا ما التعرف على بعض خدماته أو على الأقل تمكنّا من رؤية جوانب التصميم والغائيّة فيه…
الهاتف الذكي

الآن أنت تتساءل: ما مصدر هذا الهاتف؟ من أين جاء؟ من صنعه؟
للإجابة، أمامنا عدد لا نهائي من الفرضيات. إن لم نُقيّد عملية تخيل الفرضيات التفسيرية بأيّة ضوابط، فإنها في مثل هذه الوضعيات العلميّة لا حدّ لها. يمكنك تخيّل أيّ تفسير.
ولنضع هنا مجموعة مُختارة من الفرضيات حول مصدر هذا الهاتف تساعدنا في المناقشة:
- معتقدنا الأول بأن الجزيرة لم يزرها إنسان من قبل خاطئ. فقد يكون زارها بشر وضيّع أحدهم هاتفه فيها، وإن لم نعرف نوع الهاتف، ذلك بأننا على الراجح لا نعرف كل صانعي الهواتف في العالم.
- كائنات ذكية من خارج كوكبنا زارت الجزيرة وراقبت البشر ولاحظت ملازمتهم أو كثرة استخدامهم لهذا النوع من الجهاز فصنّعت مثله على سبيل التجربة أو لأي سبب من الأسباب، ثم تركته على الجزيرة قصدًا (ربما للتجسس على البشر أو لأي سبب من الأسباب) أو بغير قصد.
- الهاتف جاء بطريقة ما من أحد العوالم الموازية التي يوجد فيها أنواع مختلفة تمامًا من الشركات المصنعة للهواتف.
- الهاتف تخلق بمحض الصدفة والعشوائية من بقايا نفايات بشريّة ساقتها الأمواج إلى شواطئ الجزيرة وبفعل عوامل طبيعية عمياء أخرى (تقلبات الطقس مثلاً).
- حضارة قديمة عاشت من قبل على الجزيرة هي من توصّلت لتصنيعه.
- لا ندري ولكن لنستمر في القول بأن العلم الرصدي التجريبي سيكشف لنا يومًا ما عن السبب لأننا لا نحب الفرضيات 1، 2 و5 لأسباب أيديولوجية خارجة عن الممارسة العلميّة!
- إلخ.
كيفية عمل العلم
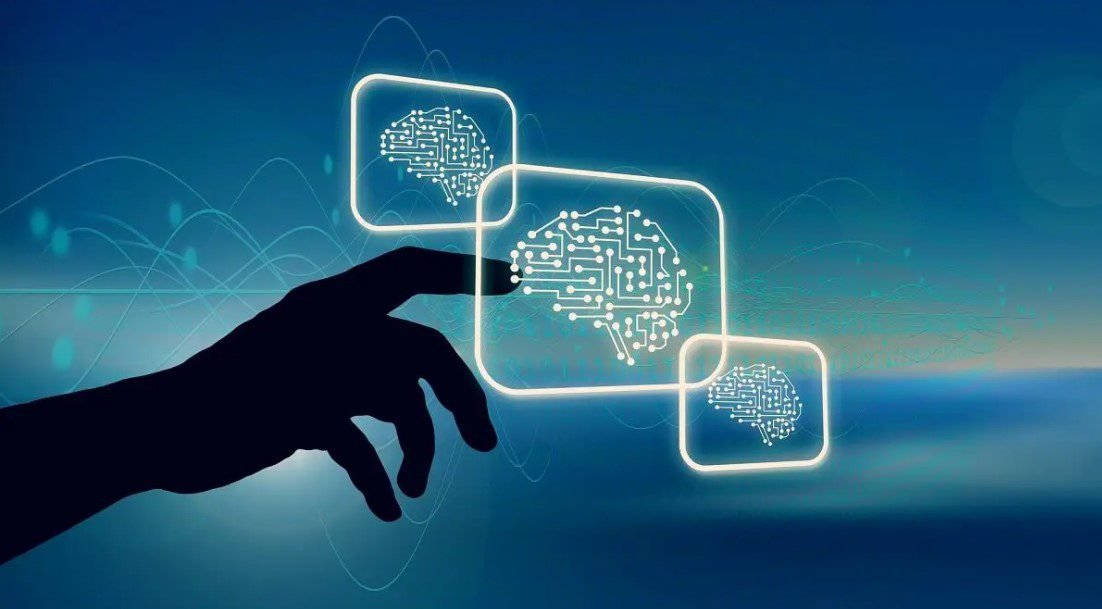
الآن، كيف يعمل “العلم”؟
أولًا: يستبعد العلم الجادّ الفرضية 6 لأسباب بدهيّة؛ 6 ليست أصلًا فرضية، وإنما هي تعبير عاطفي عن العناد والتعصب اللا علميّ. أو -باستعارة تعبير علمويّ شهير “إله الفجوات“- هي “علم الفجوات”. كما أنه لا يمكن استبعاد أية فرضية من البداية فقط لأننا لا نُحبّها؛ يعني بالهوى.
ثانيًا: لأننا بإزاء ممارسة علمية جادة (لا خيال علمي جامح) فلا بد أن نستبعد بداية الفرضيات الموغلة في السخف؛ إما: لاستحالة تحقّقها، كالفرضيّة 4 (أعلم أن هذه الفرضية تذكرك -عزيزي القارئ- بشكل عجيب بنظرية التطور، وهذا مقصود وغير بريء في الحقيقة)، وإمّا لأنها مُسرفة في الافتراض وتطرح بذلك مشكلات (أكثر بكثير مما يواجهنا)، لأسباب منها عدم قابلية الرصد وعدم القدرة على إثباتها بطريق العلم مثلًا، وهذا ينطبق على الفرضية 3 (ومجددًا صدى أوهام العوالم المتعددة في الفرضية غير بريء).
قد يقفز هنا العلموي الملحد مسرورًا ويقول: الفرضية 3 كافتراض وجود الله تمامًا! خطأ. الله بخلاف 3 ضرورة أصلًا لممارسة العلم بل ولا يستقيم شيء بدونه، وفيما أسلفنا تلميح لذلك من خلال مثال المعارف الأوليّة… كما أن براهين وجوده كثيرة حتى في داخل العلم الرصدي التجريبي نفسه، إذ أعماله المتميّزة بالتصميم الدقيق ماثلة أمامنا في كل مكان، كما تتيقن بأن سقراط وُجد بما وصل إلينا من أعماله (فضلًا عن الخبر الصادق) مع الفارق الهائل بين آثار سقراط القليلة المنقولة من زمن سابق، وأعمال الله المنتشرة والمتجددة في كل ركن من أركان هذا الكون، وليس هذا مجال الخوض في تفاصيل ذلك. بالرجوع لوضعيّتنا،
ثالثًا: يشرع العلم الجاد في دراسة الفرضيات الأدنى في الافتراض؛ يعني الأقل افتراضًا؛ لأن كل ما تفترضه يحتاج لإثبات وكل ما تزيده في الفرضية مما لا تدل عليه الوضعية الأولى أو عملية البحث اللاحقة في إثبات الفرضيات الأدنى، يزيد في عبء الإثبات ويعقّد الوضعية بدون موجب. فمن خلال مثالنا، البحث عن وجود شركات أخرى لا نعلمها صنّعت الهاتف أسهل قطعًا من عبء البحث عن أمارات عمل كائنات من خارج كوكبنا لا نعلم حتى طبيعتها؛ فنبدأ به. في الوقت نفسه يمكن بالنسبة لبعض الفرضيات سلوك طريق الدحض لإلغائها أيسر بكثير من ركوب مشقة الإثبات. فبالنسبة للفرضية 5 يمكن على الراجح بدراسة أقدمية مكونات الهاتف دحض إمكان صنعه من حضارة قديمة.
وهكذا بالنسبة للفرضيات العلمية الجادة المتبقية نسلك سلوك الرصد والتجربة لإثبات أحدها قطعًا إن أمكن (مثلًا لو وجدنا الشركة المصنعة لهذا الهاتف وأثبتت لنا أنه من مصانعها قطعنا بصحة 1) أو ترجيحها، إن لم يمكن الإثبات بما يحُفّها من القرائن. وفي خضمّ عملية البحث نُعمل نفس المبدأ في الدحض، والإثبات والترجيح مع كل المكتشفات الجديدة في نفس هذه الوضعية دون التكثر من الفرضيات حتى يقوى الترجيح ويترسّخ.
قد نتوصل إلى ترجيح جملة من الفرضيات المعينة بنسب متفاوتة، وقد لا نصل أبدًا لنتيجة قطعية، لكن من المهم والمعقول في العملية العلمية أن ينصب العمل العلميّ أساسًا على دراسة الهاتف الغريب نفسه، والتعرف عليه أكثر. ولا يعين في دراسته إلا استحضار أنه مصمم لغاية. إذ لولا هذا الاستحضار والسير في سكته، فما نوع الفرضيات التي يمكن ابتداعها حول هذا الهاتف ومكوناته ووظائفه؟! هنا بالذات يكمن الأمل في تحقيق أي نوع من التقدم العلمي في هذا الموضوع وإلا فالسراب والجري العقيم خلف الخيالات الجامحة.
في المقابل، التمسك بعناد بإمكان أن يوجد مثل هذا الهاتف بأي نوع من العمليات العمياء عديمة الغاية، يعيدنا لمربّع الخيال العلمي الجامح، بل ويقودنا لمواجهة مشكلة أعوص في العملية العلمية وهي القابلية للقياس؛ إذ كيف يمكن قياس إمكانية حصول ظاهرة بمعجزة صُدفيّة نادرة لا نجد لها نظيرًا آخر في عالمنا (فلا رصد هنا ممكنٌ) وأي نوع من التجارب يمكن أن يسمح بإعادة إنتاج لهذه الظاهرة جزئيًا أو كليًا في ظروف مخبرية محكمة (فلا تجربة ممكنة هنا أيضًا): ومجددًا، بلا قياس، لا رصد ولا تجربة، مات العلم الرصديّ التجريبيّ، ولا تقدُّمًا معرفيًّا بالمحصّلة إذًا.




