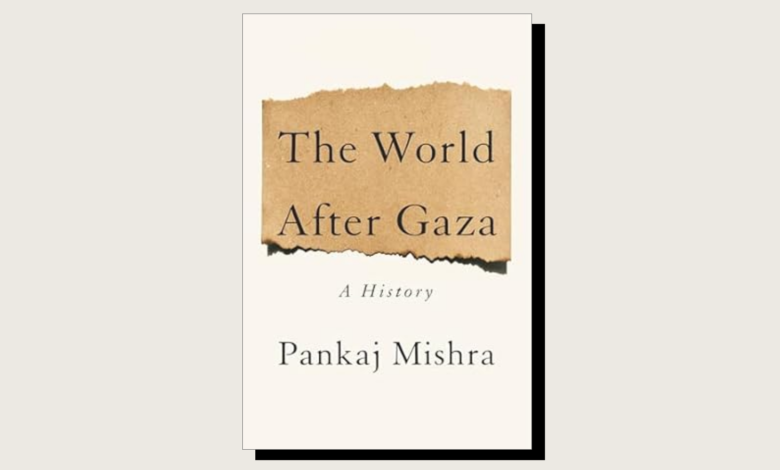
كيف حطمت غزة.. “أساطير الغرب”؟!
لقد حدث الكثير في العالم في السنوات الأخيرة: كوارث طبيعية، وانهيارات مالية، وزلازل سياسية، ووباء عالمي، وغزو وحروب انتقامية، ومع ذلك، لا توجد كارثة تضاهي كارثة غزة، لا شيء ترك لنا مثل هذا الثقل الشديد الذي لا يُطاق من الحزن والحيرة وتأنيب الضمير، لا شيء مثل غزة أعطانا هذا الكم من الأدلة المخزية على افتقارنا إلى العاطفة والسخط، وضيق الأفق، وضعف الفكر، لقد دُفع جيل كامل من الشباب في الغرب إلى مرحلة البلوغ الأخلاقي بسبب أقوال وأفعال وتقاعس الكبار من الساسة والإعلاميين، وأُجبر على أن يستعد بمفرده للتعامل مع الأعمال الوحشية التي تدعمها أقوى ديمقراطيات العالم وأغناها.
بانكاج ميشرا
في 11 فبراير 2025 وبعد أسابيع قليلة من بدء اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، صدر كتاب: (عالم ما بعد غزة – The World After Gaza) للكاتب والمفكر الهندي “بانكاج ميشرا” ليُشعل جدلًا واسعًا حول القضية الفلسطينية، والصهيونية، والاستعمار الغربي، يقدم هذا الكتاب تحليلًا مهمًا للأحداث، حيث يعيد تأطير الصراع من خلال النظرة الواسعة لمفهومي “الاستعمار” و”عنصرية الرجل الأبيض”.
يرى الكاتب أن الاستعمار الغربي هو الجذر الرئيسي للصراع، حيث كانت القوى الغربية مسؤولة عن إنشاء “نظام عنصري عالمي” تعامل مع شعوب آسيا وأفريقيا على أنهم رعايا مستباحون للاضطهاد والإبادة، ويتبنى المؤلف تفسيرًا واسعًا للاستعمار حين يربط النازية بالإمبريالية، وكلاهما غربيّان، وأن (الهولوكوست – المحرقة اليهودية) كانت امتدادًا للجرائم الاستعمارية التي ارتكبها الغرب ضد الشعوب غير البيضاء.
يعترف المؤلف بأنه لم يكن يوما ما داعمًا للقضية الفلسطينية، بل نشأ على الإعجاب بشخصيات إسرائيلية مثل “موشيه دايان “الذي كان يعلق صورته في غرفة نومه!! لكن رأيه تبدل جذريًا بعد زيارة فلسطين في عام 2008، حيث صدمه الواقع القاسي للاحتلال الإسرائيلي، وصدمته مشاهدة (الجدار العازل) حول الضفة الغربية، والحواجز العسكرية، والسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى عزل الفلسطينيين وقمعهم، ما دفعه إلى إعادة النظر في موقفه السياسي.

كما استعرض الكتاب كيفية استخدام ذكرى (الهولوكوست) في السياسة الإسرائيلية، حيث يرى، كما آخرين استشهد بهم، بأن الكيان المحتل استخدم (الهولوكوست) كأداة سياسية تم تحويلها إلى مبرر لاستمرار الاحتلال والاستيطان.
وأشار إلى أن هناك “دائرة تتوسع” حول العالم من الناس الذين يرون أن ذكرى (المحرقة اليهودية) قد تم “تحريفها” لمنح إسرائيل حصانة أخلاقية تتيح لها ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين دون محاسبة.
كما يستعرض المؤلف رؤيته الواضحة حول كيفية تواطؤ القوى الغربية في دعم إسرائيل، رغم انتهاكاتها الواضحة لحقوق الإنسان، ويرى أن الحكومات الغربية، التي تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتبنّى معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، إذ تغض الطرف عن جرائمها، بينما تدين دولًا أخرى بشدة على أفعال أقل جرمًا.
هذا التناقض بات أكثر وضوحًا بعد حرب غزة 2023، حيث ارتكبت إسرائيل مجازر مروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، في حين استمرت القوى الغربية في دعمها دبلوماسيًا وعسكريًا، ويستعرض الكتاب أسباب دعم الغرب لإسرائيل تاريخيًا، موضحًا أن هذا الدعم لم يكن دائمًا بدوافع إنسانية، بل كان مرتبطًا بالمصالح الجيوسياسية.
في هذا الكتاب يصور المؤلف قطاع غزة كـ”مسرح حي للشر السياسي” كما يُعبر، ويسلط الضوء على تواطؤ القوى العالمية في إبقاء المجازر قائمة بلا توقف، ويرى بأن تداعيات ما جرى في غزة أعادت تعريف المساءلة الأخلاقية في عالم مزّقته أكاذيب ودعاوى الإنسانية الزائفة والمخصوصة.
إن الرسالة المركزية لهذا الكتاب تتمثل في ضرورة مواجهة الإخفاقات الأخلاقية للأنظمة العالمية، لذلك فهو يزدري (تعاطف الغرب الانتقائي) واستخدامه لخطاب حقوق الإنسان لتبرير العنف الإمبريالي، ويطالب بأهمية الترابط بين حركات النضال، وضرورة وجود مقاومة موحدة ومناهضة للاستعمار والقمع المنهجي الغربي.
كما ينتقد المؤلف التناقضات الأخلاقية لليبرالية الغربية، ويكشف كيف تعمل هذه الديمقراطيات الليبرالية الزائفة على إبقاء دورات العنف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتداء قناع (التفوق الأخلاقي).
استقبال حافل.. وهجوم عنيف


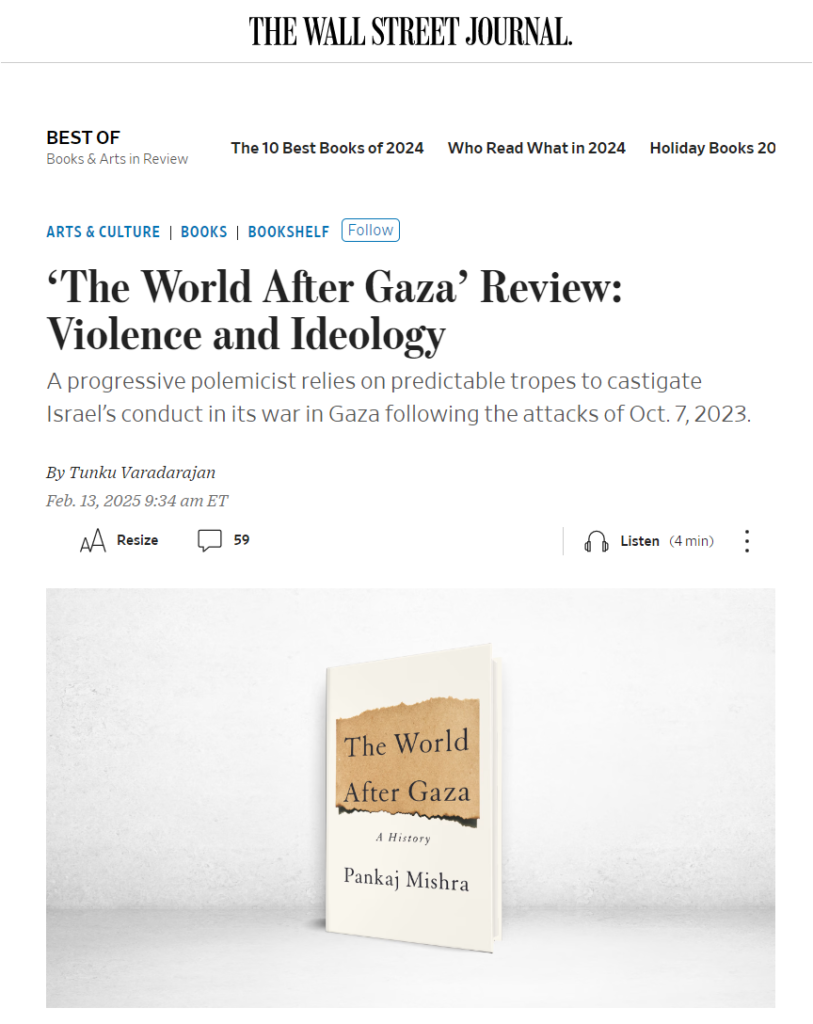
استُقبل الكتاب بكثير من الترحيب من كُتاب كبار مثل “نعومي كلاين” اليهودية الكندية، كما كُتبت عنه مراجعة جيدة في صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، وتم تصنيفه كواحد من أكثر الكتب المنتظرة لعام 2025 من قِبَل صحيفة (الجارديان) البريطانية، ومجلتي (فورين بوليسي) و(تايم) الأمريكيتين.
كما تمت أيضًا مهاجمة الكتاب حتى قبل صدوره من خلال مقالات نقدية لاذعة في صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، و(الجارديان) البريطانية وغيرهما، ففي (وول ستريت جورنال) كتب “Tunku Varadarajan” قائلا: «هذه مراجعة لـ (كتاب بغيض)، يتهم مؤلفه إسرائيل بــ(البغيضة) بسبب حربها على غزة بعد 7 أكتوبر 2023، كما يتهم الدولة اليهودية باستخدام الهولوكوست كحجة لـ”ذبح الأبرياء في غزة بكل وقاحة” السيد “ميشرا” لا يصف قتلة حماس في 7 أكتوبر بالإرهابيين في أي مكان في كتابه، فهم إما “مسلحون” في إشارة واحدة، أو”مقاتلون” في إشارة أخرى، هذا الكتاب يروّج، لا بل يتخبط في نفس الفكرة المبتذلة والمسمومة وغير التاريخية التي يتشاركها أحفاد “إدوارد سعيد” الأيديولوجيون: أن الإسرائيليين اليهود هم (استعماريون استيطانيون)، إن “ميشرا” الذي هو من أصل هندي، راديكالي عنيد مناهض للرأسمالية، وإن حجة (العنصرية) ليست إلا مجرد خدعة يستخدمها الذين يعانون من (رهاب اليهود)، وهذا ما يجعل “ميشرا” وأمثاله خطرًا على اليهود في وسطنا، تمامًا مثل جزاري حماس»!!
كما انتقدت مراجعة صحيفة (الجارديان) التي كتبها “Charlie English” الكتاب ومؤلفه، فقال: «يرى “ميشرا” في نفسه تشابهًا عرقيًا مع العرب، ويدمج هذا الإحساس في نقده، فهو يعتبر أن الهند تحررت من هيمنة البيض، بينما الفلسطينيون “لا يزالون يعيشون كابوسًا كان يجب أن نتركه وراءنا”، كما يبني الكاتب تحليله على شرور الاستعمار الغربي، حيث يرى أن القوى الغربية تعاونت للحفاظ على “نظام عنصري عالمي”، وكان إبادة الشعوب الآسيوية والأفريقية أو اضطهادهم أمرًا طبيعيًا، وحسب قوله، فإن النازية لم تكن سوى امتداد للاستعمار، حيث طبّق “هتلر” أساليبه في أوروبا، مما أدى إلى الهولوكوست كنتيجة طبيعية للإبادات الجماعية التي ارتكبها الرجل الأبيض حول العالم».
وتواصل المراجعة: «من المؤكد أن هذه النظرة ستثير ضده اتهامات بـ(معاداة السامية)، لكنها تعكس أيضًا حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعتمد بشكل متزايد على استذكار المحرقة، ويشاطر الكثيرون “ميشرا” في وصف إسرائيل بأنها “دولة استعمارية استيطانية عنصرية”، لكن تحليله يشوبه الكثير من المشكلات، فهو يتجاهل العلاقة الدينية والقومية العميقة بين اليهود وأرض إسرائيل، كما أغفل وجود المزراحيين (اليهود الشرقيين) الذين لديهم جذور قديمة في الشرق الأوسط، كما قلل من أهمية أعداء إسرائيل، حيث لا يذكر حماس إلا بشكل عابر في الصفحة 34، ولا يناقش هجوم 7 أكتوبر إلا في نهاية الكتاب، حيث يكتب بإيجابية أن “حماس دمرت، بشكل دائم، هالة مناعة إسرائيل”، ويرى أن رد الفعل الغربي على الهجوم كان صدمة “للمهيمنين البيض”، الذين شعروا بأن “قوتهم قد انتهكت علنًا”».
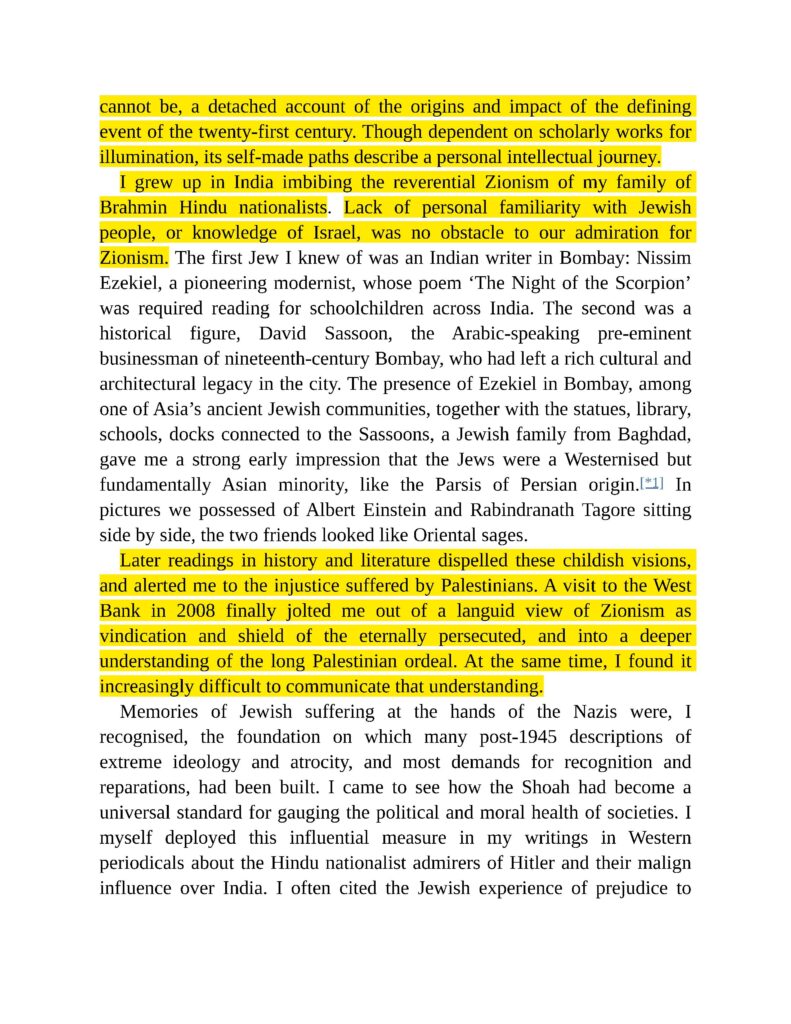
واتهمته (صحيفة الجارديان) كذلك باستخدام “التحليل الأيديولوجي الصارم” رغم أن المؤلف كما يتحدث عن نفسه في مقدمة الكتاب (صفحة 20): بأن عائلته تنتمي إلى القومية الهندوسية البراهمية، ورغم أنه تربى في مدرسة مسيحية في شمال الهند حيث كان يقيم، إلا أنه لم يتحول إلى المسيحية، بل كانت التناقضات التي رآها كما يقول في (الإيمان المسيحي والهندوسي)، هي ما دفعته إلى (الإلحاد)، فيقول في مقال له بعنوان (الله وأنا):
«لم يتحول أيّ من الطلاب الهندوس الذين عرفتهم في المدرسة إلى المسيحية، ويبدو أن تعرضي المبكر للإيمان قد حرضني على (الإلحاد)، فأنا معجب بالنظام الفكري والروحي مثل البوذية، لكنني ظللت بعيدًا عن الدين المؤسسي».
فلا مجال هنا لاتهام المؤلف بالتفسير الأيديولوجي المتشدد، والتحليل الانتقائي، أو تجاهل تعقيدات الصراع العقدية، بل إن الجرائم البشعة وغير المسبوقة للكيان المحتل، والتواطؤ الغربي الفج، هي التي حركت وحفزت (إنسانية) الكاتب لتأليف مثل هذا الكتاب.
وكنت قد انتهيت من قراءة مقدمة الكتاب المميزة، لكن قبل إكمال الكتاب وجدت للمؤلف مقالًا في مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية يتحدث فيها حول الكتاب، بعنوان: (كيف حطمت غزة أساطير الغرب) وقد لخص فيه الكتاب بشكل جيد، ثم تبع ذلك حوار له مع رئيس تحرير ذات المجلة بعنوان (لماذا العالم مستقطب بشدة حول غزة)، لذا خشية الإطالة حول هذا الكتاب؛ فسأكتفي هنا ببعض فقرات الحوار، ثم أختم بنص المقال كاملًا.
الدافع وراء تأليف الكتاب
السؤال الافتتاحي للحوار من رئيس تحرير مجلة (فورين بوليسي): «أخبرني لماذا اخترت تأليف هذا الكتاب؟»
جواب: «لم أكن لأكتب هذا الكتاب لو لم يحدث السابع من أكتوبر، ولم نشهد هذا الرد الإسرائيلي غير المتناسب تمامًا، فعندما رأينا الفظائع والمجازر وقتل الأطفال أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر، كان هناك الكثير من تراكمات اليأس والإحباط على حد سواء، ولم أكن الشخص الوحيد الذي شعر بذلك، لكن ككاتب، كان أحد الأشياء التي يمكنني القيام بها هو التفاعل مع هذا الموقف من خلال اللجوء إلى الكتابة، إلى الجُمل، إلى التفكير، إلى جعل الأمر منطقيًا ولو على الورق، كان هذا هو الدافع الأولي وراء الكتاب.
كنت أسعى للإجابة على عدة أسئلة محيرة للغاية، منها: كيف انتهى الأمر بدولة تأسست لتكون (مأوىً للناجين من الهولوكوست) إلى أن تقوم بارتكاب مثل هذه الفظائع بحق شعب آخر؟ هذا واحد من تلك الأسئلة التاريخية الكبيرة التي يجب الإجابة عنها بكل تعقيداتها، سواء كان ذلك أخلاقيًا أو جيوسياسيًا، نحن نميل فقط إلى النظر إلى تاريخ الشرق الأوسط أو التاريخ الفلسطيني أو تاريخ اليهود الأوروبيين، لكنني أعتقد أن هناك أسئلة أخلاقية أكبر ما زالت كامنة هناك تحتاج إلى إجابات واضحة، كما يجب أن ندرك أن الذاكرة الخاصة بالهولوكوست في إسرائيل لم تنشأ صدفةً؛ بل كانت نتاج بناء متعمد ومخطط، ومن الضروري النظر في كيفية “زراعة هذه الذاكرة” والسرديات حولها بشكل مشابه في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، في ألمانيا».
إسرائيل .. خطيئة غربية
سؤال: «كتابك لا يعيد صياغة الصهيونية ودولة إسرائيل فحسب، إنه يضع إسرائيل في سياق الهيمنة والذنب الغربيين؟»
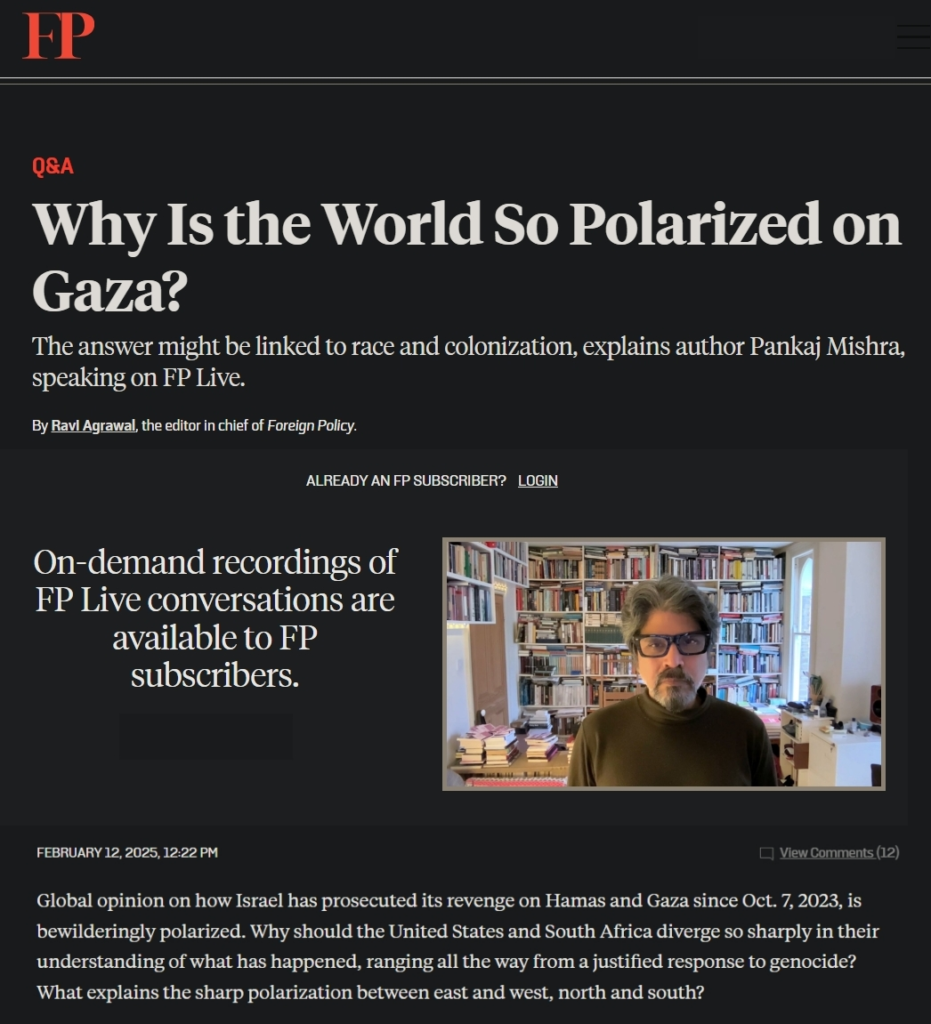
جواب: «منذ تأسيسها، كانت إسرائيل تتماهى بشكل متزايد مع الغرب الأبيض، إذا جاز التعبير، وبشكل أكثر تحديدًا مع النمط الغربي للاستعمار الاستيطاني في أوائل القرن العشرين، لذا من المهم إدراك أن المواقف الغربية تتغير بمرور الزمن، ولكن لصالح إسرائيل دائمًا، وبطرق تؤجج العداء والصراع».
غزة .. أكبر الصراعات تأثيرًا
سؤال: «لماذا تعتبر غزة أكثر تأثيرًا من الصراعات الأخرى التي تعصف بالكوكب الآن؟»
جواب: «في رأيي هناك إجابات بسيطة جدًا على هذا السؤال، أحدها أن الهجوم على غزة تم بثه على نطاق واسع، سواء من قبل مرتكبيه أو من ضحاياه، كان هناك سيل لا يتوقف من مقاطع الفيديو والصور الحية، وعلى الرغم من عدم السماح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة، كان هناك عدد من الكتاب والصحفيين والنشطاء والمدنيين الفلسطينيين الذين نشروا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للمنازل التي سويت بالأرض، والمدارس التي قصفت، والأشخاص الذين ينتشلون الأطفال من تلال الأنقاض، وهذا لا يشبه أي فظائع أخرى اليوم أو في العقود الأخيرة.
إن الاعتداء على السكان في غزة لم يتم تأييده فقط من قبل الديمقراطيات الغربية بل يتم دعمه بشكل قوي منها، وهذا الموقف حيّر الكثير من الناس، كيف يمكن للغرب الاستمرار في فعل ذلك بينما تتراكم الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل جرائم الحرب والإبادة الجماعية؟ لقد أصيب الكثير من الناس بالصدمة والحيرة، متسائلين ما الذي حدث في الغرب؟
لقد أصبح هذا السؤال أكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة في الأسبوعين الأخيرين منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ما الذي حدث في الغرب، وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد، ما الذي خلق هذه العقلية، وهذا المناخ الذي يفرض علينا أن ندعم فيه جميعًا إسرائيل في قمعها الوحشي للفلسطينيين؟
لماذا الذين خالفوا هذا الاتجاه تمت معاقبتهم بشدة من خلال نبذهم اجتماعيًا، بعض هؤلاء فقدوا وظائفهم، وتعرض آخرون لحجب حضورهم على المنصات الرقمية، وأنا بين الذين عانوا من هذا المصير، وهذا لم يحدث إلا مع الذين ناصروا غزة فقط».
صراع اللونين.. الأبيض والأسود
سؤال: «لماذا يرى (الجنوب العالمي) ما حدث في غزة بشكل مختلف عن (الشمال العالمي)، هناك فصل في كتابك بعنوان “عبر خط اللون”، فكيف يلعب العرق دورًا في كل هذا، ولماذا؟»
جواب: «إن من يتحدث عن هذا اليوم سيتعرض لاتهامات بأنه “واكي”1 وخطرٌ على الحضارة الغربية، لكن المؤرخين والروائيين في ذلك الجزء من العالم الذي نشأت فيه يعتقدون أن العالم الحديث بُني على أنماط عنصرية محددة من الإمبريالية والرأسمالية، ففي أماكن مثل الهند، كان أفضل أبناء الوطن، من فنانين وكتاب وشعراء ورسامين ونشطاء سياسيين، يُقاتلون بشراسة وغالبًا ما يُسجنون لتحرير أنفسهم من سطوة سادتهم الأوروبيين، أو في بعض الحالات الأمريكيين، لذا، خارج الولايات المتحدة، هناك وعي عميق بالتسلسل الهرمي العنصري العالمي الذي أخضع بشكل منهجي دولًا كانت ذات يوم مرموقة وقوية وغنية مثل الهند والصين.
بالنسبة لغالبية سكان العالم، فإن وجود (هرمية عرقية عالمية وامتيازات خاصة بالعرق الأبيض) لم يكن يومًا محل شك، فقد كانت النضالات الأولية من أجل الحرية وتقرير المصير تهدف إلى إنهاء هذا النظام العرقي بالتحديد، حتى إن دولة مثل اليابان، التي كانت من المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، توسلّت إلى حلفائها من القوى الغربية مطالبةً ببند في (معاهدة فرساي) ينص على “المساواة العرقية” لكن هذا الاقتراح المتواضع رُفض، والعجيب أن هذا الرفض جاء من (اللورد بلفور)، صاحب الوعد الشهير للصهيونية بالاستيلاء على أرض فلسطين، فقد صرح بأنه لا يستطيع تصور أن يكون الأفريقي مساويًا للأوروبي!!
إذن، فإن “خط اللون” والانقسام العرقي هما واقعٌ قائم منذ زمن بعيد، وفي نواحٍ عديدة هما من شكّلا العالم الحديث الذي نعيشه، ولم تنتهِ الآثار السيئة التي خلفوها لدى الكثيرين ممن لا يزالون يرون أنفسهم يعيشون في (عالم صنعه الرجال البيض.. لأجل الناس البيض)، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على العلاقات الجيوسياسية وعلى الطريقة التي ننظر بها إلى أحداث مثل غزة».
غزة.. نذير شؤم على أمريكا
سؤال: «قلت في الكتاب أن التعاطي الأمريكي مع أحداث غزة، تسبب في خسارة مكانة أمريكا وقوتها الناعمة، كيف سينتهي ذلك بالنسبة لأمريكا؟»
جواب: «يمكننا أن نتفق على الأرجح أن مرحلة التراجع الأمريكي بدأت منذ فترة، بالطبع، هي لا تزال دولة قوية بشكل كبير، لكن الآن لديها الكثير من التحديات والمنافسين أكثر مما كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات، وأعتقد أننا نشهد تحولًا في المشهد العالمي، حيث لم تعد أمريكا في موقع الحماية المطلقة الذي كانت تتمتع به سابقًا.
وما يجعل غزة مزعجة للغاية كنذير شؤم للولايات المتحدة، حتى قبل انتخاب ترامب، هي هذه الحالة التي لا يدعم فيه حتى (السياسيون الديمقراطيون) في أمريكا ما تفعله إسرائيل فحسب، بل ويبذلون جهودًا كبيرة لقمع الانتقادات والقضاء على الأصوات المعارضة لجرائم إسرائيل، وقد أظهر هذا أن (الميل إلى الاتجاهات غير الديمقراطية)، الذي بدأ يشيع في كل القوى الخائفة والمتراجعة تقريبًا، بدأ يتصاعد، وهذا النوع من السيناريوهات التي كانت مرتبطة فقط بـ(البلدان الفاشية) أصبحت الآن سائدة في (الديمقراطيات الغربية المتقدمة)، وهذا ما فضحته غزة.
لهذا تُعد غزة قضية بالغة الأهمية، فهي ليست محصورة في الشرق الأوسط، بل ترمز إلى تحوّل في المزاج العالمي، إنها تعكس بوضوح تام تحوّلًا جذريًا في العقلية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
هذا هو السبب الحقيقي وراء تأليفي لهذا الكتاب، لقد كنت أدرك أننا مقبلون على فترة مضطربة جدًا وأكثر فوضوية حيث سيتخذ السياسيون، وبمساعدة الإعلاميين أحيانًا، إجراءات متطرفة، وسوف يُبنى نظام كبير من التبريرات والقمع، يُعاقب فيه المعارضون بشدة، وتُداس فيه الحقوق الديمقراطية».
ونكتفي بهذه الاقتباسات من الحوار، ونستعرض الآن نص المقال الذي كتبه مؤلف الكتاب حول الكتاب، وإن كان لا يغني عن الاطلاع على الكتاب.
ضحايا المحرقة.. حين يصنعون محارق أبشع!!

“في 19 أبريل 1943، حمل بضع مئات من الشباب اليهود داخل (الغيتو – الحي اليهودي) في مدينة وارسو البولندية ما استطاعوا حمله من أسلحة وردوا على النازيين الذين اضطهدوهم، كان معظم اليهود في هذا الحي قد تم ترحيلهم بالفعل إلى معسكرات الإبادة، وكان المقاتلون، كما يتذكر أحد قادتهم “ماريك إيدلمان”، يسعون لإنقاذ بعض كرامتهم: «كان الأمر يدور في النهاية حول عدم السماح لهم بذبحنا عندما يحين دورنا، كان الخيار الوحيد لدينا.. هو اختيارنا لطريقة الموت».
لكن بعد بضعة أسابيع يائسة، تم التغلب على المقاومين، قُتل معظمهم، وانتحر بعض من ظلوا على قيد الحياة منهم في اليوم الأخير من الانتفاضة في مخبأ القيادة، بينما كان النازيون يضخون الغاز السام فيه؛ ولم يتمكن سوى عدد قليل منهم من الهرب عبر أنابيب الصرف الصحي، ثم قام الجنود الألمان بحرق الحي اليهودي، مبنى تلو الآخر، مستخدمين قاذفات اللهب لإجبار الناجين على الخروج.
تذكّر الشاعر البولندي “تشيسلاف ميلوش” لاحقًا سماع صرخات من الحي اليهودي في قصيدته “في ليلة هادئة جميلة في ضواحي وارسو”: «كان هذا الصراخ يصيبنا بالقشعريرة، لقد كانت صرخات الآلاف من الأشخاص الذين يتم قتلهم، تنتقل عبر الأجواء الصامتة للمدينة من بين وهج الحرائق الأحمر، وكان الهواء عطرًا، ومن الجيد أن يشعر الإنسان أنه ما زال على قيد الحياة، لكن كان هناك شيء قاسٍ في هذا الليل، جريمة إنسانية تدمي القلب، لم نقدر على أن ننظر في أعين بعضنا البعض».
وفي قصيدة أخرى كتبها “ميلوش” في وارسو المحتلة، يستحضر فيها لعبة الدوامة، قرب جدار الحي اليهودي، التي يتحرك راكبوها في السماء عبر دخان الجثث، والتي يطغى لحنها المرح على صرخات العذاب واليأس، عاش “ميلوش” في بيركلي، كاليفورنيا، بينما كان الجيش الأمريكي يقصف ويقتل مئات الآلاف من الفيتناميين، وهي فظاعة قارنها بجرائم “أدولف هتلر” و”جوزيف ستالين”، عرف “ميلوش” مرة أخرى التواطؤ المخزي في الهمجية الشديدة، فقد كتب: «إذا كنا قادرين على التعاطف، وفي الوقت نفسه عاجزين، فإننا نعيش في حالة من السخط اليائس».
لقد ألحقت الإبادة الإسرائيلية لغزة، التي دعمتها الديمقراطيات الغربية، محنة نفسية بملايين الناس لأشهر طويلة، فقد كانوا شهودًا رغمًا عنهم على أفعال (الشر السياسي)، هؤلاء الناس سمحوا لأنفسهم بين حين وآخر أن يتذكروا أنه من الجيد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ثم يعودون ليسمعوا صراخ أم تشاهد ابنتها تحترق حتى الموت في مدرسة أخرى قصفتها إسرائيل.
لقد أثّرت (المحرقة) على عدة أجيال يهودية، فقد عاش اليهود الإسرائيليون في عام 1948 ولادة دولتهم القومية كمسألة حياة أو موت، ثم مرة أخرى في عامي 1967 و1973 وسط الدعوات بالإبادة من أعدائهم العرب، بالنسبة للكثير من اليهود الذين نشأوا وهم يدركون أن السكان اليهود في أوروبا قد أُبيدوا بالكامل تقريبًا دون أي سبب سوى أنهم يهود، وجاءت المذابح واحتجاز الرهائن في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 من قبل حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى لتُحيي الخوف لدى هؤلاء من حدوث محرقة أخرى.
لكن كان من الواضح منذ البداية أن القيادة الإسرائيلية الأكثر تعصبًا في التاريخ لن تتوانى عن استغلال الشعور السائد بالاستباحة والفجيعة والرعب، لقد ادعى قادة إسرائيل حقهم في الدفاع عن النفس ضد حماس، ولكن كما اعترف “عومير بارتوف”، أحد كبار مؤرخي المحرقة، في أغسطس 2024، أنهم سعوا منذ البداية «لجعل قطاع غزة بأكمله غير صالح للسكن، والضغط على سكانه بطرق تجعلهم إما أن ينقرضوا، أو يبحثوا عن أي سبل ممكنة للفرار من القطاع».
وهكذا، وعلى مدى أشهر بعد السابع من أكتوبر، شاهد المليارات من الناس هجومًا غير مسبوق على غزة التي كان ضحاياها، كما قالت المحامية الأيرلندية “بلين ني غرالاي” التي ترافعت نيابةً عن جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي: «كان الفلسطينيون يبثون دمارهم في الوقت الحقيقي، بحثًا عن أمل يائس دون جدوى، في أن يفعل العالم شيئًا». لم يفعل العالم، أو بشكل أكثر تحديدًا الغرب، أي شيء، فخلف جدران (الغيتو – الحي اليهودي) في وارسو، كان “ماريك إيدلمان” خائفًا للغاية أيضًا من «أن لا أحد في العالم سيلاحظ شيئًا، ولن يصل أي شيء، أي رسالة عنا، إلى الخارج»!!
لم يكن هذا هو الحال في غزة، حيث كان الضحايا من الفلسطينيين يتنبؤون بموتهم على وسائل الإعلام الرقمية قبل ساعات من قتلهم، وكان قتلتهم من اليهود يبثون أفعالهم على تطبيق “تيك توك” بكل أريحية ودون أي تأنيب من ضمير.
ومع ذلك، فقد تم التعتيم على الإبادة المباشرة لغزة بشكل يومي من قِبَل أدوات الهيمنة العسكرية والثقافية للغرب: من قادة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة الذين هاجموا (المحكمة الجنائية الدولية) و(محكمة العدل الدولية) إلى رؤساء تحرير صحيفة (نيويورك تايمز) الذين أصدروا تعليمات لموظفيهم، في مذكرة داخلية، بتجنب استخدام مصطلحات (مخيمات اللاجئين) و الأراضي المحتلة) و(التطهير العرقي).
موت .. أيقظ أصحاب الضمائر

في كل يوم، وبينما كنا نظن أننا نمارس حياتنا بصورة طبيعية، كان المئات من الناس العاديين يُقتلون أو يُجبرون على مشاهدة قتل أبنائهم، تضاعفت نداءات الناس في غزة، والنداءات من الكتاب والصحفيين المعروفين، التي يحذرون فيها من أنهم وأحبائهم على وشك الموت، ثم أعقب ذلك ورود الأخبار عن قتلهم.
غشى كثير من الناس ذُل عجز الفعل المناسب، هذا الشعور بالذنب دفعهم إلى تأمل وجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بحثًا عن أي علامة من الرحمة، علامة لأجل وضع حد لسفك الدماء، لكنهم وجدوا وجهًا جامدًا باردًا مخيفًا، لم يكسره سوى ابتسامة مضطربة عندما تبنى الأكاذيب الإسرائيلية بأن الفلسطينيين قطعوا رؤوس أطفال إسرائيليين. وتبددت بوحشية الآمال التي أثارها هذا القرار أو ذاك من قرارات الأمم المتحدة، أو النداءات المحمومة من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، والتضييق من المحلفين في لاهاي، واستبدال “بايدن” في اللحظة الأخيرة كمرشح رئاسي.
وبحلول أواخر عام 2024، كان العديد من الأشخاص الذين يعيشون بعيدًا جدًا عن حقول القتل في غزة يشعرون رغم هذا البعد، بأنهم قد يعيشون في مشهد ملحمي من البؤس والفشل والكرب والإرهاق، قد يبدو هذا الشعور مبالغًا فيه من الناحية العاطفية بين المتفرجين، فالصدمة والغضب اللذان أثارتهما لوحة “غرنيكا” لبيكاسو بخيولها وبشرها الذين يصرخون وقد نزل عليهم العذاب من السماء، كان لا يساوي تأثير صورة واحدة من غزة لأب يحمل جثة طفله وهي مقطوعة الرأس.
سوف تنحسر الحرب في نهاية المطاف وتمضي، وقد يطوي الزمن ركام أهوالها الهائلة، لكن آثار الكارثة ستبقى في غزة لعقود من الزمن: ستبقى في أجساد الجرحى، ستبقى في الأطفال اليتامى، ستبقى في أنقاض مدنها، في المشردين، ستبقى في الحضور والوعي السائدين للفجيعة الجماعية، أما أولئك الذين شاهدوا من بعيد، بلا حول ولا قوة، قتل وتشويه عشرات الآلاف على الشريط الساحلي الضيق، وشهدوا أيضًا تصفيق الأقوياء أو لا مبالاتهم، سيبقون يعيشون بجرح داخلي وصدمة لن تزول لسنوات.
عالم بعد غزة: لن ينسى.. ولن يغفر
لن يتم أبدًا تسوية الخلاف حول كيفية الدلالة على العنف الإسرائيلي، سواء بتسميته (الدفاع المشروع عن النفس)، أو (الحرب العادلة في ظروف حضرية صعبة)، أو (التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية)، ومع ذلك، ليس من الصعب أن نلاحظ في هذا الكم الهائل من المخالفات الأخلاقية والقانونية الإسرائيلية علامات الفظاعة والبشاعة المطلقة: (العزم الصريح والمنتظم للقادة الإسرائيليين على استئصال غزة)، و(إقرارهم الضمني بعدم كفاية العقاب الذي فرضه الجيش الإسرائيلي في غزة)، و(توصيفهم للضحايا بالشر الذي لا يمكن التوافق معه، أو الشر الذي لا يمكن إصلاحه)، و(حقيقة أن معظم الضحايا كانوا أبرياء تمامًا، وكثير منهم من النساء والأطفال)، و(حجم الدمار الذي يفوق نسبيًا حجم الدمار الذي تسبب به قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية)، و(وتيرة القتل، وملء المقابر الجماعية في جميع أنحاء غزة، باستخدام الأساليب الشريرة التي اعتمدت على خوارزميات الذكاء الاصطناعي)، و(التقارير عن القناصة الذين يطلقون النار على رؤوس الأطفال، وغالبًا ما يكون ذلك مرتين)، و(الحرمان من الحصول على الغذاء والدواء، والعِصي المعدنية الساخنة التي يتم إدخالها في أدبار الأسرى العراة)، و(تدمير المدارس والجامعات والمتاحف والكنائس والمساجد وحتى المقابر)، و(أفعال الشر الخبيثة التي جسدها جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يرقصون بالملابس الداخلية للنساء الفلسطينيات المقتولات أو الهاربات)، و(الانتشار الواسع لهذه المقاطع على تطبيق تيك توك في إسرائيل باعتبارها مشاهد ترفيهية)، و(الإعدام المتعمد للصحفيين في غزة الذين يوثقون إبادة شعبهم).
من المؤكد أن القسوة المرافقة لعمليات الإبادة الجماعية المنفَّذة بأسلوب منظم وعلى نطاق واسع كما حدث في غزة، ليست أمرًا غير مسبوق، فعلى مدار العقود الماضية، ظلّت المحرقة النازية المثال الأبرز على الشر الإنساني الممنهج، حيث أصبحت مدى قدرة الناس على التعرف عليها بوصفها جريمة مروعة، والتزامهم بمواجهة معاداة السامية، معيارًا يقيس مدى تحضر المجتمعات الغربية، ولكن الكثير من الضمائر قد انحرفت أو ماتت على مر السنين التي تم فيها طمس اليهودية الأوروبية، فقد شارك الكثير من الأوروبيين من غير اليهود بحماسة، في الهجوم النازي على اليهود، وقوبلت أخبار قتلهم الجماعي بـ(الشك واللامبالاة في الغرب)، وخاصة الولايات المتحدة، وسجلت التقارير عن الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود، كما سجل “جورج أورويل” في وقت متأخر من فبراير 1944، رفض قادة الغرب استقبال اللاجئين اليهود لسنوات عدة بعد الكشف عن الجرائم النازية، وتم تجاهل المعاناة اليهودية، لكن في ذات الوقت، حصلت ألمانيا الغربية، التي لم تغسل يدها بعد من الجرائم النازية، على غفران من القوى الغربية، حين أراد الغرب تجنيدها في الحرب الباردة ضد الشيوعية السوفيتية.
لقد قوّضت هذه الأحداث، التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الحية، الافتراض الأساسي المشترك بين التقاليد الدينية والتنوير العلماني، بأن البشر يتمتعون بطبيعة أخلاقية خيّرة في جوهرهم، غير أن الشك المتزايد في صحة هذا الافتراض أصبح منتشرًا على نطاق واسع، فقد شاهد كثيرون الموت والتشويه عن كثب في ظل أنظمة تتسم بالقسوة والقمع والرقابة، ويدركون بصدمة أن كل شيء بات ممكنًا، وأن استحضار فظائع الماضي لا يضمن عدم تكرارها في الحاضر، وأن الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي والأخلاق ليست ثابتة أو محصنة من الانهيار.
لقد حدث الكثير في العالم في السنوات الأخيرة: كوارث طبيعية، وانهيارات مالية، وزلازل سياسية، ووباء عالمي، وغزو وحروب انتقامية، ومع ذلك، لا توجد كارثة تضاهي كارثة غزة، لا شيء ترك لنا مثل هذا الثقل الشديد الذي لا يطاق من الحزن والحيرة وتأنيب الضمير، لا شيء مثله أعطانا هذا الكم من الأدلة المخزية على افتقارنا إلى العاطفة والسخط، وضيق الأفق، وضعف الفكر، لقد دُفع جيل كامل من الشباب في الغرب إلى مرحلة البلوغ الأخلاقي بسبب أقوال وأفعال وتقاعس الكبار من الساسة والإعلاميين، وأُجبر على أن يستعد بمفرده للتعامل مع الأعمال الوحشية التي تدعمها أقوى ديمقراطيات العالم وأغناها.
أحقاد الغرب.. لماذا؟

لم يكن حقد “بايدن” العنيد وقسوته على الفلسطينيين سوى واحدة من الألغاز البشعة التي قدمها السياسيون والصحفيون الغربيون، فقد كان من السهل على القادة الغربيين أن يحجبوا الدعم غير المشروط لنظام متطرف في إسرائيل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بضرورة ملاحقة المذنبين بارتكاب جرائم حرب في 7 أكتوبر وتقديمهم للعدالة. لماذا إذن ادّعى “بايدن” مرارًا وتكرارًا أنه شاهد مقاطع فيديو فظيعة لا وجود لها؟
لماذا أكد رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر”، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، أن إسرائيل “لها الحق” في حجب الكهرباء والمياه عن الفلسطينيين، ومعاقبة أولئك الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في حزب العمال؟
لماذا هبّ “يورجن هابرماس”، بطل التنوير الغربي البليغ، للدفاع عن التطهير العرقي المعلن؟
ما الذي جعل مجلة “ذي أتلانتيك”، وهي واحدة من أعرق الدوريات في الولايات المتحدة، تنشر مقالًا يقول، بعد قتل ما يقرب من 8000 طفل في غزة، أنه «من الممكن قتل الأطفال بشكل قانوني»؟
ما الذي يفسر اللجوء إلى صيغة المبني للمجهول في وسائل الإعلام الغربية السائدة أثناء تغطية الفظائع الإسرائيلية، ما جعل من الصعب معرفة من يفعل ماذا بمن، وتحت أي ظروف “موت رجل وحيد في غزة مصاب بمتلازمة داون” كان عنوان تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية عن إطلاق الجنود الإسرائيليين كلبًا مهاجمًا على فلسطيني معاق؟
لماذا ساعد المليارديرات الأمريكيون في دعم حملات القمع القاسية ضد المتظاهرين في الجامعات؟ لماذا تمت إقالة الأكاديميين والصحفيين، وإقصاء الفنانين والمفكرين، ومنع الشباب من العمل لمجرد ظهورهم بمظهر من يتحدى الإجماع المؤيد لإسرائيل؟
لماذا قام الغرب، في الوقت الذي يدافع فيه عن الأوكرانيين ويحميهم من هجوم روسي حاقد، باستبعاد الفلسطينيين من مجتمع الالتزام والمسؤولية الإنسانية؟
بغض النظر عن الطريقة التي نطرح بها هذه التساؤلات، فإنها تجبرنا على مواجهة الواقع مباشرة: نحن أمام كارثة شاركت فيها الديمقراطيات الغربية، مما أدى إلى انهيار (الوهم الضروري) الذي نشأ بعد هزيمة الفاشية عام 1945، وهم (وجود إنسانية مشتركة) تقوم على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالحد الأدنى من المعايير القانونية والسياسية”.
هامش
- مصطلح “واكي” أصله من اللغة الإنجليزية الأمريكية ويعني “المستنير” أو “المتيقظ”، ويُستخدم للدلالة على الشخص الذي يُظهر وعيًا عميقًا بالقضايا الاجتماعية والعرقية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بالظلم والتمييز. ومع ذلك، أصبح يُستخدم أحيانًا بطريقة سلبية للإشارة إلى من يُظهرون تأييدًا مفرطًا للمفاهيم الحديثة دون اعتبار للتعقيدات الواقعية، مما يُعتبره البعض تهديدًا للقيم التقليدية أو الحضارة الغربية. ↩︎





كتاب لكاتب ثائر على الوضع العالمي، ورغم انه ملحد فإنه لم يتحمل جرائم اسرائيل والغرب عموما.