
“البطيخة” قصة تختصر مفهوم الوسطية من كتاب “في فلسفة التاريخ” و 5 تساؤلات هامة
غدت الحكمة سافرة عن وجهها في “فلسفة التاريخ”، دون غيرها من فروع الفلسفة؛ هذا ما وجده د. أحمد محمود صبحي أثناء كتابته لكتابه “في فلسفة التاريخ”. وهو أستاذ للفلسفة الإسلامية توفي -رحمه الله- في عام 2004م، بعد أن عمل في أكثر من بلد عربي كأستاذ أكاديمي. وله العديد من المؤلفات والأبحاث التي كانت إضافة متميزة للعلم، ومن بينها كتابه هذا. ولقد حصل كتابه على شهادة يعتز بها من الدكتور زكي نجيب محمود. فقد قال: “هذا كتاب ممتاز من حيث المنهج والأسلوب العلمي الرصين المشوق، كذلك من حيث الموضوع ومادته…”. وكان هذا في تقرير قدمه حين كان ضمن لجنة التحكيم لجائزة جامعة الإسكندرية؛ فكان الكتاب سببًا لأول اتصال بينهما.
ويذكر صبحي أن الدراسات الغربية توسعت في “فلسفة التاريخ”، أكثر من غيرها من فروع الفلسفة؛ كما قيل: “لغز الحاضر لن يحل إلا بوعي تاريخي بالماضي…”. والكتاب لا يتناول إلا الشكل أو الصورة دون المضمون. والمادة التاريخية التي يريدها صبحي هي الحضارة الإسلامية، والتي في حاجة إلى صياغة فلسفية لمعرفة المغزى من الأحداث، مع ما ذكره في كتابه من نظريات لا يقصد بها وضع فلسفة لتاريخنا -كما يقول-؛ ولكن لمعرفة القيم والمبادئ التي يجب أن نعتنقها. وعلى رأسها الوسطية كما جاء في النص القرآني في قوله تعالى: (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا). وحاليًا يفتقد العالم الإسلامي للابن الأوسط؛ مثلما جاء في الأسطورة الهندية “البطيخة” التي توضح مفهوم الوسطية.
قصة “البطيخة”
يحكى أن رجلًا توفي، وترك “بطيخة” لأبنائه الثلاثة. فقال الأكبر: نحتفظ بها ذكرى. فعارض الأصغر في انفعال، وقال: لن تجلب عليهم إلا عفونة، ومن ثَمَّ سيتم التخلص منها. أما الابن الأوسط فقد تمهل وكان آخرهم قولًا، وعرض عليهم أن يشتروا أرضًا خالية، فيأكلوا البطيخة، ويلقوا بقشرها، ويزرعوا بذورها؛ فتخلد ذكرى أبيهم، وينتفعوا بما يعود عليهم بالخير على أنفسهم وأهلهم وجيرانهم، وبما هو باقٍ بعدهم إلى أولادهم وذرياتهم. ويعلق صبحي قائلًا: “هذه هي مشكلة القديم والجديد، الدين والعلم والإسلام والأيديولوجيات الغربية الحديثة”.
أصدر كتابه في عام 1972م، في مرحلة وصفها بالبكر في نطاق الثقافة العربية لميدان “فلسفة التاريخ”. وهنالك الكثير من التساؤلات الفلسفية، والمناهج والنظريات التي جاءت في الكتاب. ولعل أبرزها خمسة تساؤلات.
التساؤل الأول: هل يحتاج التاريخ إلى الفلسفة؟

يرى صبحي أن كل العلوم -ومن بينها علم التاريخ– تحتاج إلى الفلسفة، حتى إنْ استقلت “الفلسفة أم العلوم”. ووصف ذلك بطريقة تبسط الفكرة؛ وهي: استقلال الابنة عن الأم حين زواجها لا يعني عدم احتياجها لأمها؛ فهي تحتاجها ولكن بصورة جديدة تختلف عن احتياجاتها السابقة. وهنالك احتياجات جديدة طرأتْ لعلم التاريخ. وهي:
احتياج منهجي
يذكر أن التقدم الذي أحرزته العلوم الطبيعية بسبب المنهج التجريبي يجعل هناك تساؤلًا حول مدى إمكان تطبيق ذلك على العلوم الإنسانية. ونخص التاريخ؛ فهناك جوانب فيه انعكس عليها المنهج التجريبي. وهي: منهج العلم من خلال جمع الوقائع التاريخية للوصول لأحكام كلية، مثلما يحدث في العلوم الطبيعية. كذلك غاية العلم التي تتحقق من خلال فهم معنى الأحداث، أيضًا استقلال العلم عن الدين بسبب اصطدام التقدم العلمي بالدين، وهذا في أوروبا.. فكان المذهب الوضعي. “الفضل في تقدم العلوم الطبيعية يرجع للفلاسفة المنشغلين بالمنهج، والعلماء المهتمين بالموضوع”.
احتياج يتعلق بطبيعة التاريخ
هنالك قصور في طبيعة التاريخ يكمله الفكر الفلسفي. عمل على هذا اثنانِ: “ابن خلدون” الذي يرى التاريخ ظاهره أخبار وحوليات وتقويم وباطنه نظر وتحقيق. فكان مؤسس فلسفة التاريخ، والثاني الذي يرى كذلك هذا الاحتياج هو “فولتير” الذي أطلق هذه التسمية “فلسفة التاريخ”. وقال بعد اطلاعه على آلاف المعارك: “لم أتعرف إلا على مجرد حوادث لا تستحق عناء المعرفة”!
ويذكر صبحي: “أن الاتجاهات العلمية انعكست على الدراسات التاريخية في النزعة النقدية؛ التي أخذت طابعًا عنيفًا في محاولة لإخضاع الوقائع التاريخية، التي جاءت في الكتاب المقدس للنقد التاريخي؛ وفي النزعة الإنسانية التي تعلي من قدر الإنسان مُستبعِدةً القوة الغيبية لتصبح السيادة للعلم. إلا أن هناك هُوةً بين العلوم الطبيعية والإنسانية؛ فالطبيعية حتمية وثابتة بينما الإنسانية ليست حتمية وديناميكية”. وبهذا كان الخلاف بين العلماء قائمًا بين النزعة الطبيعية التي تتبنى منهج العلم، وترى ثبات الطبيعة الإنسانية، والنزعة التاريخية التي ترى مبدأ الصيرورة والتغير، وعدم صلاحية المنهج التجريبي لعلم التاريخ. ومنها كانت المذاهب التاريخية التي تدور في فلك الفلسفة، كما يرى صبحي.
التساؤل الثاني: لمَن يُؤرخ التاريخ لأفراد أم شعوب؟

كان التاريخ عبارة عن سِيَر لرموز سياسية، تسرد الأعمال والحروب؛ بتصور يقوم على أن التاريخ من صنع أفراد. ولكن بعد ذلك أصبح هناك تأريخ يهتم بالجانب الحضاري من ذكر العلماء وإسهاماتهم في تقدم العقل البشري. ويذكر صبحي أن هذا كان في عصر التنوير -سيادة الفلسفة العقلية التجريبية-، وهذا بعد العصور الوسطى للغرب.
ويؤكد أن التاريخ الإسلامي أول تأريخ للحضارات؛ فهناك عدة عوامل جعلت المؤرخين يؤرخون للحضارة لا للحكام. منها: القرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات كان لها الأثر في تصور المسلمين للتاريخ، وأيضًا الحديث من حيث منهج رجال الحديث، كذلك التقويم الإسلامي الذي تحدد بالهجرة. فكان التاريخ الإسلامي يهتم بتسجيل فكر العلماء بناءً على ما قدمه القرآن من تاريخ الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. ولقد أرخ مؤرخو الإسلام للحكام ولكنهم يرون أن التأريخ للعلماء أكثر فعالية وتأثيرًا.
التساؤل الثالث: هل أخلاق الدولة غير أخلاق الفرد؟
يذكر صبحي أن هناك من فصل بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد. وذلك أنهم وجدوا مبررات لأخلاق الدولة من خلال فلسفتهم للتاريخ، مثل: الفيلسوف الألماني هيجل. في حين أن ماكيافيلي كان متبنيًا الاتجاه اللاأخلاقي للدولة؛ فهو يرى أن أعمالهم لها مبرراتها. وحين ألف كتابه “الأمير” قال عنه: “كتاب يرهق به الإنسانية قرونًا ولن يستنفد أغراضه”. ويصف صبحي هذا الكتاب أنه طلاق تام بين الأخلاق والسياسة لا رجعة فيه. وقد انعكس على هذا اتجاه يتخذ موقف الحياد الأخلاقي؛ بل أكثر من ذلك، فهو يتبنى الموقف اللاأخلاقي ما دامت الغاية تبرر الوسيلة. وبهذا يكون تأريخًا للأفراد يتبع السياسة بل يخضع لها.
ويدعو صبحي المؤرخين إلى التحرر من وهم الميكافيلية، ورفض منطق الفصل بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد؛ فليس على المؤرخ إلزام أن يتبع ذلك لذا عليه ألا يستبعد الأخلاق عن مجال التأريخ.
التساؤل الرابع: هل التاريخ مجرد دراسة لما وقع؟

يذكر صبحي أنه من الخطأ أن نعتقد أن التاريخ مجرد دراسة لما وقع؛ فهو معرفة ذاتية لذهن حي حتى إن كان في الماضي، فالدليل على وجودها قائم. ويقول: “جمع المادة التاريخية تعتبر الخطوة الأولى في دراسة التاريخ، والخطوة الأخيرة الحاسمة هي التعليل”. فالتاريخ الذي يقف عند مجرد السرد؛ هو جسد بلا روح.
تاريخ بلا تعليل مجرد تقويم.
منهج ابن خلدون
يذكر صبحي أن ابن خلدون أخذ في منهجه من الفلسفة نظرتها العقلية التعميمية، ومن التاريخ واقعيته الاستردادية، وأن التعليل عنده أقرب إلى تعليل الأصوليين في الفكر الإسلامي؛ فهو يستخدم مصطلحاتهم وطرق استدلالهم. ولا يعتبر ابن خلدون تابعًا لفلاسفة الإسلام العقليين في التعليل؛ فسياق آرائه مخالف تمامًا لهم. فهو يتخذ التعليل صفة الضرورة؛ مما جعل نظريته تتصف بالحتمية التاريخية. فهو يؤكد دائمًا أن ما حدث هو سنة الله في خلقه.
ومن بين ما كُتب عنه ما ذكره الفيلسوف الأسكتلندي روبرت فلنت: “ابن خلدون يعتبر كباحث نظري في التاريخ؛ ليس له مثيل في أي عصر، حتى ظهر “فيكو” بعده بأكثر من ثلاثمائة سنة. ولقد جمع العرب المادة التاريخية، ولكن ابن خلدون وحده الذي استخدمها، وكمؤرخ هناك من يتفوق عليه”.
ابن خلدون مقارنة بــ فيكو
يرى صبحي أن آراءه فيكو بعيدة عن الرُّوح العلمية، ولديه تعصب ديني في تقييمه للحضارات القديمة. على عكس ابن خلدون؛ فهو إن عرض قصة من القرآن الكريم أضاف إليها تفسيرًا علميًا يتسق مع سياق آرائه.
مثال لتفسيرات ابن خلدون
“عقاب بني إسرائيل بالتِّيْه في صحراء سيناء أربعين عامًا، بعد أن رفضوا دعوة نبي الله موسى -عليه السلام- لهم إلى فتح الأرض المقدسة”. رأى ابن خلدون أن الجيل الذي كان مع موسى -عليه السلام- اعتاد حياة الترف في مدن مصر، كما خضع للذل والقهر من فرعون. ومدة أربعين عامًا هي المدة اللازمة لفناء هذا الجيل، ونشأة جيل جديد في قفار سيناء لا يعرف إلا حياة الخشونة؛ فتقوى فيهم العصبية التي تمكنهم من المطالبة والتغلب.
التساؤل الخامس: هل هناك ربط بين الحضارة والديانة؟

يذكر صبحي أنه الحضارة تعدُّ وحدة الدراسة التاريخية، وليست الأمة. والوحدات التاريخية لمجتمعات العالم خمس حضارات، من أحد وعشرين حضارة اندثرت. وهي:
- الحضارة المسيحية الغربية، والتي تتمثل في أوروبا وأمريكا.
- الحضارة المسيحية الشرقية، والتي تتمثل في روسيا ودول البلقان.
- الحضارة الإسلامية، وديانتها الإسلام بالبعثة النبوية، وتتمثل في الدول الإسلامية.
- الحضارة الهندية في ديانات مثل: البوذية والهينايانا والهندوكية.
- الحضارة في الشرق الأقصى في ديانات مثل: الماهايانا والبوذية.
وأسباب اندثار هذه الحضارات جاءت في دراسة للمؤرخ “توينبي”؛ الذي يُعتبر صاحب أهم نظرية في فلسفة التاريخ. فبعد أن عمل على دراسة حضارات العالم القديمة والحديثة لأكثر من خمسين عامًا، مع حرصه على أن يكون بالقرب من موضوعه من خلال سفره ورحلاته؛ كانت النتيجة دراسة موضوعية عميقة رد فيها الحضارات إلى الأديان. ويرى أن الإمبراطوريات هي بداية انهيار الحضارة؛ فهي لا تقدم حلولًا لمشكلات مجتمعها، بعكس الأديان. فكل حضارة وراءها ديانة؛ فالعقائد الدينية هي التي تُسيِّر مجرى التاريخ. ووصف الحضارة الغربية بالأنانية؛ كونها سيادة تمركزت في مجالين، وهما الاقتصادي والسياسي، لذلك هو ينفي أن تكون من أسمى الحضارات.
ويرى توينبي أنه من الخطأ القول بعالمية الحضارة أو وحدتها. وهو قول جاء لاعتبار الحضارات مقدمات للحضارة الأوروبية. لذلك قدم توينبي نظرية “التحدي والاستجابة” التي يوصف فيها كيف تنشأ الحضارات؛ فعلى مستوى الفرد في التحدي والاستجابة -على سبيل المثال-: “العاهة تستثير صاحبها وتدفعه إلى التفوق في مجال عجزه؛ فالأعمى يصبح شاعرًا يردد الجنود أناشيده… وهكذا”. وبهذا التاريخ البشري سلسلة من التحدي والاستجابة، وانهيار الحضارة يبدأ من الداخل.
ويقول: “الخطر الذي يواجه العالم اليوم أن الجماهير استعاضت عن الفراغ الديني بأيديولوجيات عن الأديان البدائية من حيث وثنيتها؛ حيث عبادة الذات وإن تسترت تحت ستار القومية أو الاشتراكية متمثلة في تأليه الدولة أو الحاكم. الذين يعتبرون الأديان سرطانات مخطئون؛ فإن السرطان الحقيقي هو أن تحل هذه الأيديولوجيات محل الأديان… وأن التاريخ يصبح قصة عابثة يرويها أبله إذا لم يكتشف الإنسان فعل الله الواحد الحق”. وهذا ما نجده في آيات القرآن الكريم من أسباب انهيار الحضارات؛ الكفر بالدين وتكذيب الرسل والأنبياء والفساد.
وأخيرًا يذكر صبحي أن الكتاب يقدم “نهج التاريخ”؛ بحيث تذكر الحقيقة التاريخية دون افتراء، وأن يهدف التاريخ إلى العظة والعبرة أو المغزى من خلال “فلسفة التاريخ”. وكل هذا كان إطارًا أو قالبًا للمقصد وهو تحديد القيم لمواجهة المستقبل.


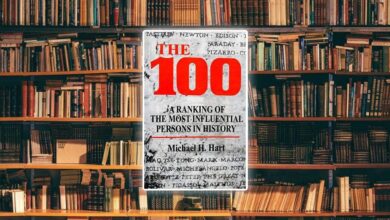
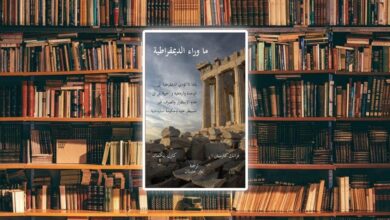

الكاتب لم يصلي و يسلم و لو مرة واحدة على الرسول صلى عليه و سلم