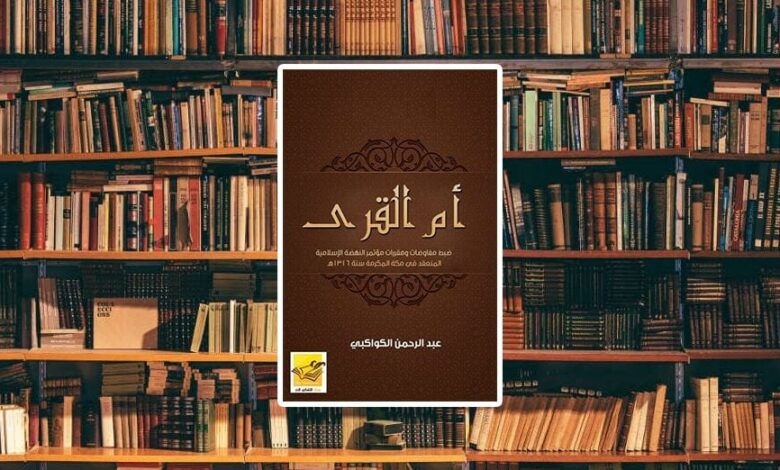
قراءة في كتاب أم القرى لعبد الرحمن الكواكبي.. المشكلة النفسية لأُمتنا
الأمم في حال انحطاطها تكون أشدّ حاجةً لتلك النماذج المُشرقة الدافعة على النجاح والنهوض، خاصّةً إذا كانت هذه النماذج من ثقافتها وديانتها. وقد ظهر منذ منتصف القرن التاسع عشر كثير من المصلحين حاولوا جاهدِيْنَ إدراك ما تعانيه أمَّتنا وما تحتاج إليه للعلاج. كان منهم الإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وجمال الدين الأفغاني، عبد الحميد بن باديس، عبد الرحمن الكواكبيّ.
“عبد الرحمن الكواكبيّ” هو أحد أعلام المفكرين المسلمين. وُلِدَ في سوريا عام 1270هـ – 1854م. وتُوفِّي عام 1320هـ – 1902م. وقد عمل كاتبًا ومُدرّسًا، ومارس الأدب والشعر. ركَّز اهتمامه على النهوض بالعرب والأمّة الإسلاميّة. رأى ووعى المشكلة الإسلاميّة في بلده، واستقرّ في مصر ليدوّن، وينقّح ما كتب. وقد خلَّفَ كتابَيْن؛ أولهما -ترتيبًا- “أمّ القُرى”، والآخر “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”. وقد كان فيهما مجتهدًا كلَّ الاجتهاد في بحثه عن مشاكل أمَّته، وجدّه الصارم في تحليل مشكلاتها، وفي دفعه الأمة للنهوض من كبوتها. إنّ “الكواكبيّ” واحد من أعلام المفكّرين في العصر الحديث، بل هو من أشدهم حميَّةً وحرصًا على التقدم.
لكنَّ عيبًا لا بُدَّ أن نتنبَّه إليه ونحن نطالع ما ألَّفه “الكواكبيّ” هو أنَّ الرجل كان مِمَّن تأثَّروا بالأنظمة الأوربيَّة الغربيَّة في عصره، بل وافتُتن بها. ومن شدَّة إعجابه جعل الأنظمة الأوروبيَّة معيارًا مُحكَّمًا يقيس عليه الواقع العربيّ الإسلاميّ؛ فيكون الوضع أفضل كُلَّما اقترب من نظيره الأوروبيّ الغربيّ.
ومن أخطر مظاهر افتتانه بالواقع الأوروبيّ أنَّه راح يقرن بين أنظمة الغرب والدول المُتقدِّمة (مثل روسيا) بالنظام الإسلاميّ الكُلِّيّ وبعض فرعيَّاته؛ فمثلًا نجده يحاول إيجاد اقتران بين الديمقراطيَّة نظامًا للحُكم العامّ وبين النظام الإسلاميّ في الحُكم، ونراه يقرن “الاشتراكيَّة” مع كثير من ملامح الإسلام. ونراه يُثني على كلّ علوم الغرب منه قوله: “وكظهور سلسلة خلق الحيوان من تُراب وطين وصلصال بقاعدة الترقِّي التي أثبتها العلَّامة دارون” (أمّ القُرى صـ187). وهذا كلُّه خطأ لا يجب متابعته فيه؛ بل التصرُّف الصحيح هو القراءة الراشدة الواعية للاستفادة من خير ما في تراثه، والبُعد عمَّا لا يفيد.
أم القرى

كتاب “أمّ القُرى” (واعتمد صاحب السطور على طبعة الهيئة العامة المصريَّة للكتاب الصادرة عام 2012م) هو كتاب يعرض فيه مُؤلفه لتجربة خياليَّة يتصور فيها اجتماعًا يضمّ مُمثلي الأمَّة الإسلاميَّة في “مكة المكرمة” -ومن كُناها أمّ القُرى وهو اسم الكتاب-، تحت لواء الكواكبيّ نفسه الذي كنَّى نفسه بوصف “السيِّد الفُراتيّ”. وفيه نرى تمثيلًا لاجتماع حقيقيّ -حتى ظنَّ بعض القرَّاء أنَّه كتاب حقيقيّ لا خياليّ- وقد أرَّخ الاجتماع الأول منه لسنة 1316 هـ. وغرض الكتاب هو الوصول إلى حقيقة داء الأمة.
وجدير بالذكر أنَّ هناك أهميَّة للكتاب غير موضوعه وهو أسلوب المُحاورة التي تجري فيه؛ فالكتاب كلّه محاورات. وهذا أسلوب قليل الاعتماد في تراثنا الفكريّ، وقد يُذكِّر القارئ بمحاورات أفلاطون حيث هي الأخرى تعتمد اعتمادًا كُليًّا على هذا الأسلوب.
وقد قسَّم “الكواكبيّ” المشكلات التي رآها في الأمة الإسلاميَّة إلى نمطَيْن من المشكلات: نمط باطنيّ وهي “حالة فتور الأمّة الإسلاميَّة”، تلك الحالة التي تعتمل في نفسيّة المسلمين، وهي في نظره الأشدّ خفاءً. ولعلّ إدراك مثل هذه المشكلة الدقيقة هو ما يميّز “الكواكبيّ” من بين جيل المُصلحين. ونمط ظاهريّ يراه كلُّ من ناظر “الاستبداد السياسيّ”. ومن الممكن أن تقول عن هذين النمطين إنَّهما نظريتان في رؤية الجانب المُعضِل المُشكِل في الأمّة.
هذا ويُركِّز كلّ الباحثين في تجربة “الكواكبيّ” على الجانب الظاهر فقط وهو مناقشته لمسألة الاستبداد السياسيّ، بل تكاد تنحصر شهرة المؤلف فيها وتقترن بها كليَّةً. ويغفل الغالب من الباحثين في تراثه نظريَّته الأبرز والأمتن ولعلَّها الأفضل في رؤية مشكلاتنا وهي “فتور الأمة الإسلاميَّة“.
ولعلّ هذا الجانب عند “الكواكبيّ” أبرز ملامح التفرُّد في فكره، وتمحيصه للأزمة الإسلاميّة من بين كل المفكرين من أبناء جيله وغيره من الأجيال. وذلك لأنه حقل بعيد المنال حتى عن ذوي الفكر الثاقب. فإن غالب أهل الفلسفة يركّزون جهدهم على العوامل الفكريّة، لا النفسيّة. حتى مَنْ قال بهذا الجانب النفسيّ أو ألمح إليه من المفكرين لم يجعله رأسًا، إنما أشار إليه من تضمين كلامه عن الأفكار الخاطئة المسيطرة على المسلمين.
أودُّ الإشارة قبل بحث أهمّ ما قاله “الكواكبيّ” عن الفتور إلى شيء يستحقّ التنويه؛ وهو أنَّه جعل بداية المُشكلة الإسلاميّة قديمة جدًّا على غير ما يسير عليه الاتجاه البحثيّ العام. يقول: “إنّ مسألة تقهقر الإسلام بِنْتُ ألف عام أو أكثر”. وهو على الأرجح يشير إلى تاريخ انتهاء العصر العباسيّ الأول (334هـ) تقريبًا.
وجدير بالذكر أنَّ هذا العصر هو أزهى عصور المُسلمين على الإطلاق في نظر جمهور الباحثين، ويرى كثير منهم أنَّ الضعف قد بدأ بعده منذ العصر العباسيّ الثاني. والحقّ أنَّ هذا الأمر أيضًا به نظر فقد احتفظت الأمة بتماسكها حتى عهد قريب، بل إنَّ العصور بعدها تمتعت بعديد لحظات القوة والتألق. ولا بُدَّ أن نفرِّق بين سريان الضعف في الأمم وبين ظهوره في شكل الانهيار الكُليّ.
المشكلة النفسيّة عند المسلمين

إنّ “الكواكبيّ” يرى أن مشكلة المسلمين في عالمنا المُعاصر حالة نفسيّة، سمّاها “حالة الفُتُور العامّ” التي سيطرت على المسلمين، فلمْ ينجُ منها إلا القليل بل النادر. وهي حالة نفسيّة تعني -بتعبيره- “أنْ تسأم الأمَّة حياتها”. ومن الممكن أن أشرح ما يريد فأقول: إن المسلمين سئِموا مُمارسة حياتهم، فلا يرغبون في تحقيق شيء، ولا التدقيق في أمر، ولا تحرِّي الجيد من الرديء، ولا يطمعون في إحراز أيّ تقدُّم، ولا يطمحون إلى تغيير حال من أحوالهم.
وبالجملة تتساوى عند الأمَّة الحالاتُ كلّها؛ فهم فاقدو الهدف والحافز (إصلاح الدنيا، وإرادة الآخرة)، وبفقدهم للهدف لا تكون حاجة للبحث عن وسائل الوصول إليه (العِلم، الفلسفة، الأدب، الفنّ). وهم مُشوَّشو الأفكار والضمائر مُفتقدون لليقين الأخلاقيّ والوجهة العموميَّة؛ وهذه المُعطيات جميعها يفعل الإنسان بهديها كل ما يصدر عنه. يقول “الكواكبيّ”:
لا غرو أن تسأم الأمة حياتها؛ فيستولي عليها الفتور. وقد كرَّتْ القرون، وتوالت البطون، ونحن على ذلك عاكفون. فتأصَّل فينا فقد الآمال، وترك الأعمال، والبُعد عن الجدّ، والارتياح إلى الكسل.
وبالقطع فإنَّ الحالة التي يصفها الكتاب مازالت تسيطر على الأمَّة حتى يومنا هذا. بل إنَّ القارئ قد يُخدع بمطالعته للكتاب لو خفي عليه زمن تأليفه؛ فسيظنّ أنَّ هذا الكلام ابن سنتنا لا ابن القرن التاسع عشر. الكواكبيّ يصف أمَّة قد أصيبت بالعطب والتوقف، كما أيّ جهاز يصاب ويعطل. وهذا التوقف في مسيرة الأمَّة لمْ يأتِ من خارجها، بل أتى من داخلها أيْ من تكوينها النفسيّ، فصارت الأُمَّة عليلة الذات. وهنا نحن نتحدث عن “نظريَّة” تبلور الأمراض تحت لواء داء عميق أصاب الأمَّة في عُمق تكوينها.
والأمر المُستحقّ للذكر في كونه كيَّف داء المسلمين من ناحية نفسيَّة هي إدراكه لأنَّ الداء في الأمم لا يظهر فجأةً، ففتور المسلمين لمْ يكنْ وليد قرنه التاسع عشر، بل إنَّ الداء قديم بدأ يتسرَّب شيئًا فشيئًا إلى نفس الأمَّة وعقلها الجمعيّ، أوْ نفسها الجمعيَّة -إنْ أردنا الدقة- حتى تمكَّن منها، وصار جزءًا من تشكيل وعيها، وبالتالي جزءًا من تشكيل سلوكها كلّه. فليس سلوك الأشخاص والأمم إلا وليدًا لوعيها بنفسها وبذاتها الكليَّة، وكذلك بموقعها بين الأمم، وبدورها التي تريد أن تحققه فإمَّا تريد أن تتقدم وتنمو، وإمَّا تكتفي فقط بالعيش في صمت انتظارًا للموت. وهذه الحال الأخيرة هي التي رآها الكواكبيّ ونراها حتى لحظتنا هذه.
أسباب حالة الفُتُور العامّ

وهنا نأتي لأمر في غاية الأهميَّة وهو تفكيك هذه الحال النفسيَّة بطرح سؤال: منْ أين أتت تلك الحال النفسيَّة التي استقرَّت في الأمَّة؟! وما هي الأسباب التي ولَّدتها؟ .. معرفة هذه الأسباب تمثِّل الجانب الجُزئيّ من الرؤية الكُليَّة النفسيَّة، أيْ أنَّ هذه الأسباب الآتية هي الوجه الآخر لعُملة “الكواكبيّ”. وقد رصد أسبابًا كثيرة لتلك الحالة النفسيَّة التي تأصَّلت في الأمة، قامت هذه الأسباب مُجتمعةً على توطين حالة الفتور في نفوس المسلمين. وهي أسباب كبيرة أو كليَّة مثل:
- تحوُّل السياسة الإسلاميّة من الديمقراطيّة إلى الملكيّة الوراثيّة، بعد الخلفاء الراشدين؛ يقول: “تحوُّل نوع السياسة الإسلاميَّة حيث كانت نيابيَّة اشتراكيَّة أيْ (ديمقراطيَّة) تمامًا. فصارتْ بعد الراشدين بسبب تمادي المُحاربات الداخليَّة مَلَكيَّة مُقيَّدة بقواعد الشرع الأساسيَّة، ثمَّ صارتْ أشبه بالمُطلقة” (أمُّ القرى صـ171). وهذا الرأي للكواكبيّ قد جانبه الصواب؛ فما كان الحُكم الراشديّ ديمقراطيًّا. وهو أيضًا من مظاهر افتتانه بالأنظمة الغربيَّة.
- فقد الحريّة لدرجة نسيان معانيها مع أنها روح الدين.
- توارث السلاطين وولاتهم للحكم. حتى تولَّى الطفل خلافة المسلمين.
- اقتصار الاهتمام بالعلم على العلوم الشرعيّة، وإهمال العلوم الطبيعيّة.
- يأسُنا من مُجاراة الأمم المُتقدَّمة علينا في مجالات التقدُّم.
- الفقر المُلمُّ بالأمة، وهو رأس الشرور.
- التحريف في أصول الديانة، وكثير من فروعها حتى استولى علينا التشديد والتشويش.
وتعود حالة الفتور إلى أسباب جُزئيَّة عديدة، أوصلها “الكواكبيّ” نفسه إلى ستة وثمانين سببًا. ولكنه صنفها في ثلاثة أصناف:
1. أسباب دينيّة: شملت انتشار عقيدة الجبريَّة في الأمة، وكذلك التصوف، بما استدعاه من تواكل ونبذ للعمل، تهوين غُلاة الصوفيّة من الدين، وإفساده بمزيدات، ومتروكات، وتأويلات، والأوهام التي أدخلها مُدلِّسوهم على العامّة. الجدل في العقائد الدينيّة، والاختلاف في كثير من الفروع؛ مما يؤدي إلى التشويش. تشدُّد الفقهاء المتأخرين. إدخال العلماء المُدلّسين مقتبسات كتابيّة من أديان أخرى على الدين. والاستسلام للتقليد وترك التبصُّر. والتعصُّب للمذاهب والآراء مع هجر النصوص الأصليّة (القرآن، السُّنّة). وتهاون العلماء في تأييد التوحيد. واعتقاد بعضهم أن العلوم الحِكْمِيَّة (الطبيعيّة، والفلسفيّة) والعقليّة تنافي الدين.
2. أسباب سياسيّة: السياسات الدكتاتوريّة (المُطلقة)، وتفرُّق الأمّة إلى أحزاب. حرمان الأمّة من الحريّات في التفكير والتعبير. فقد العدالة في المجتمع. وانتقاء علماء مُدلّسين، وجهلة المتصوّفة ليسودوا الرأي العام، وتكليف القضاة والمُفتيْنَ أمورًا تهدم دينهم. مع إبعاد الأحرار، وذوي الخبرة والرأي السديد. انغماس الأمراء والملوك بالترف، والمفاخرة بالمال والفخفخة لا بالتقدم الحقيقيّ وبالعلم. انحصار السياسة العامة في جباية الأموال من الرعيّة، وتجنيدهم الإجباريّ.
3. أسباب أخلاقيّة: الاستغراق في الجهل، والإخلاد إلى الخمول، واستيلاء اليأس على النفوس. فقد التناصُح، وترك البُغض في “الله” -تعالى-. انحلال نظام الحِسبَة الدينيّة. فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد، وفقد التربية الدينيّة. التهاون في نظام “الزكاة” الإسلاميّ مما أدى إلى افتقادنا للاشتراكيّة، يورد الأخير في السبب الثامن والأربعين؛ حيث يقول: “فقد القوَّة الماليَّة الاشتراكيَّة بسبب التهاون في الزكاة” (أم القُرى صـ252). ومعروف أنَّ هناك فارقًا ضخمًا بين “نظام الزكاة في الإسلام” وفكرة “الاشتراكيَّة” (وهي المرحلة المُمهِّدة لشيوعيَّة، والنموذج التخفيفيّ منها)، بل لا اشتراك أصلًا بينهما إلا اشتباه فكرة عموم الفائدة على المجتمع، وهو من تأثُّر “الكواكبيّ” بالأنظمة الغربيَّة في زمانه.
ترك الأعمال بسبب ضعف الأمل في تحقيق الأهداف. إهمال طلب الحقوق جُبنًا وخوفًا. توهُّم أن الدين في العمائم وفي بطون الكتب. غلبة خُلُق التملُّق للغير، والتزلُّف للصغار والكبار. وتفضيل الجُنديّة للارتزاق بدل الصناعات.
دور عُلماء السلطان في تأخُّر المسلمين

لقد أفسح “الكواكبيّ” لهذا العامل العديد من مواضع كتابَيْه. ذاك أنه يرى للعلماء المنافقين دورًا عظيمًا في استمرار الحالة المتأخرة للمسلمين وزيادتها. فإن العلماء مَناط التقدم، وهم مُوجِّهُوْ الرأي، ومُنوِّرُوْ الفكر. ولكن الملوك والأمراء يختارون منهم فئة منافقة، ممالقة. لا تريد إلا البقاء في السلطة، ولا تريد منهم السلطة إلا إبقاء ملكها. وهم يخاطبون علماء السلطان بألقاب من مثل: أقضى قُضاة المسلمين، أعلم العلماء المتبحِّرين.. وهؤلاء العلماء يصبغون على الملوك ألقابًا مثل: المولى، المقدّس، صاحب العظمة والجلال…
ويكفي أن أسوق لك سطرين من كلامه عن هؤلاء العلماء:
هذا ولا ريب أن التسعين في المائة من هؤلاء العلماء المتبحّرين لا يحسنون قراءة نعوتهم المُزوّرة. كما أن الخمسة والتسعين في المائة من أولئك المُتورّعين رافعي أعلام الشريعة والدين يحاربون الله جهارًا.
ويسوق “الكواكبيّ” مثالًا على ذلك مما يحسن ذكره هنا للتدليل. يقول: “لما فتح السلطان هولاكو (وهو مجوسيّ) بغداد سنة 656 أمر أن يُستفتى علماؤها: أيُّهما أفضل السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟.. فاجتمع العلماء في المستنصريّة لذلك. فلمّا وقفوا على الفُتيا أحجموا عن الجواب. حيث كان “رضيّ الدين عليّ بن طاووس” حاضرًا، وكان مُقدَّمًا محترمًا، فتناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر. فوضع العلماء خطوطهم بعده”. ولا أظنُّ أن هناك حاجة لمزيد. لولا أنْ أنبّه أن “الكواكبيّ” يتناول بنقده علماء مالوا إلى السلطان. وهم فئة من العلماء، لا يقصد بذلك العلماء الحقيقيّين القائمين على دورهم الحقّ.
وبعدُ؛ فهل عرض الكواكبيّ كل هذا العرض ليُثبِّط هممنا، ويُشعرنا بأنَّنا فاشلون وأنَّ عوامل الفشل تحيط بنا من كل جانب فلا داعي إذن لفعل شيء؟! .. بالقطع لا فالمُفكِّر في أيَّة أمَّة لا يُشخِّص الداء إلا ليُقوَّم، ولو أشعرنا هذا التصور لدائنا باليأس فلنشعر باليأس عند خروج أيّ منا من فحص طبِّي. وقد نرى جميعًا أنَّ النهوض صعب لكنْ متى كان صعود الأمم سهلًا؟!


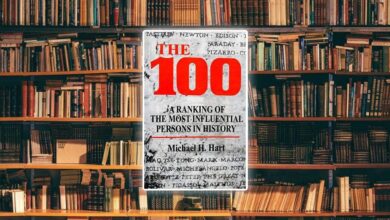
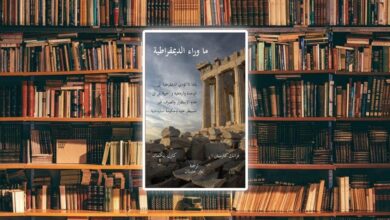

بارك الله فيك
اتمنى انكم تكملوا
احنا فى معركة وعى و محتاجين جهد الجميع