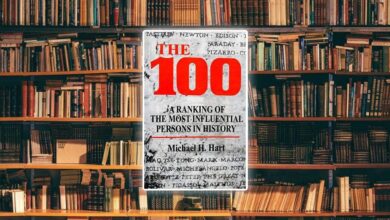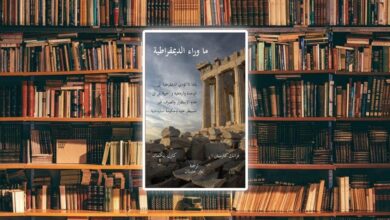كتاب المَخرج الوحيد.. إنسان ما بعد الحداثة وتخبُّط البشريَّة
إذا كان لكلِّ عمل عاقل هدفٌ بُذِلَ من أجله هذا العمل؛ فما الهدف الذي بُذِلَ من أجله هذا السِّفر الكبير المُسمَّى “المَخرَج الوحيد”؟ إنَّه إرشاد إنسان هذا العصر الذي يمتاز بالكثير من الضلال إلى طريق الهداية أو “المَخرَج الوحيد” لأزمته؛ وهو الإسلام الحنيف. وبما أنَّ كتابنا رحلة علاج فيجب علينا أنْ نعرف أعراض وماهيَّة هذا المرض الذي نُواجهه، بل هي الخطوة الرئيسيَّة الأولى في أيّ علاج.
وسنتناول الآن معًا حالة الإنسان في العصر الحديث الذي يُسمَّى “عصر ما بعد الحداثة”، وكذلك سنتناول تلك الأفكار والنظريَّات والأديان التي تسبِّب لهذا الإنسان وللبشريَّة جميعًا حالات التخبُّط وتدخله في متاهات تفرض عليه إيجاد مَخرَج صحيح منها. سنلتزم ما جاء في الكتاب من مادة لكن مع عدم الالتزام بترتيب المواضع، الأهمّ هو صناعة نسق معرفيّ مفيد.
القسم الأوَّل: إنسان ما بعد الحداثة
عالَم اليوم خاصَّةً في الغرب يسيطر عليه اتجاهٌ يُسمَّى “ما بعد الحداثة“. وهي الفلسفة التي جاءت اعتراضًا على سابقتها “الحداثة” التي سيطرت على العقل الغربيّ طوال عصر التنوير وما بعده. ويمتاز اتجاه “ما بعد الحداثة” بسمات تجعل العصر عصر جنون حقًّا.
فلنتخيَّل هذا العصر الذي يرفض أنْ يكون هناك شيء ثابت ومُستقرّ بل يصف الثبات بأنَّه كُفر بالتقدُّم، ولنتخيَّلْ عصرًا لا يعترف بالقيمة المُطلقة في الأشياء حتى بقيمة الإنسان نفسه فليس الإنسان في نظره كما كان من قبل، ولنتخيَّلْ عصرًا ليس به تمييز لأيّ شيء فكلُّ الأمور والفئات متساوية بغضّ النظر عن أيّ معيار قد يرجِّح كفَّة على أخرى؛ فالأقليَّات لها حقّ فرض الذات على الأكثريَّات والشواذ لهم حقّ على غيرهم في أنْ يعترفوا بهم ومدمنو المُخدرات كالأصحَّاء تمامًا.
عالم ما بعد الحداثة لا يتعرف بتفسير نهائيّ لأيّ شيء، لا يوجد تفسير نهائيّ أو “صحيح” أو “مُطلق” بل كلُّ أحدٍ من حقِّه أنْ يصنع لنفسه نموذجًا تفسيريًّا للحياة أو النص المُقدَّس أو أيّ شيء آخر ويعتبره صحيحًا لأنَّه تفسيره بغضّ النظر عن صحَّته في ذاته أو عدم صحته. فليس هناك اعتبار للحقيقة الموضوعيَّة في عالم ما بعد الحداثة. و”الحقيقة الموضوعيَّة” هي حقيقة الشيء في ذاته بغضّ النظر عن تأثير الإنسان أو المُفسِّر أو الرَّائي لهذا الشيء.
عالَم ما بعد الحداثة عالَم غامض غير مُحدَّد بل يكره التحديد والوضوح في الرؤية، ويميل إلى الغيام والهُلاميَّة. وهو عالَم يرى الكون بلا أساس، يراه عارضًا لا حتميَّة فيه. عالَم تتحوَّل فيه القيمة المعرفيَّة الناجمة عن تحديد حقيقة الأشياء إلى القيمة الذوقيَّة حيث تتبع التفسير والتذوق الشخصيّ لكلّ فرد. وهذا له أثر كبير على الفنون التي داخَلَها الكثير من العناصر غير الفنيَّة كالعري والانحلال تأتينا في صورة الفنّ.
إنسان ما بعد الحداثة

ولنتخيَّل معًا على أيّ حال سيكون الإنسان في هذا العصر؟! .. إنسان هذا العصر الذي اختار هذه الخيارات الجُنونيَّة السالفة اعتراضًا منه على عصر “الحداثة” وما أتى به، لا اقتناعًا بما اختار أو نتيجةً لمنطق مُحدَّد أودى به إلى تلك الأفكار.
إنَّ الإنسان في عصر ما بعد الحداثة إنسان مُنهَك تائِهٌ لا يدري صوابه من خطأه بعدما أزال كلّ المعايير وأهدر قيمتها، وأهدر قيمة كلّ شيء ثابت راسخ، وأنكر نفسَه ومُسلَّمات العقل وراح كلُّ واحد يخطُّ لنفسه قِيَمَه وتاريخه وقناعاته وأُسس صوابه الخاصة به، والتي هي بالضرورة صحيحة لأنَّه لا يوجد تفسير نهائيّ لأيّ شيء.
أصبح الشكَّ عنده هو اليقين الثابت الراسخ الذي لا راسخ غيره، وصارتْ حالة الريبة تجاه أيّ فلسفة أو موقف أو دين هي حاله الرئيسة التي لا تزول إلى التحقُّق إلا نادرًا.
إنَّه إنسان مُغيَّب العقل كالمخمور تتداخل أمامه الحدود بين القِيَم حتى تبدو كلُّ قيمة أو سلوك صحيحًا مهما بلغ من قُبح حتى لو فعل رجُلان فعل قوم “لوط” فماذا في الأمر! إنَّه اختيارهما ويجب علينا احترامه! .. إنَّه إنسان المتاهة التي لا خروج منها بتلك الأفكار التي يؤمن بها. إنَّه وباختصار إنسان مُفتقد للمعنى ضائع لا يدري غرضًا من الحياة. وبذلك عاد الإنسان ليسأل سؤال الوجود مرةً أخرى: ما هي الحياة؟ ومن أين أتتْ؟ وإلى أين المصير؟
القسم الآخر: تخبُّط البشريَّة بين المَخارج غير الصحيحة

بعد تشخيص داء الإنسان المُعاصر بدأ الكاتب في توضيح الحلول التي يسلكها الإنسان للخروج من أزمته، أو المخارج التي يحاول الإنسان من خلالها صناعة هدف لنفسه ومعنى لحياته، وتأسيس رؤية عن سؤال الوجود ومحاولة الإجابة عنه. وسأجمع هنا بين مواضع من الكتاب لأحشد المخارج التي بثَّها الكاتب.
علمًا بأنَّه استخدم أسلوبًا منطقيًّا -لمْ يُصرِّح به- يُسمَّى “الحصر والإبطال” يستخدمه الأصوليُّون أيضًا. وفيه يجمع الباحث كلَّ الحلول المُمكنة للمُشكلة ويبدأ في إبطالها واحدةً بعد الأخرى وصولاً إلى الحلّ الصحيح. وكذلك بدأ الكاتب يبطل جميع المخارج ليصل إلى أنَّ هناك مَخرَجًا وحيدًا للإنسان من حيرة الوجود.
المَخرَج الأوَّل: العِلم

منذ نهوض العلم وإيجاد الطفرات العلميَّة في الغرب والإنسان ينظر إلى العِلم بوصفه المَخرَج الوحيد الذي يستطيع أنْ يجيب عن سؤال الوجود ويعطي لحياة الإنسان هدفًا ومعنى. لكنَّ هذا المَخرج لا يصلح أبدًا لما يأمل الإنسان فيه؛ فإنَّ العلم يجيب عن الأسئلة الجُزئيَّة التي مدراها “كيف هو الشيء” لكنَّه لا يستطيع الإجابة عن سؤال “لماذا هذا الشيء” أو سؤال الغاية.
ومع قصور العلم عن أداء هذه المهام إلا أنَّ إنسان العصر الحديث نصَّبَ العلم إله الأرض مُصرًّا استجداءَ إجابات خاطئة منه وفرضها على الجميع. تقول “مارجريت ويتلي”:
التفَتْنَا في طلبنا للإجابات إلى الإله المُعاصِر المَعبود في الثقافة الغربيَّة ألا وهو العِلم… نريد من العلم أنْ يمنعنا من الشيخوخة والموت وأنْ ينقذنا من جميع تحديات الحياة، لكنْ بالطبع فإنَّ إله العلم هذا لا يملك إلا أنْ يخذلنا.
ومثال من السوء الشديد عندما نطلب من العِلم التجريبيّ أنْ يكون هادينا ومُرشِدنا أنَّ الأخلاق السامية الفاضلة مثل الرحمة والعدل والحب لا تمثِّل في نظره إلا حالات بيوكيميائيَّة -مزيج من عِلمَيْ الأحياء والكيمياء-، بل الإنسان نفسه كقضيَّة لا يمثِّل إلا سلسلة من تفاعلات صمَّاء تنتج بعضها بعضًا. فيا له من إله بائس! ويا له من مَخرَج مُخزٍ!
المَخرَج الثاني: مذهب المُتعة وإرادة تحقيق النجاح والثراء

وهذان وِجهتان اتجه الإنسان لهما لتحقيق معنى لحياته. أوَّلهما هو حصر معنى الحياة في مُعاقرة اللذات الدُّنيويَّة، في سلوك يُوصَف إدمانُهُ بمذهب “المُتعة الأنانيَّة” الذي يرى أنَّ إدراك السعادة السريعة العابرة يُحقِّق الهدف النهائيّ للسلوك البشريّ. ولعلَّ سياق الكاتب يجعلنا نشير إلى أنَّ هذا السلوك الشنيع يفسِّر كمَّ التدافع على المواد المُخدِرة بين الشباب في هذا العصر، ويفسر أيضًا ظواهر انتشار المحالّ التجاريَّة الكُبرى في جميع بلاد العالَم والذي نعدُّه في بلادنا -من الغفلة وسوء الرؤية- مظهرًا للتقدُّم!
والآخر هو تكالُب الناس على تحقيق النجاح والثراء -كلٌّ على حسب طاقته وإمكاناته- واعتبار هذا معيارًا لنجاح الإنسان ولتحقيق ذاته. وهذا المعنى نلقِّنه لأبنائنا من حيث لا ندري حينما نحضُّهم على التعليم بدافع أنْ يكون رجُلاً ذا شأن يكسب المال! وكأنَّ العلم هدفه كسب الأموال.. ويورد الكاتب مقالاً علميًّا يؤكِّد على أنَّ الأشخاص الأكثر غنًى ليسوا الأكثر سعادةً.
المَخرَج الثالث: الفلسفة والنظريَّات الكُبرى فيها

لمْ يرَ الكاتب الفلسفة أبدًا مَخرَجًا لإنسان هذا العصر. فالفلسفة في نظره عمومًا لا تقدِّم حلولاً بل تزيد المُشكلات تعقيدًا، وهي مُفضية إلى الحيرة والتذبذب لا اليقين. وقد نفى الكاتب عن الفلسفة أيَّة فائدة إلا كونها مُتعةً عقليَّةً للذهن البشريّ، حتى اعتمادها على فعل التأمُّل رأى أنَّه آتٍ من الدين لا منها.
ولمْ يجد فائدة إلا من بعض فروعها مثل فرع “فلسفة العلوم”. هذا بالنسبة للفلسفة وسأجمع الآن حديثه عن نظريَّتَيْن فلسفيَّتَيْنِ كمثال لإنتاج الفلسفة (دون نظريَّة التطور التي لها مقال خاصّ، وأيضًا دون “ما بعد الحداثة” التي رأينا عرضه لها في القسم الأوَّل).
- الحداثة: وهي الفلسفة أو الإطار الفكريّ العامّ الذي سبق “ما بعد الحداثة”. وركَّز الكاتب في نقضها على أنَّها ليست مشروعًا إنسانيًّا عامًّا نهضتْ به الأمم جميعًا، بل هي سيطرة الحضارة الغربيَّة على الحضارات الأخرى عسكريًّا -مثل الاحتلال الأوربيّ لبلاد الشرق الإسلاميّ العربيّ- وسياسيًّا -مثل معاونة الغرب للمُستبدِّين على الدول الأخرى لضمان السيطرة عليها- واقتصاديًّا، وأتبعتْ هذا كلَّه بالسيطرة الثقافيَّة من خلال فكرة “العَوْلَمَة”.
كما ركَّز أيضًا على بروز القيمة الاستهلاكيَّة عند الإنسان الحداثيّ، ومن ثَمَّ تجفيف الحياة الاجتماعيَّة والرُّوحيَّة، ونظرة الحداثة لأيّ قديم بوصفه عدوًّا للإنسان ولمُستقبله ويُرجع هذه السمة لمُحاربة الكنسية الطويلة وللإيمان بنظريَّة التطور. والغريب في الأمر أنَّ الكاتب لمْ يذكر ركيزة “العقلانيَّة” إلا من خلال كلام لـ”مُراد هوفمان” مع أنَّها ذات أهميَّة عُظمى في نقد المشروع الحداثيّ -خاصةً من وجهة إسلاميَّة-.
ثمَّ رأى الكاتب أنَّ الإسلام لا يعادي مُنجزات الحداثة بل هو أقرب للحداثة إذا قِيستْ بما بعد الحداثة التي تعدُّ نقيضًا للإسلام على طول الخطّ. وكذلك يتفق الإسلام مع الحداثة في التبشير بإمكان الحق والوصول إليه والخلاص وفكرة الأمل. وبالعموم هذا رأي الكاتب في علاقة الإسلام بالحداثة والذي قد لا يؤدي إليه الكثيرُ من المُعطيات الأخرى.
- الدِّيمقراطيَّة: وهي مَخرَج آخر لإدارة الحياة يرى الكاتب أنَّ الإسلام لا يتفق أو يختلف معها كُليَّةً بل هناك نقاط تقارُب ونقاط تباعُد. فهُما يتفقان على هدف رئيس هو منع إساءة استخدام السلطة من خلال سيطرة منهجيَّة على الحكومة وتوازن القوى. ويصنع الإسلام هذا من خلال توظيف الشورى والمحاسبة والعدالة.
والاختلاف بينهما يأتي من انتساب كلٍّ منهما إلى إطار مرجعيّ ضخم، وكذلك أنَّ مصدر التشريع في الإسلام هو “الله” -تعالى-، أمَّا الديمقراطيَّة فمصدره هو الناس أنفسهم، ومن خلال سلطويَّة الأغلبيَّة. وليس الحلُّ للاستبداد هو إعطاء الأفراد الحُرِّيَّة المُطلقة.
المَخرَج الرابع: الدين

هذا هو المَخرَج الأخير لإنسان هذا العصر. ولعلَّ الكاتب قد أدار رؤيته باحترافيَّة مُعتمِدًا على تقسيمات وتداخلات تبيِّن رؤيته. ففي البدء أكَّد على أنَّ الدين تجربة صامدة أيْ أنَّها صمدتْ أمام موجات مُتتالية وجَّهتْ لها سهام النقد وحاربتها أيَّما مُحاربة.
ويكفي أنَّه صمد أمام موجات “نيتشه” الإلحاديَّة، وصمد أمام “العِلمويَّة”، وصمد أمام “الحداثة”، ومازال صامدًا أمام “ما بعد الحداثة”. بل أورد دراسة أُجريتْ عام 2006م تدلُّ على تنامي صوت الدين في النطاق العامّ لا تراجعه كما يوهِمنا الكثير من المُثقَّفين، وأثبتت الدراسة أنَّ أكثر الأديان ارتفاعًا وعُلوًّا هو الإسلام.
ثمَّ أكَّد على أنَّ كلمة “دين” أو عمليَّة الجمع والتوحيد بين كلّ الأديان تحت لواء “حلّ الدين لمُشكلة الإنسان” هو أمر غير صحيح كُليَّةً. بل الأصل أنْ نُفرِّق بين الأديان؛ فكلٌّ منها له رؤيته وبناؤه وحلوله التي قد تجعل منه مَخرجًا حقيقيًّا أم وهمًا وسرابًا. وبعدها نقد بعض الأديان.
ثمَّ أكَّد على رأي الكثير من المُفكِّرين بالتوحيد بين الأديان وبين المذاهب الفلسفيَّة العُظمى مثل الشيوعيَّة والوجوديَّة على سبيل المثال. وهذا رأي صائب كلَّ الصواب يقع فيه الاختلاط -عمدًا أو غفلةً- بين جمهور المُثقفين وعلماء الدين، كان من الصائب نقاشه وإبرازه. ثمَّ بدأ بتقسيم الأديان على معيارَيْن.
تقسيم الكتاب للأديان

قسَّمها تقسيمَيْن الأوَّل -وهو الأقلّ فائدةً- إلى أديان نبويَّة وقصد بها الأديان الثلاثة: الإسلام والنصرانيَّة واليهوديَّة، وأديان غير نبويَّة ومثَّل لها بالزرادشتيَّة والهندوسيَّة. وهذا أمر فيه نقاش طويل لكنْ ليس من ورائه طائل في سياقنا.
أمَّا التقسيم الأهمّ فهو تقسيمه للأديان إلى دين تقليديّ ويضمُّ كلَّ الأديان الضَّالة، والدين الحقّ. وهذا تقسيم مفيد نافع. وأورد طريقتَيْن تصنعان الدين التقليديّ الزائف هُما: عمليَّات التشويه للدين الصحيح، وعمليَّة رفض الدين رفضًا واسعًا من قبل أهله.
أمَّا الدين الحقّ فيمتاز بثلاث خصائص تثبت أنَّه الدين الحقّ الأوحد: أنَّه يدفع الإنسان على التواضُع كونيًّا واجتماعيًّا. ويقصد بذلك أنَّه يكشف للإنسان أنَّه عبد لا إله ويكفُّه عن الاستكبار المعرفيّ الذي يرى فيه الإنسانُ نفسَه قادرًا على معرفة حقائق الأشياء بنفسه دون هداية الإله، وعن الاستكبار الأخلاقيّ الذي فيه يجعل الإنسانُ نفسَه معيارًا للأخلاق ومُحدِّدًا لها.
أمَّا الخصيصة الثانية فهي قابليَّتُه للتطبيق في كلّ زمان وعلى كلّ أحد من الناس، والخصيصة الثالثة قدرة هذا الدين على الحفاظ على أصالته أمام التشويهات والتحريفات التي يُقابَل بها. وبالعموم يمتاز الدين الحقّ بالجمع بين عناصر الإنسان؛ بين المحسوس والمعقول، بين العِلم والدين. هذه كلُّها سمات الدين الحقّ الذي هو المَخرَج الوحيد -الذي سنفرد له مقالاً-. أمَّا الآن فنذكر أمثلة للأديان الخاطئة التي يظنُّ الإنسان أنَّها قد تكون مَخرَجه.
– دين الفلاسفة: تحدَّث الكاتب عن الدين وعن فكرة الإله عند الفلاسفة مُقتصرًا فيها على مُستويَيْن يقولون بهما. الأوَّل هو إله المستوى الشعبيّ وهي حالة تعدُّد الآلهة -التي رأيناها في المجتمع اليونانيّ القديم ونراها في الهندوسيَّة مثلاً-، والآخر هو إله الصفوة والنُّخبة وهو الإله المُنفصل عن العالَم الذي حرَّك الكون دون تدبير ولا مسئوليَّة منه -كإله أرسطو الشهير الذي يُحرِّك ولا يتحرَّك، علمًا بأنَّ إطلاق لفظ إله هُنا فيها شيء بالغ من التجوُّز-.
– النصرانيَّة: وهي أكثر ديانة مثَّل لها الكاتب. وهي عنده من صنف الدين التقليديّ الذي عمِلَ فيه التحريفُ عملَه وانحرف به من جانب الحقّ إلى الضلال. وقد سمَّاه الكاتب “الدين المُعلَمَن” أيْ الذي استطاعت العلمانيَّة اختراقه من الداخل. هذا لأنَّه هو نفسه قابل لهذا حيث يقرِّر أنَّ ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهذا صُلب العلمانيَّة لهذا رآه مثالاً صارخًا لقابليَّة الدين للعلمانيَّة والاختراق.
كما أنَّه دين ضالٌّ لأنَّه قِبَل بألوهيَّة المسيح وهذا فاصل يفصله حتمًا عن الدين الحقّ. وقد ناقش الكاتب مسألة التجسُّد والتثليث نقاشًا خاصًّا. لكنَّ ما يهمنا هنا هو أنَّ مثل هذا الدين لا يصلح مَخرَجًا لحيرة الإنسان.
فكيف يكون لدينٍ صُلبُ عقيدتِهِ تمثِّل ألف إشكاليَّة مُدخِلة في الحيرة والاضطراب أنْ يكون هاديًا للخروج من الحيرة والاضطراب؟!
– اليهوديَّة: وما فيها من تصوُّر غامض مضطرب عن الإله -الذي هو مصدر الدين وترتبط به فكرة الدين وجودًا وعدمًا هُنا-؛ ورُغم أنَّه دين توحيديّ إلا أنَّ به الكثير من التخبُّط في تصوُّر الإله حيث يصارع عباده في كتاب اليهود ويصرعونه -أيْ يغلبونه في المُصارعة-، وهو إله أقرب للتجسيد البشريّ يتعب ويرتاح ويبخل على عباده. ولا يمكن لأيّ دين مُضطرب أنْ يكون سبيلاً للهداية أبدًا.
– الأديان غير التوحيديَّة: والتي سمَّاها باسم خلَّاب هو “الخُرُور من السماء” اقتباسًا من آية كريمة. ومثَّل لها بالهندوسيَّة واليُونانيَّة والرُّومانيَّة القديمة. تلك الأديان التي تربط مفهوم الإله بمفاهيم أرضيَّة مُستقاة من واقع البشر، وتشيع فيها الخرافات والشعائر الوثنيَّة. وهي بيِّنة البطلان لا تحتاج إلى إبطال. حيث تصنع هي الإله لا العكس.
– الإسلام المُشوَّه: وهذا أضعه من قِبَلي لمْ يُدرجه الكاتب رأسًا. ويقصد به هذه الصورة التي صنعها الغربُ للإسلام صناعةً. وفيها يربطُ الغربُ الإسلامَ بالعُنف والإرهاب وفرض الرأي، واضطهاد المرأة وسلطويَّة الرجُل، والرجعيَّة والدُجمائيَّة والتشدُّد والجُمود. وهذه الصورة التي ألصقها الغرب بالإسلام على مدار مئات السنين لا تمثِّل مَخرَجًا بالقطع. وهنا نورد أنَّ الكاتب اعتبر جهود بعض الفِرَق الإسلاميَّة أو المدارس الإسلاميَّة من صنف الإسلام المُشوَّه مثل المُعتزلة والأشاعرة.
هذه كلُّها هي المخارج غير الصحيحة التي تُفضي إلى متاهة فوق متاهة، ولا تنفع الإنسان في مأساته الحاليَّة بشيء. وهنا نتوقَّف لنُتابع بعدها حديثه عن الإسلام الصحيح الذي يمثِّل “المَخرَج الوحيد” لإنسان هذا العصر وكلّ العصور.