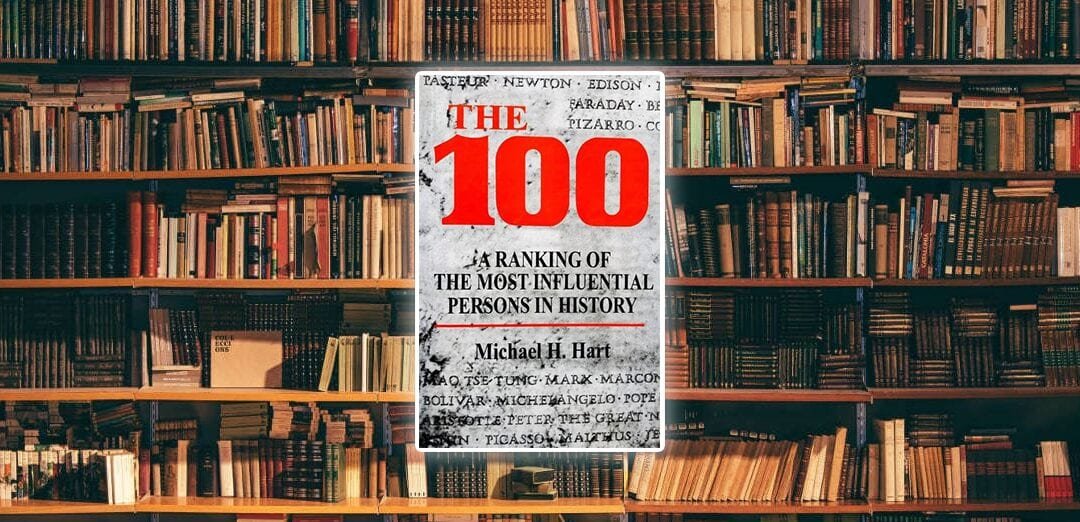قراءة في كتاب رُوح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية لـ طه عبد الرحمن
نسـج فيلسوف العرب طه عبد الرحمن خيـوطًا تتساوق مــع مفهوم الإنسان بيـن التمذهب القديم والمذهب الجديد، الذي عبر عنه بأنه ذلك الموجود الذي ينســى أنه ينسى. وبسبب نسيانـه أضحـت الأمور لديـه تجري علـى عكس ما جرت عليه العادة؛ فالذي كان خيـرًا عند أسلافه أصبح شرًا لديـه، وما كان باطلًا مسلمًا ببطلانه أصبـح حـقًا يأخذ به وينافح عنـه. وهو ما يؤكد آفـة نسيانه لحقيقة وجوده.
وهذا ما ولد للفيلسوف طه عبد الرحمن مفهوم الإنسان الأفقي “المادي=العلماني” الذي قال عنه إنه لا يذكر إلا ما يراه بصـره، ما جعلـه يجحد فضل ونعم خالقـه عليـه؛ الأمر الذي وصل بـه إلى حد القول بتعارض الدين والسياسة، على اعتبار أن الأول فيه خضوع وخنوع والثاني فيه من السيادة والقيادة ما يحرره من أغلال الدين. هذا الأمر الذي يعـد من المسلمات لدى الإنسان العمودي “الذي يرى ما لا يراه بصره وتراه بصيرته، حتى إذا دبّر كان عابدًا وإذا عبد كان مدبرًا”. فهو يرى أنه مسخـر ومستخلف فــي الأرض وكل عمل فيــه إخلاص لله -عز وجل- فهو عبادة بالنسبة له وإن كان في السياسة.
سعــى العلمانيون والحداثيون إلـى تزيف الحقائق علـى الصعيد المنهجي حسب طه عبد الرحمن. وقد ابتدعـوا فــي ذلك مبدأ يقوم على التناقض والتضاد بين الدين والسياسية، اعتبروا أن العلاقة بينهما لا تخرج عن هذين الأصلين. ولأجل ترسيخ هذه الأباطيل في أذهان وعقول الباحثين والمصلحين، سخروا جل إمكاناتهم فـــي سبيل ارتقاء واعتلاء العلمانية رتبة الحقائق المسلمة التي لا تقبل الشك أو النقد؛ على اعتبار أنها مشترك إنساني تجتمع حوله كل الشعوب. هذا السعي لاقى صدى كبيرًا، واستقبلته أذان مصغية من المتمردين والحاقدين علــى الدين ومن دعاة وأهـل الديـن، الذين سلموا بهـذا “القطع اليقيني”، واعتبروا أن العلاقـة القائمـة بيـن الديـن والسياسـة علاقة لا تخرج عن “تقابل تضاد أو تقابل تناقض”.

قاد هذا إلى إعطاء السياسيين حق التدبير والتصرف في أمور الدنيا وشؤون أهلها “بأحكام تصادق عليها الشعوب”، من غير أن تتدخل أحكام الدين فــي الأحكام الوضعية التي استأثر بحق وضعها الحداثيون والسياسيون.
إن الإنسان -حسب طه عبد الرحمن- كائن “محوط بالغيب”، وقبل أن ذاته فيما هو محسوس كانت في عالم “الروح”، وحينما لم تنحصر رؤيته في “البصر”، بل ارتقت إلى عالم البصيرة، كان بصره حياة له في العالم المرئي، وبصيرته حياة تربطه بعالم الغيب، وإدراكه لهذه الحقائق يقوده إلى الإيمان بخاصية التكامل بين ما هو ديني ودنيوي.
وعليه فإن الإنسان الأفقي “العلماني-مادي” -حسب منظور طه عبد الرحمن-، حينما يصعب عليه نقل كمالات العالم الغيبي إلى العالم المرئي، يشتغل فـي سرقة الخصائص الغيبية إلــى عالم الشهادة أو العالم المرئـي، مع تستره فــي نقلها وعدم ذكره من أين أتى بها.
أدت هذه السرقة “العلمانية” إلى إسقاط خصائص العالم الغيبي على “العالم المرئي”؛ فأصبح لفظ “الملك” وهو صفة غيبية لعالم الغيب، تنقلب حسب مفهوم العلمانــي إلى صفة استعباد لأهل الأرض، متوهمًا في ذلك أن استيلاءه على العالم المرئي كبسط الإله سلطانه على العالم الغيبي.
وعليه فإن الإنسان عند طه عبد الرحمن لا يمكن أن يحيا إلا فــي عالم واحد؛ هو العالم الذي بين يديـه، وإن اجتهد وحاول أن يتمرد على هذه الحقيقة وينتقل إلى عالم آخر كان اعتلاؤه اعتلاء مقارنة لا مفارقة.
لا يقتصر الأمر على هذه المفاهيم التي أشار إليها طه عبد الرحمن، ولا تنتهي عند هذا الحد؛ إنما تتفرع عنها مفاهيم مركزية أخرى ترسم وتحدد المعالم الكبرى لهوية الإنسان حسب منظوره. ومن أجل إبراز هذه الفوارق الجوهرية حدد طه عبد الرحمن نمطين؛ يؤصل من خلالهما لمفهومَيْ الوجود والحياة، نمط أطلق عليه الكاتب لفظ “الانوجاد”، الذي يحدد العلاقة القائمة بين الروح “ما وراء الحس” والجسد الذي يحيا في عالم الحياة “العالم الحسي”؛ على اعتبار أن أحدهما يكمل الطرف الآخر ويضفي عليه خاصية يتحدد بها العالم المرئي.
النمط الثاني مفهوم “التواجد” لربما وجد البعض أنه مفهوم يتزاوج مفاهيميًا مع مفهوم “الانوجاد” على اعتبار أصل الكلمة في قواميس اللغة، لكن “التواجد” مركب تجريدي ينفك بالروح عن عالم الأجسام والأبصار إلى عالم البصيرة والعقائد المجردة.
تفيد هذه الأنماط الإنسان في أن يحيا الحياتين في الآن نفسه، عالم الروح وعالم الأجسام؛ وعلى أن يكون موجودًا في العالم المرئي وغير المرئي، إلا أن وصول الروح إلى عوالم الغيب يحتاج جهدًا كبيرًا وزخمًا عاليًا ليرتقي العبد بنفسه وروحه إلى منزلة الصديقية، ويعرج إلى مدارج العلماء السالكين الذين هم ورثة الأنبياء. وهذه المرتبة لا ينالها إلا عبد عارف بالله.
جراء هذا التقسيم، حدد طه عبد الرحمن أنماط الوجود الذي يرى أنه فاعل سياسي وفاعل ديني. الفاعل السياسي الذي يرفض حسب نظره كل ما هو ديني، وبالنظر إلى طبيعة الحياة السياسية التي عاش فيها الكاتب يبرز جليًا للقارئ مدى صحة نظرية طه عبد الرحمن. هذا الفاعل السياسي يدعو إلى فصل الدين عن السياسة؛ على اعتبار أن هذا الأخير جاء في فترة كانت الضرورة تلح على وجود قانون تشريعي إنساني يضبط شؤون الإنسان في العالم المرئي الذي هو مدار الأمر الذي تدور عليه السياسة.
إلا أن الكاتب يرى أن الفاعل السياسي بسبب سرقته للخصائص الغيبية، وحملها على الخصائص التي يتصف بها العالم المرئي أصبح متناقضًا في نفسه يدعي الملك والملك لله، وينزل اسم العزيز على صنم العزى ليكون نفعًا دنيويًا يوازي بين الربح النفسي والربح المادي، وغيرها من تنزيل وسرقة اسم الله وإطلاقه على صنم اللات، واسم المنان وحمله على مناة. سرقة الفاعل السياسي لهذه الخصائص الغيبية وحملها على الخصائص الدنيوية جعله يزاوج بين عالم الأبصار وعالم البصيرة، تحت العديد من الأسماء والمناصب الدنيوية “السيادة/ السيطرة على الحكم الإنساني”، “الملك/ ضبط مسار التاريخ ومآله”.
بالمقابل، نجد أن الفاعل الديني يستقر على عالم الغيب ويعتبره منطلقًا لكل شؤونه وقضاياه الدينية والدنيوية. ويتجلى هذا -حسب طه عبد الرحمن- في كون أن اشتغال الفاعل الديني أكثر شمولية من الفاعل السياسي، لأنه ينفتح على العالم المرئي والغيبي قولًا وفعلًا. وهو كما يقول الكاتب “تنزيل للمثال الغيبي على الواقع المرئي”.
ومن ذلك يجد طه عبد الرحمن في هذه المقاربة التي أجراها على “الفاعل السياسي والديني/ العالم المرئي والعالم الغيبي”، أن الدين والسياسة منهجان أصلهما واحد ويصبان في نبع تدبير الحياة الإنسانية؛ لتوفق بين عالم المادة الذي يعد وسيلة للوصول إلى العالم الغيبي. والذي يربط بين هذين الأصلين “عالم الغيب وعالم الأجسام” الفطرة التي هي أقوى من الذاكرة التي خص بها الخالق -عز وجل- الإنسان./*7

يخلص الكاتب ويؤكد على حقيقتين؛ الأولى أن استحضار الغيب في الحياة العملية يفضي بالإنسان إلى حقيقة وجود ذات عليا لا يماثلها شيء، هي من تستحق العبادة وهي المنفردة بالخلق.
الحقيقة الثانية: أن استحضار العمل بالتشريعات الدينية يوسع من نطاق العلم. وهكذا فإن الاشتغال بالعمل الديني يفتح آفاقًا لا يدركها العقل من الوهلة الأولى.
نستقي من هذه الحقائق أن طه عبد الرحمن يرى أن التسامح الديني الذي طالته الألسنة وتناولته أقلام الباحثين ابتعد عن نبعه؛ حيث يرى -طه- أن المفهوم الذي أصبحت العقول تتبناه هو مفهوم التسامح الأفقي، بمعنى آخر لا وجود للتسامح إلا إذا حضر نوع من الاستعلاء والفوقية من طرف المتسامح. وحسب طه، فإن تجاوز هذا الفهم الخاطئ لا يمكن أن يكون إلا بطريقة واحدة وهي مبدأ المعاملة بالمثل. هذا المبدأ الذي يرى أن على المتدينين استحضاره وتبنيه من أجل تضييق دائرة الخلاف بين جميع الأطراف بغض النظر عن هويته. وهذه هي حقيقة الدين؛ لكن انحراف الفهم وتدليس المفاهيم هو ما ولَّد كل هذه الصراعات. بالنسبة لطه، ما دام الشخص لم يجبرك على اعتقاد دينه، ولم يحارب دينك، وما دام لا يضرك باعتقاده فله أن يعتقد ما يشاء (طبعًا هذا موضوع موسع ولا يمكن أن نحصره في كلام مجمل مثل هذا).
وخلاصةً يمكن أن نقول إن الكاتب يرى أن الإنسان يمكن أن يُحَصل مبدأ التكامل الديني من بوابة المعاملة بالمثل، بدلًا من التسامح الذي يرى أنه يميل إلى صفة الاستعلاء والفوقية.
بالعودة إلى سرقة الفاعل السياسي للخصائص الغيبية، نجد أن الكائن الإنساني يتميز بخاصية الاستقلالية أو حب الذات، أو كما يطلق عليها في علم النفس الأنا؛ التي تجعله يتجرد من كل شيء يربطه بغيره ويسعى بذلك إلى ممارسة السيادة الشخصية على كل ما يحيط به، انطلاقًا من تلك الخصائص الغيبية. وعندما كانت الغاية تحقيق هذه المعاني في العالم المرئي أصبحت غايته تغيب هذه المعاني الغيبية الروحية، وتبني سلطة الحكم المطلق والملك الأوحد الذي يرعى كل الذي يدور في العالم بحيث يكون تحت سلطته. وبهذا فإنه يسعى إلى التسيد؛ ما قد يجعله يدعي الألوهية في نهاية المطاف. ومثال على ذلك فرعون والنمرود بحيث تصرف كل منهما على نحو تصرف المالك في ملكيته، متشبهين في ذلك بالذي فطر السماوات والأرض.
هذا يدفع الخائف “الرعية/الشعب” إلى الفرار من المتسيد والفرار إلى الله وهذا الفرار يجعله يخشى من له المُلك يوم الدين، ويسعى في عبادته وطاعته والخضوع له وفق أسمائه وصفاته التي سرقها المتسيد ونسبها إلى نفسه.
إذا أخذنا كلام الكاتب وأمعنا النظر فيه؛ نخلص إلى أن النظام الديمقراطي حصل له فراغ جعل منه يتبنى سياسة الخوف والتخويف وسيلة للتدبير السياسي على كل المستويات، ويجتاح الخوف الشعب والمسيطر معًا. وهذا بسبب فقدان السيطرة وانعدام الحق والحكم بالعدل، والقول بالخوف هو من كلا الطرفين؛ فلو لم يكن الأول خائفًا لما مارس سياسة التخويف ضد غيره. وحقيقة معرفته بأن سياسة التخويف هي الحل لبقائه في عرش الحكم تجعله يفرط في استخدامها، وكلما أفرط في استخدام القوة والجبروت والملكوت تسيد وساد على من يحيطون به، وانقاد له مسودوه وأطاعوه وخافوا منه ومن ملكه كما أن خوفهم يكون خوف فقده وذهاب هيبته.
وفي محاولة منه -طه عبد الرحمن- لتجاوز هذا الوضع وإيجاد مخرج من غير هذه السيادة الإنسانية المتعجرفة التي تسيطر بالمفاهيم الغيبية، رأى أن العمل بالتزكية الحل الأنسب للحد من هذه العجرفة والتسلط الإنساني.
المقصود بالتزكية -حسب الكاتب- معرفة خصائص النفس لتستعيد وعيها الروحي الذي تختص به، وعند تعرف الروح على المعاني الغيبية التي تزاوج بين الخصائص الغيبية والخصائص المرئية، تستطيع أن تدرك حقيقة التزكية.
بنى طه عبد الرحمن فرضيته على مجموعة من النصوص الشرعية. قال تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) [سورة الشمس:1-10]. قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) الأحزاب 72. قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ) الأعراف 172.

هناك ضوابط لتحقق التزكية؛ الأول المقصود به التزكية الروحية، والثاني حفظ الأمانة، والثالث تمتع الإنسان بحرية الاختيار في حمل الأمانة وفي عمله بها وتصريف نفسه لسعي في تحقق معانيها.
وعلى كل، فإن الحديث عن الكتاب وكل ما جاء فيه وقراءة ما بين دفتيه؛ لا يسع في مثل هذا المقال. وقد أوجزت واختصرت الكلام بما هو لائق بفهمي وفهم الصديق القارئ، ورأيت أن أسوق هنا عبارات لها ارتباط لصيق بالتزكية.
تتحقق تزكية الفكر من خلال التوحيد الذي ينهج رؤية تسدد الوجهة، ليتحرر عقل المتلقي من كل الأغلال التي تعوقه وتكبله. وهذا بالفعل ما أحدثه القرآن الكريم في عقل المسلم لإعادة صياغته وتشكيله من خلال النظرة الاعتقادية التي تذهب بالإنسان إلى حد التخلص من جميع الأغلال والسلاسل والإقبال على الخالق الذي لا تتحقق حرية الإنسان إلا به. فالرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما جاء بدعوته إلى قريش وسائر البشر أراد بذلك تبليغ الدعوة التي تهدف إلى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
يقول الطاهر بن عاشور:
إن إصلاح التفكير من أهم ما قصدته الشريعة الإسلامية في إقامة نظام الاجتماع من طريق صلاح الأفراد. وبهذا نفهم وجه اهتمام القرآن باستدعاء العقول للنظر والتذكر والتعقل والعلم والاعتبار.
إن العقيدة أساس التفكير، وهي التي تسمو بالإنسان نحو ملكوت السماوات. ومن أجل تأسيس عقل صحيح لا بد من تربية صحيحة، والتربية الصحيحة هي التربية التكوينية التي تنتج عقلًا علميًا وشخصًا منهجيًا عكس التربية التلقينية، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من العودة إلى كتاب الله تدبرًا وتعلمًا وتزكية.
ولا تقل تزكية الوجدان أهمية عن تزكية الفكر؛ إذ بها يحصل الإخلاص في العبادة والعمل، ومن خلالها يسمو الإنسان ويشعر بالأمان والطمأنينة في الحياة، وبها ينمي العبد الشعور بالذات، ويثمر بالتالي الإيمان بالنفس الذي هو مفتاح التوازن في الشخصية. وحاجة الإنسان إلى تزكية الوجدان أشد من حاجته إلى الأكل والشرب؛ فالذي يحيي قلبه يسمو عن هذه الملذات الزائلة ذلك، أن تحرير النفس يتم بعد تحرير الوجدان. فالهدف من تزكية الوجدان ليس هو تدوين الفوائد وتقيدها في الكراسات والمذكرات؛ إنما يراد بها تغير نمط العيش والتفكير والتحرر من الأغلال، وتنمية الوازع الديني، وأن يحصل الأثر ويتجلى في الواقع.
لا اعتبار للإيمان الذي لا يثمر فعالية وإيجابية. وهذه هي الغاية من تزكية السلوك؛ إذ إن القصد من وجود الإنسان هو الإنتاج والعمل وفق رؤية نسقية متزنة تقوده إلى بر الأمان. والعبد الذي تشرب من دينه والمفاهيم الشرعية التي أتى بها لا يستطيع الجلوس في مكانه دون تقديم الإضافة للأمة والإنسانية جمعاء؛ فالفطرة التي فطر الله الناس عليها لا يمكن أن تقودهم إلى غير هذه الطريق. ولن تجد حضارة عبر العصور وصلت إلى الرقي الحضاري من دون وجود هذا المقصد الكوني والحرص عليه من قبلها.