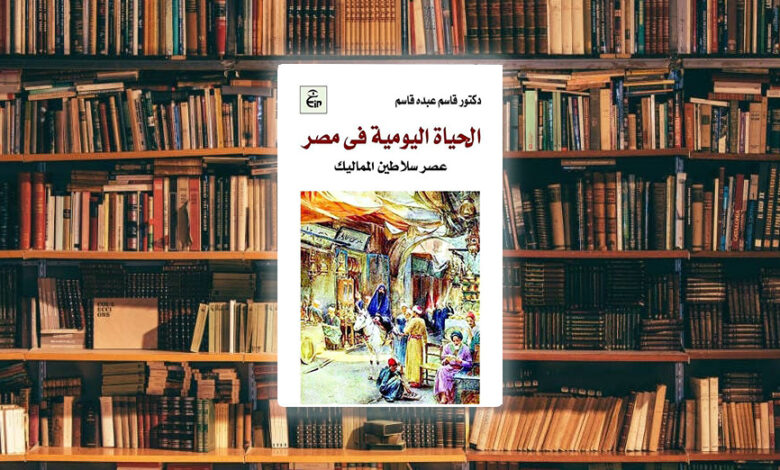
مراجعة كتاب الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك
تحرير: عبد المنعم أديب
كتاب “الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك”، صدر عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الطبعة الأولى 2019م /هـ 1440. أما مؤلفه فهو الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق. صاحب التآليف الكثيرة والترجمات الغزيرة، مؤرخ ومترجم مصري ولد في 1942. متخصص في تاريخ العصور الوسطى، حاز على كثير من الجوائز والأوسمة، منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة 1983، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر 1983، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2008.
من مؤلفاته: في تاريخ الأيوبيين والمماليك، والأيوبيون والمماليك التاريخ السياسي والعسكري، أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، دراسات في التاريخ الإجتماعي عصر سلاطين المماليك. وأما عن الترجمات فمنها: قصة الحضارة (البداية والنهاية /التاريخ الوسيط/نورمان. ف. كانتور. وحضارة أوروبا العصور الوسطى موريس كين، والاستيطان الصليبي في فلسطين /تاريخ الحملة إلى بيت المقدس /فوشيه الشارتري. وغير ذلك من التآليف والترجمات فقد كان رحمه الله من المكثرين في التآليف. توفي رحمه الله في 2021.
موضوع الكتاب

عنوان كتابنا يشي بالبساطة والسهولة، بيد أن هذا العنوان مراوغ مخادع يخفي في ثناياه عشرات العناوين الفرعية، كما أنه يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات. الحياة اليومية في أي مجتمع، وفي أي زمان، تضم الكثير من الصور المتعلقة بالجوانب المختلفة من حياة الناس. الحياة اليومية تشكل تحديات ومغريات في الوقت نفسه، أمام الباحثين بشكل عام. الحياة اليومية تطرح نفسها أمام كل من يعمل في مجال التاريخ الاجتماعي بدُروبه الكثيرة ومادته القليلة في المصادر.
هذه الدراسة تركز على جوانب الحياة اليومية في مصر إبان عصر سلاطين المماليك. وسوف تقتصر على حياة الناس العاديين اليومية، وما كان يحيط بها من الظروف البيئية والطبيعة والسياسية والاقتصادية، سلبية أو إيجابية، ومدى تأثر الناس بها، أو تأثيرهم فيها، دون الدخول في تفاصيل تلك العوامل المختلفة. كانت الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك مثل شريط سينمائي متصاعد، ولم تكن صورة ثابتة، أو لقطة واحدة .. بهذه الكلمات ختم الأستاذ قاسم عبده قاسم كتابه الماتع “الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك”. وفي السطور القادمة نتعرف على الكتاب.
يأتي الكتاب في أربعة فصول استطاع أن يرسم فيها المؤلف الإطار العام للحياة في مصر عصر سلاطين المماليك، بكل ما كانت تحمله من تناقضات ومفارقات وتوافقات وانسجامات. يأتي الفصل الأول والثاني، وكلاهما يكمل بعضهما البعض في وصف الحياة وشكلها في المدن المصرية، وكيف كانت تبدو. رسم الأستاذ بريشته كمؤرخ ناقد ذي فهم ثاقب لظروف هذا العصر الثري المثير صيغة سؤال يدور في ذهن كل قارئ: تُرى كيف كان شكل الحياة اليومية في المدن المصرية في ذلك الوقت؟
كيف كانت الحياة اليومية آنذاك؟
أنت الآن أمام لوحة فنية تُرسم لهذا العصر. تأتي الإجابة في هذين الفصلين. الحياة اليومية في المدن وشكلها، القاهرة وأسواقها، المدن الأخرى والحياة فيها. وهناك يأخذك الكتاب في جولة سياحية عبر أثير الزمن؛ ليصف لك المجتمع كيف كان، وكذلك يضع لك بعض التنبيهات التي لا بد أن تدركها أثناء سيرك في هذه الجولة السياحية. منها أن شكل الحياة -بل المجتمع-؛ يختلف من مدينة إلى أخرى في هذا العصر (اللامركزيّ) بحسب الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وما ينتج عن ذلك. منها أن العادات والتقاليد والأعراف هي من كانت تحكم تصرفات المجتمع من مدينة إلى أخرى، ومنها أن شكل الحياة محكوم بكل ما يمر على هذه المدينة أو تلك من تطورات.
ثم يطوف بك لعقد مقارنة بين الحياة في المدن والريف (عقد فصلًا مستقلًا للكلام عليه). ويضع لك إشارات ضوئية للمرور؛ يرسم لك صورة عن الأكل والشرب، والزواج والطلاق، وتعامل الناس بعضهم البعض، ووسائل المواصلات، والخدمات العامة التي تقوم بها السلطة الحاكمة عن طريق المحتسب وغيره. كذلك نظام الأسواق، والبيع والشراء، وشكل المنازل وكيف كان الأسلوب المعماري يرسم صورة جمالية للمدينة المصرية، يجمع فيها أهم الملامح العامة للمدن من أهم المرافق المؤسسات.
شكل الحياة في الريف

“الحياة في الريف” هو العنوان الذي وضعه المؤلف للفصل الثالث. في بادئ الأمر لا بد صوأن نعرف أن الحضارة المصرية في كل عصورها هي حضارة مرتبطة بنهر النيل؛ إذ عليه قامت الحضارات المصرية المتعاقبة من عصورها القديمة إلى يومنا هذا. فنهر النيل هو الشريان النابض في قلب الأمة المصرية؛ عرف المصريون كيف يروضون نهر النيل، وكيف يزرعون ضفافه، وكيف يقيمون دولتهم عليه، وبسببه علموا كيف يعبرون عن ذلك كله في فنونهم وآدابهم. ولذا كانت الحضارة المصرية حضارة رائدة، تعلمت منها الحضارات الأخرى.
قامت الحياة في البلاد على ثلاثية تتكون أضلاعها من الأرض والنهر من جهة، والفلاح وهو ساكن هذه الأرض، وهو الغالبية من سكان الأرض من جهة أخرى. الحياة في الريف المصري محكومة على الدوام بنتيجة التفاعل الذي يحدث بين ثالوث الأرض والنهر والفلاح. ولقد ظل هذا الثالوث يحكم الحياة المصرية في كل عصورها، الحكم هنا بمعنى أنه يتحكم في مصير الحياة من قيامها وعدم قيامها؛ ولما لا ومصر صاحبة الأرض الغنية والوفيرة بمواردها؟ خصوصًا حوض النيل. فهذا الثالوث صاحب إطعام السكان، ومنه يخرج الطعام والشراب إلى سائر البلاد المصرية.
كانت الزراعة هي الحرفة الرئيسية لأهل الريف وهم الغالبية. عاش الفلاحون في قُراهم الممتدة على نهر النيل. وكما ذكر المقريزي في خططه؛ إن الأمر استقر في مصر على قسمين، هما: الوجه القبلي والوجه البحري. عاش فلاحو مصر في هذه القرى الممتدة، ولم يكن المصريون يعرفون -أو السواد الأعظم منهم- لهم حرفة ومعاشًا في بلادهم -التي يجري فيها النيل- غير الزراعة. ولذا تعلموا هندسة الري وأساليب الزراعة، ودرسوا مواعيد الفيضان، واخترعوا وسائل صيانة لمجرى النهر، وغير ذلك.
لذا كان النيل هو قوام الحياة المصرية، وكان المصريون يراقبون الفيضان سنويًا بمزيج من القلق والشوق؛ نجد لذلك احتفالًا خاصًا بفيضان النيل، خصوصًا إذا أتى مستوفى في عامه. وأيضًا من الملاحظ أن المصريين كانوا عندما يأتي الفيضان يوزعون مياه النهر على الأراضي الزراعية كلها، يتم ذلك على أربعة مراحل. جدير بالذكر أيضًا أنه كان من الضروري إقامة المنشآت الخاصة بضبط النهر والتحكم في مياهه، وعدم ترك ذلك للظروف إذا فاض أغرق، وإذا غاض فأعطش. لذا نجد الجسور ومنها الجسور السلطانية؛ والتي يعم نفعها سائر البلاد. وكان لهذه الجسور صيانة، وميزانية مقررة على كل بلد. وكان السلطان يعين في كل عام أحد الأمراء الكبار مسئولًا عن الصيانة الدورية لهذه المنشآت.
وإن اقتربنا أكثر من المشهد وجدنا أن الزراعة نفسها كانت بسيطة بدائية، ونظام الزراعة نفسه كان محكومًا بالظروف السائدة في ظل النظام الإقطاعي المعروف في ذلك الوقت؛ وهو المناسب للدولة العسكرية، وهو النظام الذي ورثه المماليك من دولة الأيوبيين وأدخلوا عليه بعض التعديلات. وقامت الزراعة على أساس المقاسمة؛ وهو نوع من المشاركة في استغلال الأرض الزراعية بين صاحب الإقطاع والفلاح، إما أن يكون مناصفةً بينهما أو أقل أو أزيد لصالح جانب من الجانبين. وهذا يرجع إلى اختلاف خصوبة الأرض ونوع الجهد المبذول. كان الفلاح يأخذ ما يحتاج من مقويات (أسمدة) أو التقاوي التي يريد زراعتها من الشون السلطانية؛ في نظام متبع يدعى التقاوي السلطانية. وكان يرد ذلك بعد جمع المحصول.
أما إذا أردنا معرفة أنواع المحاصيل الزراعية؛ التي كانت تخرج من الأراضي -وليس على سبيل الحصر-؛ نجد القمح والذي كان يجلب من الصعيد دائمًا، خاصةً في أوقات الشدة والجفاف والجوع، والشعير الذي كان يُزرع في الوجه القبلي بعد زراعة القمح، والفول، والعدس، والحمص، والحِلبة، والثوم، البصل… وغير ذلك كثير. وكذلك الفواكه نجد أن الفلاح المصري في ذلك الوقت كان يزرع أنواعًا من الفواكه كثيرة؛ ولذا انتشرت البساتين في جميع أنحاء البلاد. ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أن الحياة في الريف المصري لم تكن قاصرة على أعمال الفلاحة والزراعة فقط؛ وإنما كان هناك بعض الصناعات التحويلية البسيطة، وكذلك بعض الأشغال اليدوية. لذا نجد أن الحرف والصناعات في الريف تنوعت ما بين غذائية ومنسوجات.
هنا أيضًا أمر لا بد من ذكره؛ ألا وهو الثروة الحيوانية والداجنة. فلقد لعبت دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الريفي بمصر عصر المماليك. نجد من ذلك مفارخ الدجاج والتي تكلم عنها كثير من الرحالة الذين زاروا مصر. وكان لتلك الصناعة ضرائب تدفع لما يسمى مقرر الفراريج، وكانت تقرر وتلغى. ووجدتْ مناحل لاستخراج العسل. وغير ذلك مما يعرف بمجرد مطالعة مصادر هذا العصر.
ولا نغفل أماكن بيع هذه المنتجات والصناعات؛ الأسواق. وأسواق الريف تختلف عن أسواق القاهرة؛ سواء في الشكل والمساحة أو كونها متخصصة في شيء ما. وكان للموالد الشعبية التي كانت تقام في الريف دور هام في إنعاش الاقتصاد الريفي. هذه أهم مظاهر النشاط الاقتصادي لأبناء الريف.
بقى عندنا في هذا الفصل الحياة الاجتماعية للفلاح، وأسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع. تكلمنا عن الريف المصري وأهمية نهر النيل، وعن بعض المحاصيل التي كانت تزرع، وغير ذلك. ووقفنا عند شكل الحياة الاجتماعية في القرية المصرية، وعلاقة السكان بعضهم البعض؛ فكيف كان شكل الحياة الاجتماعية، وكيف كانت تسير هذه الحياة في الريف المصري، وهل كان هناك فرق بينها وبين شكل الحياة في الوجه البحري، وما طبيعة العلاقة بين شرائح المجتمع الريفي المكون للبناء السكاني في الريف، وما العوامل التي أدت إلى انهيار المنظومة الريفية واختلالها؟ .. أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع.
الحياة الاجتماعية في ريف مصر عصر المماليك

أولًا يجب أن نضع في أذهاننا أن أشكال الحياة تختلف باختلاف المكان وطبيعته. وهذا معناه أن الحياة اختلفت بين الريف والحضر، وهذا أمر مشاهد حتى يومنا هذا، وكذلك الطبيعة السكانية فضلًا عن سهولة الحياة وصعوباتها. ولا بد أن نضع في اعتبارنا أن طبقة الفلاحين هم المكون الأساسي، وهم الكتلة السكانية المكونة للريف؛ بغض النظر عما يطرأ عليها من دواخل من أصناف السكان.
ولذا قسمت طبقة الفلاحين إلى قسمين؛ منهم الفلاحون القرارية، وهم من ولدوا في القرية وعاشوا فيها جيلًا بعد جيل. وعلى تفسير المقريزي في خططه قال هم الفلاحون الذين كانوا يعاملون معاملة الأقنان والعبيد قبل عصر المماليك. الصنف الثاني الفلاحون الطوارئ وهم من نزح إلى الريف من أماكن أخرى لأسباب كثيرة، ثم استقروا مع مرور الوقت في الريف المصري. ومنهم العُربان المستفلحون. ولكن هذه الطائفة عاشت -كما يقول المؤلف- على هامش الحياة الريفية؛ أيْ أنهم ظلوا مُتمسكين بأنسابهم البدوية، مع المحافظة على العادات والتقاليد البدوية، وكانوا مُستعلين على الفلاحين، على سبيل المثال كانوا لا يزوجون بناتهم للفلاحين.
أما عن طعام الفلاحين آنذاك؛ فقد كان الفلاح يستمد طعامه من البيئة الريفية التي يعيش فيها مع المحافظة على نوعية الطعام البسيطة وطريقة الإعداد والتي لم تتغير على مر السنين. حاصل الأمر أن طعام الفلاح كان مما تنتجه الأرض. ومن أمثلة نوعية الطعام ما نسميه نحن البصارة، والمفروكة وهو فطير ساخن يوضع في الماء ويغمر باللبن حتى يصير مثل الثريد. ومن كان ذا قدرة من الفلاحين يجد على مائدته أنواع اللحوم والطيور، وأما من كان فقيرًا فلا يجد اللحم إلا في المواسم. أما طريقة إعداد الطعام؛ فقد غلبت عليها البساطة؛ فكان الفلاح يعد طعامه على الكانون والتي كانت توقد من الأغصان الجافة وغير ذلك.
من ناحية أخرى كانت بيوت الفلاحين بسيطة في بنائها ومحتواها، فقيرة في شكلها الخارجي، لا تكاد تحتوي على أي أثاث أو فرش من الداخل. كانت تُبنى من الطوب اللبن، أسقُفُها من البوص، وربما كانت من جذوع الشجر أو أغصانها. وغالبًا تكون طابقًا واحدًا، وربما كانت من طابقين. كان يوم الفلاح يبدأ من الفجر إلى الغروب، ولم يكن في قاموسه ما يجعله يغيب لأي سبب كان إلا ما يكون عند حضور المناسبات الدينية أو الاجتماعية.
هذه أهم الملامح للحياة الاجتماعية في الريف المصري في ذلك العصر المملوكي. وجدير بالذكر أنْ كان للسلطة الحاكمة رجال يقومون على ضبط الأمور في القرية المصرية. منهم الكاشف وهو الذي يمثل السلطان في الناحية كلها، وكان له معاونون ومساعدون له يوزعون على الأقسام في نواحي البلاد. وكان هناك قاضي القرية؛ وهي وظيفة من أهم الوظائف في ذلك الوقت، مهمته الفصل في المنازعات، خصوصًا تلك المنازعات التي تكون بسبب الأراضي الزراعية والري وما شابه ذلك. ويوكل إليه توزيع الصدقات وإثبات عقود البيع والإيجار، فضلًا عن الشئون الدينية مثل إثبات الأهلية وبدء الصيام. وكانت له مهابة واحترام في النفوس.
وأما باقي الأمور الإدارية؛ فقد كانت توكل إلى أرباب السيوف من الأمراء والمماليك. ما يلفت الانتباه أن أخطر ما كان يؤثر على الحياة في الريف بشكل مباشر؛ إهمال مرافق الري، وأعمال صيانة نهر النيل. ظهر هذا خاصة في أواخر عصر الجراكسة؛ فقد كثرت حوادث انقطاع الجسور وانهيارها، بحيث باتت من الأخبار المتكررة. انظر ابن إياس وغيره. أيضًا من أسباب تدهور الريف هو معرفة صاحب الإقطاع أنه لن يستقر في إقطاعه كثيرًا. نبه على هذه الفائدة المؤلف -رحمه الله-.
وعليه، فلم يُهتم كثيرًا بالأرض الزراعية ولا بوسائل الري، وغير ذلك مما له علاقة بالزراعة. وهناك عوامل كثيرة أدت لانهيار الريف المصري؛ مما أدى بدوره لهجرة الفلاحين للريف والأراضي الزراعية. فقد كان الفلاح يهجر أرضه باحثًا عن مكان آخر، وكانت وجهته في الغالب القاهرة مقر السلطنة بحثًا عن فرص عمل أو الانضمام للمتسولين والشحاذين.
نستطيع أن نقول إن التدهور العام الذي أصاب البلاد، مع الفساد الإداري للمسئولين عن الريف، مع الأزمات التي أصابت البلاد، فضلًا المجاعات والأوبئة، وكل ما كان ينتج عنه من معاناة للفلاحين، مع العوامل الطبيعية التي أقضت مضاجع الفلاحين وأرَّقت عليهم حياتهم؛ من فساد الزرع وهجوم الفئران والقوارض وهبوب الرياح الشديدة مثلما حدث في سنة (724 هـ) مع عدم ضبط فيضان النيل قلة وكثرة؛ كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى الخلل الذي أصاب الريف والقرية المصرية.
هذا هو الريف المصري، وهذه صورة بسيطة استطاع المؤلف أن يرسمها بقلمه النابض؛ ليصور لنا الريف المصري وقريته عصر سلاطين المماليك، وما أصابه من آفات مما أدى إلى انهيار وهجرة الفلاح منه. ثم كان بعد ذلك سقوط الدولة بأسرها تحت ضربات العثمانيين. هنا انتهى هذا الفصل من الكتاب، ويليه الفصل الرابع والأخير؛ والذي يعتبر درة تاج الكتاب، وهو بعنوان: السلطة وأثرها على الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك.
السلطة وأثرها على الحياة اليومية في مصر عصر سلاطين المماليك

في هذا الفصل يحاول المؤلف أن يضع بعض الخطوط العريضة المبينة لأثر السلطة على حياة المجتمع؛ من حيث النوع والشكل، سلبيًا وإيجابيًا. في البداية؛ لسلوك الحاكم ورجال السلطة (المماليك) تأثير قوي على حياة المجتمع والناس في مصر في هذا العصر. ومن مظاهر هذا التأثير التي ذكرها المؤرخون:
1- خروج الناس في مواكب حافلة لاستقبال السلطان عند عودته للبلاد؛ أيًا كان سبب هذا السفر. وهناك أمثلة كثيرة دالة على ذلك، يكفى أن تراجع سلوك المقريزي لتجد ذلك. فهذا النوع من الاحتفالات أسهبت المصادر في وصفه؛ فقد كانت التجمعات السياسية والتظاهرات المؤيدة للسلطان من السمات العامة في هذا العصر، أو المظاهرات المناهضة للسلطة أو ضد ممثل السلطة؛ كرفض المجتمع المحتسب. والمصادر التاريخية فيها الكثير من ذلك.
2- دعوة السلطات طوائف المجتمع لأداء صلاة الاستسقاء، عند قصور النيل عن الوفاء وتأخر المطر. تجد المصادر -المقريزي والعيني وغيرهما- تذكر أن السلطان أصدر أوامره للمحتسب وغيره بدعوة الناس لذلك. وقد يخرج الناس لهذا النوع من الدعوة للصلاة عدة مرات. وكانت الدعوة للخروج إلى الصحراء -وهذا هو الغالب-، أو للخروج والتجمع في المساجد الكبيرة الجامعة مثل الجامع الأزهر وغيره.
3- الخروج للاحتفال بوفاء النيل. وهو من الأمور المبهجة. ولا يخفى على أحد أهمية نهر النيل بالنسبة للمجتمع المصري؛ فقد كان يخرج السلطان والأمراء للاحتفال والطبع كان يخرج الناس؛ فإذا تم الإعلان بوصول النيل لحد الوفاء (ستة عشر ذراعًا) تكون هذه الليلة من ليالي القاهرة العظيمة. ونهارها يشهد الموائد (السماط) الحافلة بأنواع الشواء والحلوى والفواكه. هذا النوع من الاحتفالات يبين تأثير المسئولين في الحياة، الذي بدوره يمثل عاملًا من عوامل التواصل بين السلطة والمجتمع، وأيضًا تترك آثارها الإيجابية على الناس في كل أنحاء مصر.
4- الاحتفالات كثيرة غير المذكور. منها الاحتفال بدوران المحمل؛ الذي كان يتم مرتين سنويًا، الأولى في رجب والثانية في شوال. والعادة يكون الدوران في يومي الاثنين والخميس. أيضًا الاحتفال بذكرى وفاة السلطان كانت تمد الأسمطة وتفرق الأطعمة على الفقراء والمشايخ.
5- أيضًا من الأمور ذات التأثير على المجتمع ما كان يخرجه الظاهر بيبرس من صدقات، كل يوم من أيام شهر رمضان. وعندما يتم ختان ابن سلطان؛ حيث يتم ختان عدد من أولاد الأمراء. هذا من التأثير الخاص وليس العام. كل هذه أنواع من تأثير السلطة على المجتمع إيجابيًا.
هناك بعض التأثيرات السلبية أو التي كانت تحمل في طياتها مشقة؛ مثل دعوة الناس للمشاركة في عمل من أعمال المنفعة العامة من شق ترع وتمهيد طرق، وما كان يصاحب ذلك من عسف وجور. كذلك -من أخطر أنواع التأثير على المجتمع وهو ما كان له الأثر السيء على الأسواق-؛ ما كانت تقوم به الدولة من طرح للبضائع على التجار (نظام فيه السلطان يفرض ما قد يكون متوفرًا لدى الدولة من سلع -لسبب أو لآخر- على التجار في الأسواق الداخلية، بالسعر الذي يريده هو وبالكميات التي يقررها هو). ونستطيع أن نستدل من المصادر التاريخية المتاحة ما كان يسببه هذا النظام من آثار سلبية بعيدة وقريبة المدى على حياة الناس سواء اجتماعيًا، اقتصاديًا، بل ونفسيًا. والأمثلة كثيرة ومتاحة في المصادر المعاصرة تبين مدى التأثير السلبي الضار الناتج عن تلك الممارسات من السلطة. وجدير أن يذكر أن هذا الأثر لم يكن يتضح على التجار فقط؛ وإنما كان ينسحب على فئات المجتمع كافة.
ومن جوانب التأثير على المجتمع التدخل في الشئون الشخصية للناس وأذواقهم؛ بحجة المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وقد يتعدى الأمر حدود المعقول (بمقياس هذا العصر)؛ مثل التدخل فيما يلبسه الناس من ملابس خاصة النساء (انظر حوادث سنة 841)، عندما منع السلطان النساء من النزول من منازلهن، وما أصاب الأرامل أرباب الصنائع من الضرر؛ ولم يكن لهن أحد يقوم على شئونهن. وربما تدخلت السلطة في ملابس النساء لانسياقهن -أيْ النساء- وراء صيحة معينة في الملابس قد يكون لها أثر سيء، مثلما حدث في أيام المنصور قلاوون كما ذكره المقريزي في سلوكه. وجدير بالذكر أنه لم تكن هناك سياسة ثابتة يجري تطبيقها في مثل هذه الأمور.
هذه بعض المظاهر التي كانت تؤثر على المجتمع. ولكن ما هو رد فعل المجتمع تجاه هذه التأثيرات السلطوية؟ كانت ردود أفعال الناس أحيانًا تتسم بالعنف تجاه التأثيرات السلبية، خاصة في الشطر الأخير من عُمر الدولة. وهناك أمثلة صارخة البيان والوضوح تدل على ما كان الناس يكنونه من مشاعر الحقد والحنق والغيظ لبعض المسئولين، أحياء كانوا أو بعد موتهم، وخصوصًا صاحب وظيفة المحتسب.
أخيرًا لا بد أن نذكر أن تأثير السلطة على مجريات الحياة اليومية في مصر في عصر المماليك؛ كان متنوعا، وفيه قدر من التناقض. وهو ما يتماشى مع روح هذا العصر الثري المثير الطويل. ومن ناحية أخرى لا بد أن نفرق بين عصرَيْ هذه الدولة الطويلة (البحرية /الجركسية)؛ من حيث التأثير ونوعه ورد فعل المجتمع عليه.





مقال في غاية الروعة وعرض مميز لكتاب استاذنا الدكتور عبده قاسم وخاصة أن الحياة الاجتماعية يعزف عنها كثير من الباحثين، هذا فضلًا عن الاسلوب المميز والسلاسة في اللغة العربية، جزاكم الله خيرًا لمزيد من العروض الطيبة المفيدة لباحث التاريخ الإسلامي
عرض طيب لابأس به على كتاب أستاذنا الراحل د.قاسم الذي شرفنا بالتتلمذ على يديه ،وهو صاحب بصمات ناصعة على طلابه عامة، وعلى الدراسات المملوكية خاصة.وقد نجح عارض الكتاب في نقلنا إلى معايشة العصر بنفس القدر الذي أحدثه فينا صاحب الكتاب الأصلي ، وذلك بلغة سهلة تخلو من الركاكة،وكان موفقاً إلى حد كبير لغوياً ونحويا.مزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله في عروض قادمة لمصادر مهمة في تاريخ مصر.
المقال جيد جدا في عرضه اللغوي … ويمكن ملاحظة أن تكرار المتردافات يضعف المتن … كما في مراوغ ومخادع … استخدام ضمائر المتكلم … نستطيع أن نقول … استخدام أفعال زمن المضارع بدلا من الماضي … جهد مشكور من الباحث يستحق الإشادة والثناء