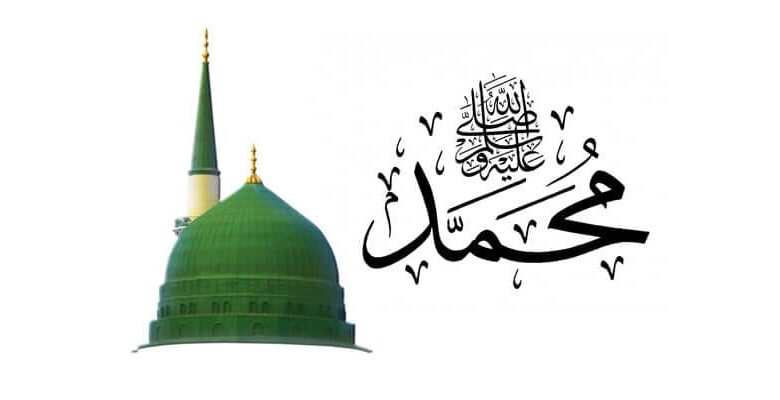
نقض الدعوى الخبيثة.. أن الإيمان بمحمد ﷺ ليس ركنًا
تاريخ الفكر البشريّ لا يخلو من شذوذ لا يعبِّر عن الخطّ العامّ، بل قد يصل هذا الشذوذ إلى درجات من الاتساع الضخم والطغيان على المفاهيم الطبيعيَّة للأمور. وطغيان هذا الشذوذ لا يُثبِّت له أصلاً، ولا يجعله يحلُّ محلَّ القاعدة. بل هناك قاعدة تقول: الاستثناء يثبت القاعدة لا ينفيها. ومن شذوذ هذا الزمان دعوى أنَّ الإيمان بسيِّدنا “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- ليس جُزءًا ولا رُكنًا من أركان الإيمان. مرَّت هذه الدَّعوى بمراحل في ظهورها حتى وصل بنا الحال أنْ تقال عيانًا بيانًا بين المسلمين. وسأبيِّن الآن تاريخ الدَّعوى وتطورها إلى صياغتها العُظمى، ثمَّ أهدافها الحقيقيَّة، ثم الردّ عليها وسأكتفي بدليليْن فقط، ثمَّ دورنا تجاه هذه الدَّعوى.
تطوُّر الدَّعوى: الصياغة الأوليَّة ونشرها
بدأت بأقوال مُفرَدَة من قِبَل بعض المثقفين الجاهلين بمفهوم “الكُفر” -أو المُحرِّفين له قصدًا-، والذين أدَّى بهم الجهل إلى أنْ يعتبروا كلمة كافر سبًّا وشتمًا وليس تقريرًا لأمر حاصل بالفعل. وقد انحصر هذا السلوك منهم في مواجهة الإسلام فقط؛ فكانت الصورة التي يرتضونها هي ألَّا يقولَ المُسلم لأحد غير مسلم -كائنًا مَن كان- إنَّه كافر.
هذه كانت البداية ثمَّ تطوَّرتْ هذه الدَّعوى في ظلّ ظروف سياسيَّة تلاعبت بالموقف بشكل ضخم، وتلاقتْ إرادتها مع إرادة هؤلاء المُثقفين نادِرِيْ العدد. فلمَّا وجدوا من الأنظمة القائمة على البلاد أُنسًا لمواجهة الإسلام وقمعه، اشتدَّ عودُهم وصارتْ هذه الصياغة الأوليَّة جملةً يسمعها الناس على منابر الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئيَّة كثيرًا لغرض ترسيخها في ذهن المُتلقِّي.
ثمَّ لمَّا بدأتْ الصياغة الأوليَّة في الشيوع حدثت حوادث أكَّدت عليها وثبَّتتها. منها إقالة أحد الموظفين بوزارة الأوقاف في أحد البلاد لأنَّه قال على غير المسلمين كافرون، أو منع أحدهم من الظهور، وغيرهما. إلى الحدّ الذي صارت فيه هذه الصياغة مُستَنَدًا يُدفَع به في وجه المتناظرين وكأنَّها تُهمة جاهزة تنتظر أنْ تعاقبك فور أنْ تنتهي من كلامك. ثمَّ تدخَّلتْ السياسة ثانيةً لتُردِّد الصياغة نفسها. وقد كانت السياسة والقائمون عليها إلى سنوات قليلة يُفرِّقون دومًا بين المسلمين وغيرهم، ويعتمدون على الألفة والمحبَّة بين الناس. أمَّا الآن فإرادتهم إزالة الأمر من بابه الأوَّل فلا يكون هناك فارق بين الناس ولا احترام لعقائدهم.
المرحلة الثانية: محاولة إكساب الدعوى الشرعيَّة

ثمَّ حدثت المرحلة التالية التي جرَّأت الكثير لترديد هذه الدَّعوى وهي خروج أستاذَيْنِ من “جامعة الأزهر” -معروفَيْن بالشذوذ في الرأي ومُصادمة الجميع- ليُردِّدا هذا القول. ويبلغ بهما الجرأة على دين الله أنْ يقولا بالاكتفاء بشِقِّ الشَّهادة الأوَّل “لا إله إلا الله”، وبتر الشِّقِّ الثاني “محمد رسول الله” وأنَّ الإيمان لا يقتضي إلا الأوَّل دون الثاني.
ومع كون الأمر مَكشوفًا لعلاقة هذَيْنِ -أو غيرهما- بالسياسة والقيام على آرائها، إلا أنَّ هذه الخطوة قد ساعدت على شيئَيْن: الأوَّل هو إعداد صياغة شبه علميَّة للدَّعوى وبذلك تتشكَّل في صورة قضيَّة معروفة واضحة، وهذا تطور كبير يدخل عليها. والثاني هو محاولة إعطائها الشرعيَّة فخروج أساتذة من الأزهر لقول هذه الدَّعوى غيرُ خروج مثقَّفين معروفين بتوجههم العَلمانيّ أو الشيوعيّ. مِمَّا سيخدع الكثير من الجاهلين الذين يغترُّون بتقديم الشخص بأنَّه “العلَّامة” أو “المُتخصِّص في الفكر الإسلاميّ” أو “أستاذ الفقه المقارن” وغيرها. وكذلك إعطاء كلّ ذي غرض طرفَ خيط يتعلَّق به في هذه الدَّعوى المائتة المَوؤدة.
التحوُّل إلى الصيغة العُظمى
ظللنا على هذه الحال إلى أنْ تحوَّل الأمر تحوُّلاً كبيرًا، فاستغلَّه بعضُ ذَوِيْ الغرض الخاصّ في نفوسهم وطوَّروا القضيَّة إلى الصيغة التي بدأت تظهر. ومن المُمكن صياغتها في الصورة التالية:
الإيمان بمُحمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- ليس رُكنًا للإيمان، ولا يعوَّل عليه في القول بالتكفير، ولا يُحاسَب عليه غير المُؤمن به أمام الله يوم القيامة.
وبهذه الصياغة التي بدأتْ تُقال من -نُدرة نادرة بالقطع- وصلنا إلى الصياغة العُظمى لتلك الدَّعوى.
فهل معنى هذا أنَّها نهاية المطاف ولنْ نتطوَّر؟ بالقطع لا فهذه الصياغة التي سمَّيتها الصياغة العظمى تحمل في طيَّاتها الكثير من النتائج الكارثيَّة التي لا يُواجهُك بها القائلُ الآن، بل المطلوب فقط منه أنْ يرتكز على هذه القضيَّة لترسيخها أوَّلاً حتى إذا ترسَّختْ، وتداولها الناس على أنَّها دعوى معترف بها بدأ الأمر ينكشف على حقيقته ونتائج تحليل هذه الصياغة تتضح.
أهداف الدَّعوى

- عدم إدخال اليهود والنصارى تحت مظلَّة الكُفر. ولعلَّها كانت نقطة البدء كما رأينا؛ وهذه من نتائج الدَّعوى الواضحة -في نظر القائلين بها أقصد، وسأهدمه قريبًا- فلو لمْ يكُنْ الإيمان بـ”محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- ركنًا فما من سبب في أنْ ندخل اليهود والنصارى في تصنيف الكُفر.
- تثبيت دعوى “وحدة الأديان”. وتعني أنَّه لا فارق بين دين ودين وأنَّها طُرُق متعدِّدة لشيء واحد. فلا إشكال من سلوك أحدهم طريقًا وسلوك الآخر طريقًا آخر إذا كانت النهاية واحدة. ولعلَّنا نلاحظ إشاعة المثقفين لهذه الدعوى من جوانب كثيرة قد تخفى الآن لكنَّها ستظهر حين تتبلور فيما بعد وترتبط بغيرها ليُصرَّح بها.
- تمييع الإسلام أكثر فأكثر لسبب واضح حيث عدم اعتبار سيدنا “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- هادم أو -على أقلّ تقدير- يجعل السنَّة النبويَّة في محل الإهمال لا الإعمال. ولِمَ لا وصاحبها نفسُه صار في محل الإهمال لا الإعمال.
- نقض الإسلام بالكليَّة. فهذه الدعوى -كما سيأتي- تهدم الإسلام بالكليَّة لا تترك منه شيئًا باقيًا يقف على ساق. فإنَّ هدم مقام النبوِّة هدم للسُّنَّة -كما سبق- وهدم للقرآن نفسه حيث الرسول هو المُبلِّغ به حصرًا. وإزالة رُكن الإيمان بـ”محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- يهدم القرآن الذي أتى به.
- التحوُّل بالمسلمين إلى حال دينيَّة تُسمَّى “الرُّبوبيَّة” -والبعض يُسميها دينًا تحت اسم “الدِّين الطبيعيّ”. وهي الاعتقاد بوجود إله وحسب، بغضِّ النظر عن ماهيَّة هذا الإله أو تحديده. بل التمحور حول أنَّ هناك إلهًا لا نعلم ولا يهمنَّا العلم مَن هو وما يريده مِنَّا، وتشريعه وطريقته لأنَّنا لن نطيِّقها من الأصل.
الدليل الأوَّل: حقيقة الإسلام تهدم دعوى المُحال

هذه الدعوى هي دعوى المُحال -أيْ المستحيل-. وهي كلُّ دعوى لا تصحُّ لمناقضتها لثوابت الأمور. فمثلاً أقول لك: إنَّ الماركسيَّة لمْ يأتِ بها ماركس، وأنَّها لا تعتمد على أفكاره، وكأنْ أقول لك ليس التنفُّس شرطًا للحياة والواضح الثابت الذي لا يقبل شكًّا نقيضُ الدَّعويّيْن فهما مهدومتان من دون جهد، وهو قول عبث ليس إلا.
وهنا لا بُدَّ من اعتبار أنَّني أوجِّه الخطاب لمَن يُقدِّم الدعوى من المُسلمين فقط معتقدًا صحَّتها، أيْ أنَّه تأثَّر بكلام الإفك الذي قِيل. أمَّا القائل بها عارفًا فهو مغرض أصلاً يعرف أنَّه يقول المُحال على سبيل المُماطلة والاعتماد على تفشِّي قلَّة الفكر بين الجمهور.
ودعوانا هنا هي دعوى المُحال لاستحالة الجمع بينها وبين الإسلام أبدًا. حيث تُناقض حقيقة الإسلام وجوهره دون مُواربة، فمقتضى هذه الدعوى عدم وجود إسلام أصلاً، والإسلام موجود ثابت؛ إذنْ فهي منقوضة مهدومة به. ولن نعرف أنَّ هذه الدعوى تقتضي عدم وجود الإسلام إلا عندما نطلع على تعريف الإسلام وحقيقته الجليَّة التي يتفق عليها المسلم وغيره، العالِم وغيره.
فإنْ قلتَ لأحد عاميّ غاية العاميَّة ما هو الإسلام؟ سيقول لك: هي الديانة التي أتى بها “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- من عند ربِّه. وإنْ سألتَ علماء الغرب غير المسلمين أو المُلحدين: ما هو الإسلام؟ سيقولون التعريف نفسه. وسأنقل لك إحدى الإجابات -وكلُّها مثلها لا خلاف- وهي تعريف “المُعجم العلميّ للمعتقدات الدينيَّة” -الذي صُنع في “الاتحاد السوفيتيّ” المُلحد- يقول:
“الإسلام أحد الأديان الثلاثة العالميَّة … وتعاليم الإسلام يتضمنها القرآن الذي أنزله الله -حسب الرواية الإسلاميَّة- من خلال الملاك جبريل إلى النبيّ محمد. ويرتكز على سبعة بنود هي: الإيمان بإله واحد-الله، وبملائكته وبكافَّة الكُتُب المقدسة وبكافَّة رُسُل الله وباليوم الآخِر، وبقضاء الله قدره وبعث الموتى … وترتكز العبادة الإسلاميَّة على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله….”.
وإذا ذهبنا إلى القرآن نفسه الذي هو المصدر الأساسيّ والرئيس للإسلام سنجد آيات الإيمان التي تُعرِّف البشر جميعًا مُفردات الإيمان وأركانه موجودة ثابتة. يقول الله تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) -البقرة 285-. ولعلَّنا هنا نلاحظ أنَّ الإيمان بالرُّسُل “جميعًا” هو صُلب الإيمان وجزء لا ينفكُّ منه إطلاقًا. وآخرهم وخاتمهم “محمد”. والذي يدخل الإيمان به ركنًا من الإيمان. ولعلَّنا لاحظنا ضبط كلمة “كُلُّ” في الآية وهذا الضبط يعني كلّ واحد أيْ إطلاقًا فليس هناك مؤمن إلا وهذا ميثاق إيمانه.
وسنجد آيات عديدة تعرض العقيدة على الناس -وهي تقوم مقام تعريف الإسلام هنا سواءً بسواء- ونجدها تطالب غير المُسلم بالإيمان بالرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، بل تقرن الإيمان بالله بالإيمان بالرسول في وحدة لا تنفصل. ولعلَّ هذا يفسِّر لك عدم وجود تعريف مختلف للإسلام في أيّ مرجع في العالَم. وسأنقل هنا بعض الآيات للتدليل لا الحصر.
هذه آيات عامَّة تحمل دعوة الله وعرضه الإيمان للناس جميعًا (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) -الأعراف 158-، (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا) -التغابن 8- والنور هو القرآن.
وهنا يوجِّه النداء إلى المؤمنين من أهل الكتاب يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) -الحديد 28-، وكذلك في الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) -النساء 136-، (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ) -النساء 171- والإيمان بالرُّسُل هنا المقصود به تصحيح ما يعتقدونه من إفك على الرُّسُل الأقدمين ممَّا هو موجود في كتابهم، والإيمان بالرسول الذي ينكرونه وهو “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم-.
ولو ذهبنا مُستدلِّين لطال بنا المقام إلى غير نهاية. ونرى من كلٍّ أنَّ الإيمان بالرسول رُكن ركين من الإيمان لا ينفصم عن الإيمان بالله. وإذا سألنا الأحاديث -وهو المصدر الثاني للإسلام- عمَّا هو الإسلام؟ سنجدها تعرِّفه التعريف نفسه ولا خلاف إطلاقًا. وهنا يتبيَّن لنا أنَّ حقيقة الإسلام هو الإيمان بالله وبجميع رُسُله؛ مِمَّا يبطل هذا القول تمام الإبطال ولا يجعل له قائمة تُقام.
وقبل أنْ ننتهي من هذه النقطة يجب تنويه العقول إلى أنَّ الإيمان بالرسول “محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- أو بالرُّسُل لا يعني الإيمان بهم على جهة الخالقيَّة أو العُبُوديَّة -كما الحال في الإيمان بالله-، بل يعني التصديق بهم وبأنَّهم رُسُل الله وأنَّهم صادقون، وأنَّ ما أتوا من عنده هو الله الحقّ. وهذا يترتب عليه التصديق بما يأتون به من أفكار وحتميَّة التزامه والعمل به.
وهذه الدعوى تكذيب صريح للإسلام نفسه وهدم له أوَّله وآخره. بل هي تسفيه للقرآن الكريم وللإسلام فلو كانت هذه الدعوى صحيحةً لما كان للإسلام من فائدة؛ فلِمَ يأتِ ليُصحِّح أمرًا هو في الأصل صحيح، ولو كانت الدعوى صحيحةً لكان الرسول مُخطئًا والقرآن مُخطئًا في توضيح أمر كُفر الناس، ودعوتهم إلى الإسلام وإلى الإيمان بـ”محمد” -صلَّى الله عليه وسلَّم- ولتركهم على حالهم -التي هي صالحة أيضًا كما تقول الدَّعوى- كما رأينا في آيات من ضمن عشرات غيرها لمْ نأتِ بها اختصارًا فقط.
وهنا أيضًا يتضح لنا أنَّ دفع هذه الدَّعوى بالقول إنَّها دعوى من غير دليل، أو أنَّها مجرَّد دعوى -كما فعل كثير من الأفاضل المُحترمين الذين حاولوا الردّ- ليس صحيحًا. ولا يُردُّ على مثل هذه الدعوى بهذا الردّ، بل يُردُّ عليها بأنَّها دعوى المُحال كما ورد. لأنَّها ليست رأيًا فرعيًّا قد يُقال فيُطعن عليه بأنَّه قول بلا دليل، بل هي قول متى قِيْلَ لمْ يكن هناك إسلام من الأساس فهي دعوى المُحال -من الداخل الإسلاميّ كما أوضحنا-. أمَّا إذا قالها خارجٌ عن الإسلام فلا ضير فليقُلها وقد قال غيرُ المُسلمين عن المسلمين كلَّ ما يمكن قولُه من إفك وافتراء. أمَّا أنْ يقولها مُسلم ويعتقد -ولو بالاشتباه- بصحَّتها فهذا هو مدار الكلام الذي يجب إزالته بتنبيهه عليه وإنارة طريقه.
الدليل الثاني: إله واحد أمْ الله

هذا الدليل يُوجَّه إلى المسلمين -كما السابق- وإلى غير المسلمين. وهو وجوب الإيمان بـ”محمد” حتمًا دون غيره -أقصد في لحظتنا هذه فكلّ الرُّسُل يجب الإيمان بهم كما سلف-. فالإيمان بالله تعالى لا يستقيم إلا بالإيمان بمحمد؛ وذلك لأنَّ “الله” هو الإله الحقّ الأوحد الذي عرَّف نفسه لعباده في “القرآن الكريم” وعلى لسان سيدنا “محمد”. وليس أيُّ إله آخر -وإنْ كان واحدًا- هو “الله”.
ولذلك لا يمكن تعرُّف “الله” إلا عن طريق القرآن الذي نزل على “محمد”، ومن أقواله نفسِهِ لا من شيء غيره. وليست الدَّعوى بعبادة “إله واحد” من أيّ شخص، أو من المُغرضين القائلين بهذه الدعوى التي نناقشها عبادةً “لله” الواحد الأحد الذي يُوجب الإسلام الإيمان به. وها نُورِد أمثلة يسيرة من التاريخ تثبت بعض أديان عبادة “إله واحد” ليس هو “الله”.
يقول “معجم الحضارة المصريَّة القديمة” -الذي ألَّفه ستَّة من أكابر علماء المصريَّات الأجانب- عن “إخناتون” وديانته التوحيديَّة “الآتونيَّة”: “والحقيقة أنَّه أطلق على ذلك الإله الواحد اسم رع حور آختي الذي يبتهج في الأُفق باسمه الضوءُ الموجود في قُرص الشمس. وكانوا يعبدونه في معبد “البن بن”، وتنازَلَ بأنْ اتخذ صورة جسم الثور منيفيس”. فهذا إله واحد لكنَّه ليس “الله” -تعالى- الإله الموصوف عند المُسلمين.
وعند الفلاسفة مثلاً يقول د/ شريف مصباح في دراسته “المعرفة والألوهيَّة عند أفلاطون وأرسطو”:
يدور نظام أرسطو الفلسفيّ على مفهوم الحركة أو الصَّيْرُورَة، وقد ذهب أرسطو إلى أنَّ لهذا الوجود مُحرِّكًا أوَّلَ يُحرِّك هذا الكون وهو لا يتحرَّك.
وها هو أرسطو يؤمن بإله هو مَنشأ الكون -وليس خالقًا بالإرادة- وهذا التصوُّر لا يمتُّ بصلة إلى “الله” في الإسلام مع أنَّه يُرجع الأمر في الأخير إلى “إله واحد”.
وكذلك الحال عند اليهود والنصارى والعرب قبل الإسلام. فعند اليهود -بالكتاب الذي بين يديهم- إله واحد لكنَّه ليس الله، والنصارى تدَّعي أنَّ إلهها واحد -ذو ثلاثة أقانيم- وليس الله، والعرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أنَّ الإله واحد يُتوصَّلُ إليه بغيره. وعلى كلِّ هؤلاء ردَّ الإسلام بالمجيء والإتيان ليُعلمَ الجميع أنَّ “الله” -تعالى- ليس ما يدَّعون أو ما قد ألصقوا به.
فخُلاصة القول هنا خطأُ مَن يقول بأنَّ الاكتفاء يجب أنْ يكون بعبادة إله واحد بغضّ النَّظر عن “محمد” ورسالته. وهنا نسأل: أيُّ إله من هؤلاء -وهناك تصوُّرات توحيديَّة كثيرة غير التي عرضتها هنا- تعبد يا أيُّها القائل؟! .. أهو الإله الذي له شريك؟ أهو الإله الذي يتعب ويتضرَّر؟! أهو الإله الذي يتكوَّن من ثلاثة؟! أهو الإله الذي يتجلَّى في كلّ المظاهر -كما في عبادات الهندوس؟!
أم هو الإله المُطلق دون أيَّة تصوُّرات أو أوصاف أو أفعال كما عند التصوُّر الرُّبُوبيّ -ويسميه البعض الدِّين المُطلق-؟! .. وهنا يتقرَّر أمامك الأمر جليًّا من أنَّه يتحتَّم على كلّ أحد على ظهر البسيطة أنْ يؤمِن برسالة “محمد”، ودعوة “محمد”، و”الله” الذي أنزل “محمد”. وهو ما قرَّرتْه الآيات السابقة نفسه دون زيادة أو نقصان.
ولنا هُنا ملحوظة لطيفة: أنَّ هذه الأدلَّة العقليَّة السابقة نراها مُتضافرة تمامًا مع ما جاء في النصوص قبلها. فكما نرى بأعيُننا الأدلَّة في الإسلام مُتشابكة مُتفقة يؤدي دليلها العقليّ الصحيح إلى دليلها النقليّ الصريح.
دورنا أمام هذه الدعوى

يجب أنْ يكون للمُسلم دور فاعل في حياته هذا مطلب الإسلام منه. وأجلُّ دور للمُسلم هو الدعوة والإعلان. لذلك فلنعتبر أنفسنا أبواق دعوة إلى الصلاح والهُدى.
وبذلك يتوجَّب علينا أمران: فضح كلِّ مَن يقول بهذه الدعوى أو يحاول نشرها بين المُسلمين في نطاق ضيِّق أو في نطاق واسع، والتنبيه على فساد قوله ومعتقده.
والثاني هو اتخاذ الدليل على فساد الرأي -منها التي سبقت وغيرها- الذي به يدحض هذا الرأي لغيره. وفكرة اتخاذ الدليل والبناء المعرفيّ عمومًا هي الخطوة الأهمّ لنُكوِّن مُسلِمًا واعيًا مُحصَّنًا من الأقوال الفاسدة والمزاعم الخبيثة، ويكون هو بدوره لِبَنة بناء في وعيٍ إسلاميّ كامل يحقّ الحقَّ، ويمحق آراء المُبطِلِين.





مقال رائع نشكر جهودكم
عليه أفضل الصلاة والسلام أحسنتم