
كيف صنع المسلمون خير حضارة دون أن ينبهروا بفارس والروم؟
ما كادت تبدأ صفحة الثورة الصناعية الأوروبية إلا وتعالت معها موجةٌ من الأفكار والبواعثِ الفكرية التي انطلقت من مركزية الإنسان وحرّيته وحقه في التحرر الكامل، ومركزية كل ما هو مادي ملموس، وتهميش أي سلطة أو جانب روحي. ثم ما لبثت تلك الموجة إلا واختلطت بعقول لا يضبطها غير المصلحة الفردية؛ فربطت التقدم المادي بالتحرر الكامل من قيود الدين والأعراف بل والمصلحة الجمعية.
وسرعان ما تأثرت العقول؛ لتتغير معها النظرة الشاملة للحياة وضوابطها، حتى أضحى التقدم المادي والليبرالية والتنوير والفكر اليساري بل إن شئت فقلْ أيّ منتج صاغه العقل الغربي هو الموجة الفكرية الرائجة، والثقافة ذات السطوة على المشهد الفكري العالمي.
وفي خضم هذا، كان الفرد المسلم مُجرّدًا من صلته الوثيقة بالقرون الأولى، يتطلع بشغف إلى هذه الثورة ومكتسباتها؛ ما انعكس على ولعه بتقليد الغالب حضاريًا، فانبهر بتقدمه المادي، وهيَّأ نفسه كي لا يرى إلا ما هو مطبوع بشعار الثقافة الغربية؛ ما دفعه لاستيراد منظومة الغالب الفكرية والدينية؛ فسُحِق تحت عجلات التقدم المادي، وضاع في جنبات سطوة الثقافة الغالبة.
وحين تُعايشُ هذه الحال اليوم، فلا تتمالك نفسك من أن تنبهر بربعي بن عامر ذاك الشاب ذو الثياب الصفيقة. حينما دخل على رستم وهو جالس على سرير من ذهب، وعليه تاجه، وقد زينوا مجلسه بالنمارق والياقوت واللؤلؤ والزينة العظيمة. فلم يزل ربعي راكبًا فرسه القصيرة حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد.
وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق. فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمَن قَبِل ذلك قَبِلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله. فقال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم.
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟
أي عِزّة هذه التي امتلأ بها ربعي، وأي درع هذا الذي حصّن به قلبه، بل أي تربية هذه التي مكّنته من المرور على متاع الدنيا يدهسه بقدميه ورمحِه دون أن يلتفت له، ولا أن يحركه عن منهجه قيد أنملة.
فيعرض بعد هذا المشهد الفتّانِ ما جاء لعرضه، فيُحسن صياغة ما جاءت به رسالة الإسلام في عبارات تعلوها العزة، وتصحح موازين النظر، فتنقلب الأمور، وينبهر أصحابُ الثقافة الغالبة، بسطوة العزة والرجاحة في ثقافة هذا الذي استقلوا ثيابه الصفيقة حينما دخل عليهم؟!
وجه تسلط الثقافة الغالبة اليوم

وإنه لمَن أول ما تشاهده عين المُطالِع لعالمنا الإسلامي اليوم، هو الهزيمة الفكرية والنفسية التي حطَّت رحالها ببلادنا، والتي أدَّت ببعض الشباب إلى الحرج من عرض تفاصيل وأحكام وحدود الشريعة الإسلامية، بل حتى إن اللغة العربية أصبحت غير المقرونة منها بعبارات إنجليزية دليلًا على قلة المستوى الثقافي للمتحدث، وهذا الذي لا يكاد يخلو حديثه من عبارات إنجليزية هو رأس الهرم في الثقافة والفكر بل والمستوى الاجتماعي. وصارت مادة الولاء والبراء تُعقد على قدر “التمدن” والمنجز الحضاري الذي يستطيع الآخر تقديمه، فيسير الولاء في علاقة طردية مع التمدن الحضاري، والبراء في علاقة عكسية مع هذا العامل.
وتحت سطوة هذه الثقافة الغالبة يجد بعض بل كثير من المسلمين حرج من العاملين للإسلام اليوم، عند مقارنة منجزهم الثقافي وطبيعة حديثهم، بالمنجز الحضاري للثقافة الغربية، وبخاصة حينما يجد تلك المركزية الرصينة للآخرة في الخطاب الإسلامي، مقابل وسيلية الدنيا، فيميل لإحداث التصورات وفقًا لمنظور غربي رافضًا حتى مراجعة ثغراته وغاضًّا طرفه عمّا أُثبِت من مآلات هذه الأفكار والتي ظهرت جلية في الغرب يجاهدون هم للتخلص منها، ويجاهد بعض المسلمين لجلبها إلينا.
وفي مآلات الخطاب المدني يُبدع الشيخ إبراهيم السكران في وصف هذا التسلط للثقافة الغربية وأثره على كثير من المسلمين فيقول:
تَحوّل الوحي من حاكم على الحضارة إلى مجرد محامٍ عن منتجاتها، يبررها ويرافع عنها ولا يُقبل منه دور غير ذلك! وليس يخفى أن الحكم نوع من السيادة، أما المحاماة عن الغير فحالة تَبَع، يُقاس نجاحها بإمكانيات التبرير والتسويغ.
لماذا انبهروا؟
والحقيقة أن ليس ثمّة إشكال حقيقي في المنهج أو الخطاب الإسلامي يَحدُو بهؤلاء إلى الحرج من الدين الإسلامي ومحاولة تفسيره وفق منظور غربي، بل إن كثيرًا من الانحرافات المعاصرة في التعامل مع النص الشرعي ومحاولة تأويله لملاءمة الثقافة الغالبة، يقف خلفها محرِّك آخر، يكمن في نفوس المسلمين بعد هزيمتهم نفسيًا، يُسهم هذا المحرك في تشكيل القناعات والميزان الذي تُحاكَم إليه الثقافة والحضارة. ومن تأمل في كثير من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان فسيجد أنها عائدة إلى مركب من أربعة أمور:
-
هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي.
-
المغالاة في قيمة المدنية والحضارة.
-
الجهل بحقيقة الإسلام.
-
ضعف التسليم لله ورسوله–صلى الله عليه وسلم-.
يقول ابن خلدون في مقدمته: في أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده: والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال في مَن غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقادًا فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداء. ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير.
لماذا لم ينبهر الصحابة بفارس والروم؟

في صحيح البخاري: يصف عمر بن الخطاب حال النبي –صلى الله عليه وسلم–عندما دخل عليه فقال: وإنَّهُ لعَلى حَصِيرٍ ما بينَهُ وبينَهُ شيءٌ، وتحتَ رأسِهِ وسادةٌ من أَدَمٍ حشوُهَا ليفٌ، وإنَّ عندَ رجليْهِ قَرْظًا مصْبُوبًا، وعندَ رأسهَ أَهَبٌ معلقةٌ، فرأيتُ أثرَ الحصيرِ في جَنْبِهِ فبكيتُ، فقالَ: (ما يُبْكِيكَ). فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ كِسْرَى وقَيْصَرَ فيمَا همَا فيهِ، وأنتَ رسولُ اللهِ.
فلم يُرد النبي أن يطمئن عمر بن الخطاب بكلمات مرحلية، أو أنّ الله سيفتح عليهم غدًا أرضًا وبلادًا، ولكنّه أراد أن يربيه على منهج يستطيع معه أن يجابه ويصحح موازين النظر، وهو عمر الذي قال معاوية عن علاقته بالدنيا “وأمّا عمر فأرادته ولم يُردها“. ولم يرد عمر رضي الله عنه لنفسه شيئًا، وإنما أراد لرسول الله أن يكون له نصيبٌ من زينة الدنيا فهو رسول الله وأثر الحصير في جنبه، وقيصر وكسرى يتمرغون في نعم الله. فقالَ النبي–صلى الله عليه وسلم–ما يقطع أي نظرة انبهار بأيّ حضارةٍ غالبة:
(أمَا تَرْضَى أنْ تكونَ لهمْ الدنيا ولنَا الآخرةُ).
ومن هذا المبدأ يظهر لنا تلك التربية التي أسهمت في صياغة شخصية الصحابة رضوان الله عليهم، فصنعوا خير حضارة تعلَّم منها المشرق والمغرب، وفتحوا البلاد لينشروا دين الله، دون أن تدخل الدنيا قلوبهم، فهم وقَّافون عند حدود الله لا يتعدوها، ينظرون إلى الحضارة المادية في البلاد التي فتحوها بنظرة مستقيمة؛ فلا يتركوها كليّة ولا ينبهروا بها ويضعونها فوق قدرها، وإنما هي عندهم وسيلة لا تتعدى أبدًا لمكانة الغاية. وتتمثل تلك التربية في هذه النقاط:
التسليم والانقياد
فلم يكن لدى الصحابة موقف مسبق من غلبة هوى أو حظ نفس أو سلطة لثقافة غالبة قبل الإقدام على الوحي والنص الشرعي، وإنما كان إقدامهم إقدام المطيع الباحث عن الحق وعن مراد الله ومراد رسوله، والتسليم التام لما أمر أو حكم به، يقول تعالى:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ويتجلى هذا حينما نزلت آيات تحريم الخمر، وقد كان المشروب الرئيس عندهم، ويحكي أنس –رضي الله عنه–هذا المشهد البديع فيقول:
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمت. قال: فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة.
هكذا بدون تردد، بدون نقاش، بدون تأويل، بدون أن يسأل لربّما كان التحريم خاصًا بقوم دون قوم، بدون أن يعارض بأن التحريم كان خاصًا بالصلاة فقط كما كان سابقًا، ولا أن فارس والروم يشربونها فكيف سنفعل معهم حين يأتوننا زائرين… هكذا بكل تسليم وانقياد.. “اخرج فأهرقها، فخرجتُ فهرقتها”.
ولَمِنْ عظم تسليم الصحابة ما جاء في حادثة الإسراء والمعراج، حينما طارت العقول كيف أُسري بالنبي ثم أصبح بين ظهرانيهم، وعندها ظنّ المشركون أن المسلمين قد حُصِروا بهذه الحادثة، فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أُسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنَّه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة.
يا له من تسليم لم يقرنه الصِدِّيق سوى بالتأكُّد من صحة الخبر لأن رجالًا من المشركين هم من أخبروه، فقال “لئن قال ذلك لقد صدق“، لم يتساءل الصِدِّيق كيف هذا؟ لم يتحرّج من الصدع بالتصديق حتى وإن توقف العقل عن تصور المشهد، حتى وإن كانت سطوة قريش وهم لهم الغلبة تأبى هذا الخبر، لم يتأوَّله، لم يقل لربما رأى النبي ذلك في رؤيا، لم يفعل سوى التسليم موقوفًا على صحة الخبر.
امتلاء القلب بتعظيم الله ودينه
لطالما كان الانبهار مقرونًا بمحرّك خفي يقوّي هذا الشعور، ويزيد تحت وطأته سطوة الانبهار ليصل حدّ تشكيل القناعة فلا يقف الأمر عند مجرد الانبهار، ألا وهو “مركب النقص“. وهو ما لم يشعر به الصحابة أمام أموال ونفوذ قريش، ولا أمام حضارة فارس والروم. والسؤال هو لِمَ؟ ما الذي حمى الصحابة من الشعور بمركب النقص. لماذا لم يشعروا بمركب النقص والإمكانيات الحضارية المتكدسة أمامهم تفرض عليهم النقص، وبعبارة أخرى لِمَ لَمْ تبهرهم؟
والإجابة تكمن في التعظيم، لقد امتلأ قلب الصحابة بتعظيم منهجهم، وتعظيم أمر ربهم، وتعظيم ما عظّمه الشرع، وتحقير ما حقّره حتى وإن كان زينة الحياة الدنيا، إنه امتلاء القلب بمنهج الإسلام وعزته فلا يبقى في قلب الصحابي موضع أنملة لرؤية وتعظيم ما سواه، فيمر ربعي بن عامر على الوسائد والنمارق دون أن تحرك فيه شيئًا، لِمَ لا وقد تربّى على قوله تعالى: «أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»
وسيليّة العلوم المدنية ومركزية الآخرة
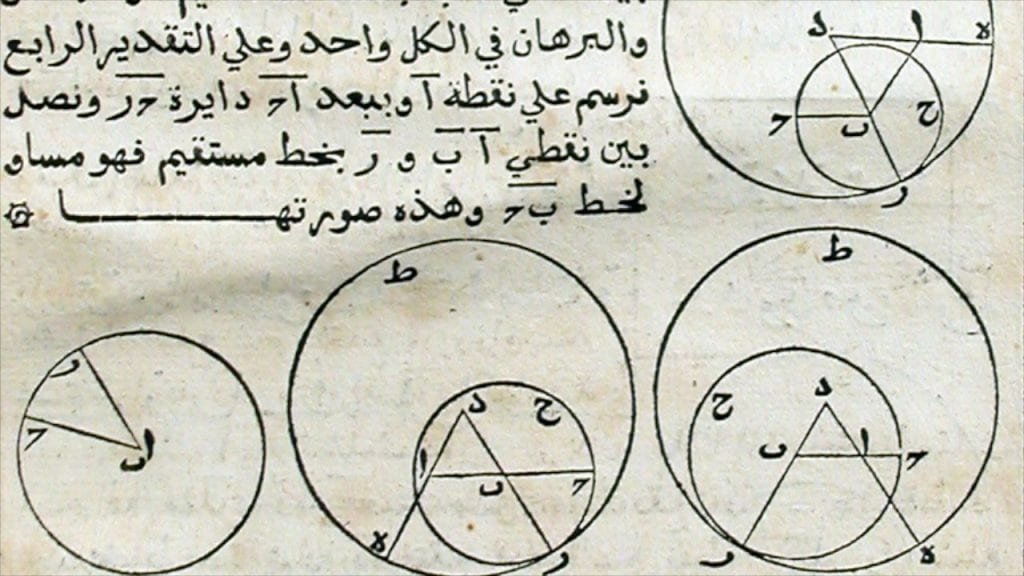
وفي مزلق الغاية من الدنيا ومكانة الحضارة المادية وقع كثير من المسلمين، في حين أن المُفتِّش في ترتيب أولويات الوحي وقضاياه المركزية، لا بد وأن يخرج بنتيجة مفادها أن الحضارة المادية ما هي إلا تبع، وأنها ليست قضيتنا المركزية التي خُلقننا من أجلها، وإنما نأخذ منها بقدر ما يحقق لنا سدّ الحاجة، وتحقيق المقاصد الشرعية بألا يعلو الغرب ولا غيره علينا.
وكم كان هذا المعنى حاضرًا في ذهن العلماء والأئمة، ومن باب أولى الصحابة والتابعين، يقول الإمام الشافعي عن مكانة علم الطب وأهميته وكذلك تقييد مكانه: (لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه). فقيده بأنه يأتي بعد الحلال والحرام، ونبل الطب كامن في أثره والحاجة إليه، ويتأسف لأن أهل الكتاب غلبونا عليه.
ولقد حسم القرآن مادة النزاع بشكل واضح، حينما نصّ على مركزية الآخرة، ووسيلية الدنيا، ما يمنع أي انبهار بتقدم حضاري ليس له غاية أو لا يسير وفق مظلة الشرع، فيقول تعالى:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
ورغم ذكر الله أنه أنعم عليهم بالتمكين في الأرض، إلا إن ذلك التمكين كان ابتلاءً وما أغنى عنهم من شيء حينما جحدوا بآيات الله وكذبوا بدينه.
وعلى هذا النحو تواترت آيات القرآن الكريم، في التعامل مع قضية الدنيا والآخرة، بل كم حقّر الله سبحانه من الدنيا، بل من أهل الحضارات أنفسهم حينما لم ينقادوا للشرع، فقال تعالى:
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ.
وقال تعالى:
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
فلم يعتبر الله لحضارتهم قدرًا حينما كفروا ولم يهتدوا.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
وحينما تحدّث سبحانه عن حال المؤمن قال:
رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.
وحينما حثّهم على عمارة الأرض وأمرهم بعدم الإفساد فيها، جعلها مرتبة تابعة للوحي لا تسبقه ولا تكون لها الأولوية عليه، بل هي خادمة له، يقول تعالى:
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.
فجاءت قضية الاستعمار في الأرض امتنانًا من الله، يستحق الشكر لا التقديم على دينه وشرعه، ومع هذا كان الحثّ النبوي على عمارة الأرض ونفع الناس، حتى وإن ظننت غياب الأثر ويأست منه، ظاهرًا جليًّا، حينما قال:
إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا.
وبهذه النظرة الشاملة للحياة الدنيا تنضبط رؤية المسلم، فلا يعطي المدنية والحضارة فوق قدرها فينبهر بثقافة أهل المدنية وسطوتهم ما يمنع عنه حتى مجرد مجاراتهم، لأن قلبه امتلأ تعظيمًا لهم ولحضارتهم وثقافتهم، ولا أن يترك الدنيا خرابًا فيُسبق ويكون لغيره يدٌ عليه في علم أو مادة يحتاج إليها.
فلا يكن في صدرك حرج منه

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
كتاب أُنزِل من عند الله، ونزل على رسوله وعمل به صلى الله عليه وسلم، وعمل به صحابته الكرام، وعمل به السلف من بعدهم، وتناقلته الأمّة بالقبول والانقياد، ولم يُعرف عنهم معارضة صريح أمره، ولا صريح ما جاء عن رسوله تبعًا لذوق أو ثقافة غالبة، ولم يجد الواحد فيهم ضيقًا ولا ثِقلًا في الصدع بأمر ربه وشرعته، حتى وإن خالف هواه، حتى وإن أبته نظرة الليبراليين القاصرة، حتى وإن رفضه الغرب أو الشرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: ففي الجملة: لا يكون الرجل مؤمنًا حتى يؤمن بالرسول إيمانًا جازمًا، ليس مشروطًا بعدم معارض، فمتي قال: أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنًا به، فهذا أصل عظيم تجب معرفته، فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاق.
وفي استحضار لمآلات إيقاف النص على عدم وجود معارض من ذي قوة أو سطوة وثقافة وحضارة غالبة، يقول ابن تيمية: “ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان“. ولسنا مأمورين بالخروج من الدنيا إلا بما أمرنا به ربنا ونبيه، وتحقيق الاستقامة كما أمر الله، لا كما جاء في قوانين وثقافة الغرب.
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
المصادر
- البداية والنهاية، الجزء السابع، غزوة القادسية.
- سلطة الثقافة الغالبة، إبراهيم السكران.
- درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية.
- ينبوع الغواية الفكرية، د. عبد الله العجيري.
- مآلات الخطاب المدني، إبراهيم السكران.
- معركة النص، د. فهد العجلان.
- دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين، مالك بن نبي.





وفقك الله لما احبه