
هل تقبل الديموقراطية والعلمانية الدين والتدين؟!
تقدم في المقال السابق الدين بين الإلحاد والتوحيد أن الدين منظومة متشابكة من العقائد والقيم والأخلاق والآداب والمعاملات، وخلصنا في المقال إلى أن كل المذاهب الفكرية والسياسية والفلسفية التي تؤسس للعقائد والأخلاق والآداب والمعاملات والقوانين هي في حقيقة الأمر أديان قائمة بذاتها عَلِمَ ذلك من عَلِمَه أو جَهِلَه من جَهِلَه، وعلى هذا فإنه لا يرتاب عاقل حصيف أن الديموقراطية دين قائم بذاته، وأن العلمانية دين قائم بذاته، وقل ذلك في الاشتراكية والشيوعية وسائر المذاهب والنحل بلا استثناء. وعلمنا أيضًا أن من يؤسسون لتلك المذاهب والفلسفات ويُنظِّرُون لها هم آلهة باطلة من دون الله، اتخذهم أتباعهم أربابًا من دون الله تمامًا كما اتخذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون من دون الله، وهم في بلاد الاسلام فوق ذلك يستدركون على أوامر الله ويعقبون على أحكامه ويردون قضاءَه الشرعي: فيقيدونَ ما أطلق الله ويطلقون ما قيد الله، ويخصصون عموميات الشريعة، ويعممون خصوصياتها! فهم بذلك آلهة باطلة وطواغيت بلا ريب.
وتقدم أن من طبيعة الدين ألا يقبل الأديان الأخرى، لما في الأديان من الثوابت والعقائد التي ينقض بعضها بعضًا، وينفي بعضها بعضًا، فإذا كان الإسلام والتوحيد يقر بالخالق الآمر الناهي، فإن الداروينية تنفي بشدة وجود الخالق العظيم، وتجعل الأمر والنهي للبشر في ملك الله! وهذه طبيعة الأديان: ولذلك أبطل الإسلام كل دين لأن طبيعة الدين ألا يقبل المزاحمة في شرائعه وعقائده.
وإذا علمنا أن الديموقراطية دين وأن العلمانية دين، عرفنا جواب السؤال في العنوان: هل تقبل الديموقراطية والعلمانية الدين والتدين؟ تمامًا كما نعرف أن الكفر لا يقبل الإسلام أبدًا.

ومع أن الجواب بعد هذا البيان واضح لا يخفى على من لم تتدنس فطرته، فإن كثيرًا ممن ينتسبون إلى الإسلام من المنهزمين نفسيًا –أو ربما من سماسرة الدين وتجاره- يبحثون عن نقطة التقاء وتوافق بين الإسلام والديموقراطية والعلمانية، ويبحثون عن مزايا الديموقراطية والعلمانية! وبعضهم يتحدث عن تفريغ الديموقراطية والعلمانية والتعددية من مضمونها مع الإبقاء على تلك الأسماء الكفرية! وهذا ترقيع خطير من شأنه تحريف الكلم عن مواضعه وتضليل الأجيال اللاحقة عن الأسماء الشرعية والمعاني الشرعية، زد على ذلك أن فيه إلباس أحكام الله بلبوس الألفاظ الكفرية والشركية، وهو ما حرصت الحنيفية السمحة على بيان المفاصلة فيه أشد الحرص، فنرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته يتحرى مخالفة أهل الشرك من جميع الأصناف في هديهم وسمتهم وعباداتهم امتثالًا لقوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، وأنزل الله تعالى كتابه الأخير مهيمنًا وشاهدًا على الكتب السابقة وحاكمًا عليها لا محكومًا، أرأيت إذا كان مهيمنًا على الشرائع السماوية السابقة وحاكمًا عليها أفيكون محكومًا بزبالات الأذهان من ديموقراطية واشتراكية وعلمانية وهي أقذرُ وأنتنُ ما تفتقت عنه الأذهان الشيطانية من الطواغيت وأعوانهم!
هذا من جهة الإجمال، وأما من وجه التفصيل فإن العلمانية البراغماتية إنما تستعمل الأديان لتحقيق مصالح “النخبة” المتسلطة التي تمتلك القوة والمال والإعلام والقانون والسلطة.
وبعبارة أخرى: فإن “النخبة المسيطرة” تستثمر في الدين، كما تستثمرُ في أي مشروع تجاري، ولا يهمها أن يكون مشروعًا حلالًا أو حرامًا، فقد تتاجر في الحروب وفي المخدرات وفي غيرها من الصفقات الشيطانية التي لم يَعُد بإمكانهم إخفارها مع الطفرة الحاصلة في وسائل التواصل، نعم، إن النخبة المسيطرة في العالم بفروعها قد تستثمر في الدين تمامًا كما تستثمر في أية صفقة أخرى، ثم تعود فتلغي المشروع أو تبيعه أو تغيرهُ إذا تعارض حكمٌ من أحكام الدين مع “مصالح” مستجدة!
وعليه، فإنَّ الديموقراطية تَخلُقُ –ومن الفراغ– بواسطة آلتها القانونية والإعلامية الضخمة جمهوراً من المرتزقة يُطالبونَ بـ “إلغاء” ذلك الحكم الشرعي الذي لم يعد يُناسبُ مصالحها، وهكذا، يَخْرُجُ من الظلام “شاذٌّ” من الشواذ، يطالبُ بحرية الشواذ، وبمساواة الشواذَّ مع الناس الطبيعيين! ثم لا تلبَثُ الآلاتُ الإعلامية الكاذبة الخاطئة، أن تستضيفه، ثم تقرعُ رؤوس الناس آناء الليل وأطراف النهار وعلى مدار سِنِينَ، في البرامج التافهة، التي تبدأ أول ما تبدأ بطرح الإشكال على نحو سؤال بريء، كسؤال: هل الشاذُّ إنسان طبيعي!

ومع ما في هذا السؤال السخيف من التناقض، فإن كثيرًا من الناس لا ينتبهون، وتأخذهم الحَمِيَّة، ويجيبون بلا أو يغضب أحدهم، ولا ينتبه إلى أن السؤال مدسوس وفاسدٌ من أساسه، فإن كل ما هو طبيعي لا يكون شاذًا، لأنَّ الشذوذ خروج عن الطبيعة! غيرَ أن الذي ينبغي أن يُفْطَنَ إليه أول مرة: هو أن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يُطرح أصلًا!
ولا تزال وسائل الإعلام الفاجرة تقرع رؤوس الناس بهذا الوحي الشيطاني -لعقدين من الزمن- حتى يَظْهَرَ إلى السطح جمهور من الشواذ، ثم على مدى السنين، وبغسيل الأدمغة المستمر، يتعاطفُ معهم السفهاء والسفلة والجهلة واللامبالين، فَيُرْفَعُ الموضوع إلى مجالس التشريع التي تَخْرُجُ بقانون يبيحُ الشذوذ، ويعتبرُ ذلك ممارسة شخصية، ويصيرُ إنكارُ ذلك جريمة!
وبهذا تتقلَّصُ رُقْعَةُ الدين، يومًا بعد يومٍ في المجتمع، ليَحْتلَّها الدينُ العلماني، فيحرم الإنكار على الشواذ، ثم يُجَرَّم، ثم يوصفُ ذلك بالعنصرية والإرهاب النفسي، وبالرُّهاب، وبما شئت من الأوصاف والكلمات التي تبرعُ في صياغتها وخُبْثِ توظيفها شياطين الإعلام!
وقلْ هذا في الحجاب، والنقاب، والمظاهر الإسلامية، والزواج والطلاق، والأطعمة والأشربة، والكُتب، والدراسات والعلوم والأعياد وغيرها من الشعائر الدينية.
فإن العلمانية لا تتردَّدُ أبدًا –إذا واتتها الظروف- في سَحْبِ البساط من تحت الدين في كل جزئية من جزئيات الشريعة، واستبدالها بأحكام الدين العلماني عبرَ خطوات شيطانية طويلة ومتوسطة الأمد لا يكاد يشعر بها أحد، لأن كل مرحلة قد تستغرق جيلًا كاملًا، وهكذا، حتى تُنْقَضَ كل عُرى الدِّين عُروة عروة، وتمضي الأجيال، فلا يشعرُ الجيل الحالي بشيءٍ مما مورسَ عليه من البغاء الإعلامي والتربوي والسياسي والفني والتشريعي حتَّى يَتَقَبَّلُ أنَّ الدين لا يزالُ غضًا طريًا، وأنَّ من العقائد الدينية أن الإنسان الشاذَّ إنسان طبيعي، وأن العري حرية شخصية، لكنَّ الحجابَ تضييقٌ وتزمت، والزواج تقييدٌ لحرية المرأة، والعهر حرية وتفَتُّح.
غيرَ أنَّ العجبَ الأكبر، هو أنْ تجد شخصًا –مغسولَ الدماغ- منتسبًا إلى الإسلام والمسلمين يُصَدّقُ أن العلمانية تَقْبَلُ الدين ولا تمنعُ التدين!
فنعيدُ ونكرر: العلمانية لا تقبلُ الدين، ولكنها تستثمرُ فيه من أجل إبطال ما بقيَ من أحكامه وآدابه، عبر الخطوات الآتية:
- خلقُ “الظاهرة اللادينية” المضادة للدين: كالشذوذ مثلًا.
- رفعُ الظاهرة اللادينية إلى وسائل الإعلام.
- إغراق المجتمع بالحديث عن الظاهرة اللادينية، بمختلف الوسائل: المقروءة والمسموعة وصفحات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة التدرج.
- خلق جمهور يتبنى الظاهرة اللادينية.
- التحريض على المظاهرات للمطالبة بتقنين الظاهرة، وإصدار التشريعات التي تحمي أصحابها.
- تشريع القوانين لصالح الظاهرة اللادينية.
وهذا على مراحل بعيدة وطيلة الأمد، وبهذا يرجعُ الدين إلى الوراء في انتظار ضربات علمانية جديدة! والله المستعان.
وبهذا يتبينُ جواب السؤال الذي افْتُتِحَ به المقال، وأن الكفرَ والشرك لا يمكنُ أن يكونا أبدًا طريقا لنشر الإسلام، ومن ظن هذا فهو ضعيف الرأي مطموس البصيرة ، قد حُجِبَ قلبه عن أصول الشريعة ومحكماتها كائنًا من كان، فإن أهم أركان الدعوة إلى دين الله وضوح الخطوط العريضة للقضية المدعو إليها، وقد أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يعلن المفاصلة الصريحة بين الكفر والشرك وبين الإسلام فأمره أن يقول ذلك فقال سبحانه: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ` لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)، وتوَعَّدَه وهو نبيه وخليله -صلى الله عليه وسلم- لو ركن إليهم شيئًا قليلًا بضعف العذاب فقال له: (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ` إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً)، ونهاه عن الركون إلى الظالمين فقال له: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ).
وللجواب على هذا السؤال وجوه أخرى قوية، وحسبُ اللبيب الإشارة، وإلا فمن تفكّر وأمعن النظر فإنه سيعلم علم اليقين من التاريخ ومن الواقع بل ومن شتى الجوانب المعرفية أنه من المستحيل أن تقبل العلمانية والديموقراطية بالدين أيًا كان هذا الدين فضلًا عن دين الإسلام الذي يقطع على مصاصي الدماء أرزاقهم.



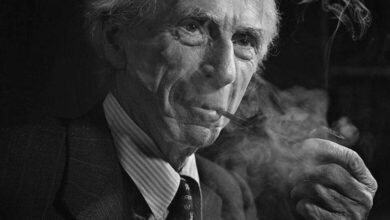

الديمقراطية هي تراجع عن الموقف الحازم تجاه الحاكمية الإلهية إلى الرجوع لرأي العامة فيها ثم تطبيقها، وإن لم يقبل فلا تطبق. لكنها لا تنفي ولا تضاد الدين على نحو قاطع.
أما العلمانية وهي المبادئ التي بدونها لا تكون الديمقراطية ديمقراطيةً (بالنسبة لمناصريها)، فهي النقيض الصريح لجوهر الإسلام، وغير الإسلام من الأديان سوى الإلحاد.
الديمقراطية والعلمانية كفر بالله العظيم