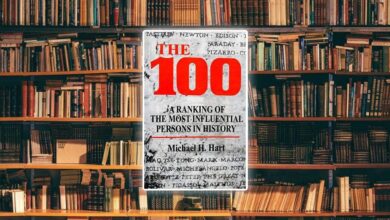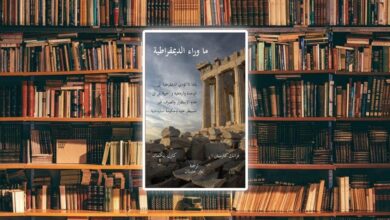الحضارة والمدنية.. وقفات مع كتاب مآلات الخطاب المدني
في كتابه مآلات الخطاب المدني يستعرض الباحث إبراهيم السكران ظاهرة انجذاب الشباب المسلم إلى الخطاب المدني والغلو في الرؤية المادية للحضارة والنهضة والذي أدى بهم إلى الانحراف الثقافي وأخذ موقف من التراث ومحاكمته بعيون غربية، وقد قدم رؤية وافية وأصيلة لسؤال الحضارة الذي شغل بال كثير من المفكرين والشباب حتى أوصل بعضهم إلى تبني الرؤية الغربية وجعلها أساسًا للانطلاق وميزانًا نزن به فكرنا وخطواتنا.
وهنا وقفات نشير فيها إلى مفاهيم أساسية تغيب عن كثير من شباب اليوم وقد يتقلبون بسبب ذلك بين شك أو اضطراب في الرؤية تعيق اتصالهم بأصول دينهم وتراثهم الفكري، وهي مفاهيم تستند إلى أصل في الوحي كتابًا وسنة ويمكن لمن أراد الدلائل المفصلة عليها أن يعود لكتاب الباحث ففيه البسط والتفصيل.
يبدأ هذا الانحراف من تغير مفهوم غائية الحياة أو وظيفة الإنسان في هذا الكون، فبعد أن كانت آية الذاريات حاضرة في الذهن إجابة لهذا السؤال لدى الأجيال المسلمة قبل بداية هذا القرن (وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، تغير الأمر مع دخول الإسلام مرحلة تلقى الضربات وأخذ موقف الدفاع وذلك بعد أن زُج به عمدًا إلى قفص الاتهام العالمي. وهنا تظهر ملامح الافتتان والانجذاب بالحضارة المادية، فلأنها صارت نموذجًا صارت الإجابة على سؤال الوظيفة ما هو أقرب إلى نموذج المادية السائدة، وهي العمارة والتمدن وتحقيق رفاة البشر وسعادتهم في مجالات الحياة الدنيوية من صناعة وطب وفن وغير ذلك. أما إجابة العبودية فقد توارت عند تلك الفئة من الشباب خلف دخان كثيف من التأويلات التي تناسب ذلك العصر وحضارته الغالبة.
ولقد بين القرآن بوضوح أن عمارة الأرض يقوم بها الإنسان إظهارًا لعبوديته لله، ووسيلة لتحقيق ما أمر الله به من عدل وإعزاز لدين الله، فهي وسيلة واجبة لإقامة دين الله وإظهار شعائره، بل إذا كان إظهار دين الله يتم بدونها فلا يجب أن تكون هي الهم الأول لأنها ليست هي الغاية من الوجود أو الحكمة المرادة من خلق الإنسان، ولذلك تأخذ الحضارة المادية في الوحي موقعًا تاليًا بعد إقامة الدين وإظهار شعائره، وتبليغ رسالته للعالمين.
يقرر القرآن في حديثه عن الدنيا خطرها ووقوعها في موضع الفتنة للخلق، فجاءت أكثر الآيات في ذمها وعدم الاغترار بها، ولم تدع إلى إعمارها أو جعلها معيارًا للنجاح والصلاح، ولعل هذا يعود إلى أن الإنسان بطبعه سينحو نحو تحسين ظروف معيشته وجعلها مهيأة لسعيه، بما وهبه الله مع علم وملكات ومواهب، وفى خضم هذا قد ينسى لم هو على الأرض أصلًا وما غاية وجوده، لذلك جاءت الآيات تذكره بالغاية وتحذره من الاغترار بمتع الدنيا الفانية التي لن تغني عنه شيئًا.
ومما يدعم تلك النظرة القرآنية ما ذكره الله عن مهمة الأنبياء وسبب إرسالهم إلى أقوامهم وصولًا إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، فلم تكن تلك الأقوام خالية من نوع من أنواع الحضارة المادية من صناعة أو تجارة أو عمارة أو فن وأدب، لكن ذلك لم ينف عنهم الجهل والضلال الذي وصفهم الله به واستوجبوا من أجله من يأتيهم بشيرًا ونذيرًا حاملًا رسالة الله بأن يتخذوا من دنياهم معبرًا للآخرة وأن يكفوا عن طغيانهم حتى لا يحل عليهم غضب الله فلن تغني عنهم عمارتهم وأبنيتهم وقصورهم من الله شيئًا. وقد عاصر نبينًا حضارتين ماديتين لكن أي منهما لم تكن مقياسًا للتقدم والنجاح، بل جاء القرآن داعيًا لهم للخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وقد فهم الصحابة هذا المعنى واضحًا فلم تفتنهم كنوز كسرى ولا قصور قيصر، وظلت كلمة ربعي الخالدة تهدر بهذا المعنى عبر السنين:
جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
وقد قضت سنة الله أن تكون لأعدائه قوة مادية ظاهرة فتنة للمؤمنين واختبارًا لصدقهم، إذ لو ظهر الحق قويًا من أول يومًا لما تلكأ أحد في إتباعه، فليس بدعًا من التاريخ أن نرى الآن تفوق الحضارة المادية التي لا تعرف الله أو تقيم له شرعًا، وإن كان واجب المسلمين في كل وقت أن يقيموا لهم قوة وحضارة تمكن لدينهم وتمنع وقوعهم مستعبدين لغيرهم. ومع استناد الحق إلى قوة الإيمان يخرج رجال أقوياء الروح والنفس لا يخشون في الله لومة لائم، بل إن هذا الإيمان الحي هو الذي يدفعهم إلى بناء حضارة مؤمنة، حضارة على منهج الله أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا تغفل الجانب المادي الذي يحقق الرفاه البشر لكنها لا تجعله الأساس ولا تغفل به عن مهمتها الأساسية في الأرض.
إذا كانت مقياس الحضارة هو التفوق المادي وحده، فإن هذه النظرة القاصرة ستصم عصر النبي وأصحابه بعصر التخلف عن ميدان الحضارة، أما نظرة القرآن ونبي الإسلام فتجعل عهد النبي وخلفاءه الراشدين هو عصر التأسي والاقتداء على رغم من بساطة الحياة وقلة المدنية، وجعل الخيرية متحققة في تلك العصور الأولى لأن المقصود الأول قد تحقق وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتبع ذلك أن سعد الإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم بالعدل والحرية والكرامة وغير ذلك مما تحققه شعائر الإسلام واتباع منهج الله وإقامته في الأرض.

لم يدع القرآن إلى التحضر وإقامة المدنية الكاملة بالمعنى المادي المجرد، بل دعا إلى اتخاذ وسائل القوة التي تمكن من إقامة شعائر الله وتحقيق العبودية وتبليغ دينه لخلقه، وقد فهم النبي وأصحابه من هذا التصور القرآني أن الآخرة هي المركز وأن عمارة الأرض وإقامة أسباب القوة فيها مرتبط بحفظ الدين ووصول الناس إلى معرفة ربهم معرفة تصل بهم إلى السعادة في الدار الآخرة. وقد حفظت هذه الرؤية المتزنة للقوة المادية المسلمين في قرونهم الأولى من الوقوع في الانبهار بما جاورهم أو سبقهم من حضارات، أو الاستمداد من مناهجهم الفكرية التي لا تستند إلى دليل ولا أصل لها في الوحي، وذلك رغم أخذهم بما احتاجوا إليه من وسائل وما انتفعوا به من علم طبيعي دنيوي من تلك الأمم والحضارات.
يظن المتأثرون بالحضارة المادية أنها حضارة إنسانية ترفع من الإنسان بلا تمييز بين أصله ومذهبه، وأنها حضارة خادمة للبشرية، راقية في تعاملها، والحق أنه لا توجد أمة لا تميز بين مواطنيها في مدى التزامهم بقوانينها وحسن تمذهبهم بمذهبها وتعدهم حينها مواطنين أكفاء مستحقين لأقصى درجات الاحترام والتقدير. فإن كان ذلك حال الدول والأمم التي قد لا توفر لمواطنيها حدًا أدنى من الاحتياجات، فما بال البعض يستنكف تمييز الله للمسلم عن الكافر كأنهم يدعون أن الله الخالق لا حق له في الحكم بين عباده، وذلك أثر من آثار النظر بعيون غربية أو بعيون بشرية قاصرة لا معيار لها. وإن العارف البصير بأحوال أمم الغرب ليدرك مدى صدق وصف الله لهم بالضلال والغي ما داموا بعيدين عن الوحي والهدى الذي يجعل الإنسان خلقًا آخر، وليس مبدعًا عظيمًا أمام الناس ومحطمًا ضائعًا في حياته الخاصة.
لكل اعتقاد وموقف وقول توابعه الفكرية ولوازمه التي تدفع إليه، لذلك فإن الاعتقاد بمركزية الحضارة المادية وغائية تعمير الأرض سيلزم صاحب الاعتقاد بالنظر نظرة دونية إلى خير القرون، وسيصدر حكمًا بأن المشكلة كامنة في تراث المسلمين وثقافتهم وليس في تخليهم عنها، وسيلجأ للبحث عن الحضارة والسيادة بطريقة عكسية خاطئة. لذلك لا غرابة أن ترى تلك الشكوك والشبهات الواهية تملأ عقل عدد لا بأس به من شبابنا، ليس عن علم أو بحث وإنما لأن الميزان الذي يزنون به دينهم ويحكمون به على تراثهم وقيمهم إنما هو ميزان الغرب ورؤية الغرب وثقافة الغرب صاحب التقدم المادي والإنتاج المعرفي الدنيوي الذي لا حظ له من علم الله فأنى يرضى وأنى يعرف قيمة ما ينتمي إليه.
فهل يعنى ذلك الرضا بحالة التخلف والإذلال التي يحياها المسلمون اليوم وعدم السعي لنهضة حضارية ترفع من شأنهم وتزيل عنهم ما هم فيه من بؤس وشقاء؟
لم يكن هذا أبدًا مقصد صاحب الدراسة وهو يرصد ظاهرة الانحراف الثقافي والمغالاة في الخطاب المدني من قبل المتأثرين بحضارة الغرب المادية، وليس هذا ما يوجه إليه هذا المقال، وإنما القصد أن توضع الأمور في نصابها وأن تكون حركة المسلم وفكره من قبل ورؤيته التي ينطلق منها نابعة من المصدر الأصيل الذي ينتمي إليه، من وحي السماء ومن المفاهيم التي غرسها النبي في نفوس أصحابه. أما العزة وإعداد القوة والتمكين في الأرض أو بناء الحضارة بتعبير العصر فهي وسائل لازمة تقدر بقدرها ولها أسسها وسننها وآلياتها في النفس والكون والحياة، فليأخذ بها من يريد، شرط ألا يبتعد عن المركز وألا ينهل من غير نبعه الأصيل.