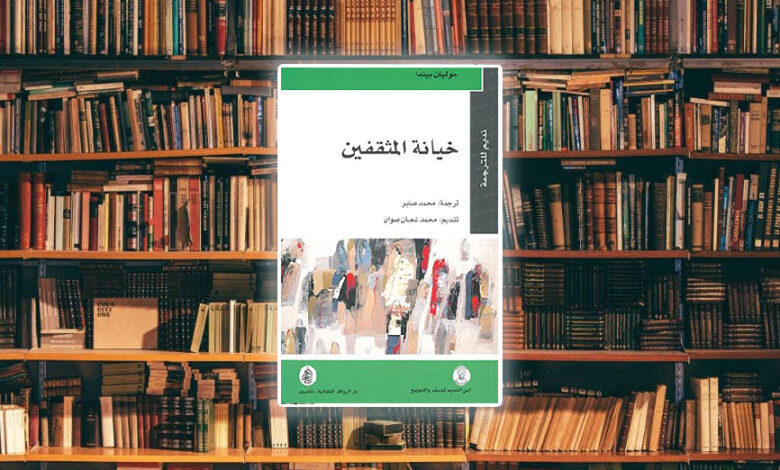
«خيانة المثقفين» لجوليان بيندا، والعودة للبراءة الأولى
تحرير: عبد المنعم أديب
يعدُّ كتاب خيانة المثقفين -كما وصفه “فرانسو ريفيل”- “واحدًا من أقوى المُناشدات من أجل استقلال لا مناص منه للمثقفين”. فهو -وإن كان يضعُ المثقفين في أروقة المحاكمة-؛ إلا أنَّه يرجو عودتهم إلى براءتهم الأولى.
وأعتقد أن كتاب خيانة المثقفين لا يُعنى بالمثقفين وحدهم؛ بل هو صرخة ومناشدة للإنسانية جمعاء من أجل العودة إلى فطرتها الأولى، والانتباه إلى قيمها الثابتة التي تحولت تحت “ما بعد الحداثة” إلى قيم سائلة نسبية خضعت باتفاق جماعي لما تقرره المنفعة والمصلحة!
فالقارئ للكتاب يُدرك أن من كان مَعنيًّا بهذه المحاكمة ليس المثقف وحده، بل الأسباب والظروف الاجتماعية والسياسية التي رسمت فيما بعد منظومة ما بعد الحداثة.
غياب المعيار الأخلاقيّ
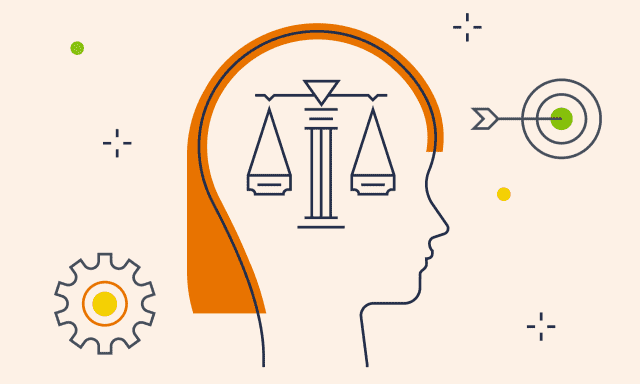
إنَّ من أهم ما رصده الكاتب هو التطور الفكري الذي ساهم فيه المثقفون من خلال فصل السياسية عن الأخلاق؛ فبعد أن كانت الأخلاق تحدد السياسة زمن أفلاطون، حتى عندما فصل ميكافيللي الأخلاق عن السياسية، ظلت معايير الشر في نظره شرًا، وظلَّ الخير خيرًا. وفي العصور السابقة كانت الأخلاق تنتهك، لكن ظل -مع ذلك- معناها واضحًا لا لبس فيه. ولكن ما حدث بعد ذلك بسبب تصاعد القوميات ونشوء الدولة الحديثة وتضخم البرغماتية، وظهور مذاهب فكرية (أكد وأشار الكاتب كثيرًا إلى كونها جِرمانيَّة) وإشاعة الإلحاد؛ أدت في النهاية لإضعاف القيمة الأخلاقية وإخضاعها للقوة؛ فلم تعد تستمد قيمتها من ذاتها، بل من نتاجها وآثارها ومدى منفعتها. فما حدث بعد ذلك لم يكن فقط فصلًا بين السياسة والأخلاق، بل أصبحت كما ذهب “موراس”: “السياسة هي التي تحدد الأخلاق”.
ولا يخفى على أحد أن الأمر لو استمر على هذا النحو، وضاعت كل معيارية ثابتة؛ فإن الأجيال اللاحقة ستذوب أخلاقها في تراب النسبية، وسيصبح بعد ذلك مجرد تعريف الخير أو الشر لغزًا محيرًا!
مشكلة الممارسة السياسية
تبدأ خيانة المثقف في نظر “بيندا” عندما اختلط المثقف بالعالم ومارس السياسة. ومن هنا أيضًا يتضح لنا أن هنالك إشكالية في فهم دور المثقف عند “بيندا”، ربما قد يعود سببها إلى زمن الكاتب. إضافة لسيطرة الرؤية المسيحية على كاتبه؛ فهو يُعرِّف المثقف: “هو الذي لا يسعى وراء المصالح والمكاسب بل يجد سعادته في ممارسة فن أو مزاولة علم أو البحث في نظريات ما وراء الطبيعية. وتتلخص سعادتهم -أيْ المثقفين- في الترفع عن ملذات الحياة .. هُم لسان حالهم يقول: إن مملكتي لا تنتمي لهذا العالم”.
وقد يبدو هذا التعريف متسقًا مع ما خرج به من تحليل، ولكنه سيسبب إشكالية إن أردنا التصحيح في أيامنا هذه. فبهذا المفهوم سيغدو مثقف اليوم ليس مُدجَّنًا وحسب، أو دمية في يد السلطة أو وزيرًا للحرب؛ بل سيغدو أيضًا حبيسًا في كهف أفلاطون. وهذا سيُعيق أية حركة بإمكانها أن تكون مسمارًا أو لوحًا في سفينة نوح التي عليها أن تُصنع على عين المثقف الصادق؛ لتقاوم طوفانًا يكاد يغرق العالم دون أن يشعر بالبلل.
خطر البراغماتية

ذكر الكاتب أن البراغماتية كانت نقطة في تحويل التاريخ الأخلاقي للإنسان: “البراغماتية هي فلسفة الذرائع، وهي مذهب فلسفي سياسي، يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة”. وقد ترتب عليها عدة مظاهر منها -كما يذكر الكاتب-: “تمجيد الحياة العسكرية والمشاعر المصاحبة لها، ونبذ الحياة المدنية وأخلاقها وتمجيد الدولة القوية. وما فعله المثقفون لتمجيد الدولة القوية هو: إثبات حقوق العادات والتاريخ والماضي من أجل مساندة أنظمة القوة.
وتمجيد السياسة القائمة على الخبرة؛ بمعنى أن المجتمع عليه أن يخضع لمبادئ أثبتت قدرتها على تحويله إلى دولة قوية، كذلك انتقاص قيمة المعرفة أمام قيمة العمل، وأيضًا كراهية الغرباء ورفض أي شخص وكرهه؛ لأنه من خارج الوطن واحتقار أي شيء ليس من داخله.
خيانة الأدباء
أما عن خيانة الأدباء فقد رصد “بيندا” الأسباب، وأرجعها إلى: تصاعد المذهب الرومانسي، وانتشار مذاهب فكرية أدت إلى الفصل بين ما هو حسي وما هو فني، ساهمت في اهتمام الأدباء بما هو فني وإهمال كل ما هو عقلي. فأدى ذلك برأيه إلى ظهور “عصر الفكاهة”. وهذا الأمر قد جعل من الصعوبة ظهور مفكر أدبي أو أديب مفكر.
نقد على نقده للقومية
يُؤخذ على “بيندا” أنَّه مع رفضه للقوميات وإيضاحه مدى هناتها، وكم أضاعت مواهبَ وفنونًا وأقامت حروبًا! إلا أنَّه مع ذلك ظل يصرّ على أن تصاعد القوميات لم تأتِ به سوى الفلسفة الألمانية، وهو بذلك دون أن يشعر وقع فيما يحذر منه. أضف إلى أن تصاعدها لم يكن ينتظر الفلسفة الألمانية، بل كان تصاعدها حتميًا. فلم يكن ساسة الحروب لينتظروها، ولا الشعب كان بانتظار قراءتها -ناهيك عن وعيها، وإن كان هذا لا ينفي أثرها-. وإن كنتُ أعتقد بكونها تفسيريةً بدايةً، أكثر من كونها دافعة ومحركة.
المثقف الصادق
يبدو أن صناعة المثقف الصادق عند “بيندا” صعبة هذه الأيام؛ لأن ما آل إليه المثقف هو نتيجة الظروف الاجتماعية والسياسية المفروضة عليه -على حد تعبيره-. لذلك فالشر الأكبر ليس خيانة المثقفين وحسب؛ بل صعوبة أن تحيا حياة المثقف في عالم اليوم.
ومما لا شك فيه أن هذه نظرة قد تميل للتشاؤمية على الرغم من كونها حقيقة أيضًا. ولكن هذا لا يعني أن على المثقف أن يبقى دميةً أو مُدجَّنًا أو غارقًا في القومية والوطنية على حساب مبادئه الإنسانية، عليه أن ينتمي للإنسانية أولًا -في نظره-. وليحقق ذلك عليه أن يجعل نفسه معيارًا (فما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره)، وأن يتبع الطريقة (التولستية) -نسبةً إلى “تولستوي” الروائي الروسي- في النضال؛ عليه أن يكون نبيًّا في قومه، وأن يكون نابض الحس الذي أشار إليه “بيغوفيتش”، حتى إن اقتضى ذلك نيله سياطًا كسياط “ابن حنبل” أو أن يجترع من ذات السم الذي اجترعه سقراط.
فإن كان المثقف قد ساهم في إثبات هذه المنظومة وانخرط فيها، حتى أصبحت هي الطبيعية. فآمل أن يكون المثقف -هو أيضًا- من يبني منظومةً تقف في وجهها، ويعود المثقف إلى براءته الأولى، وتعود القيم الأخلاقية إلى معاييرها الحقيقية والثابتة.




