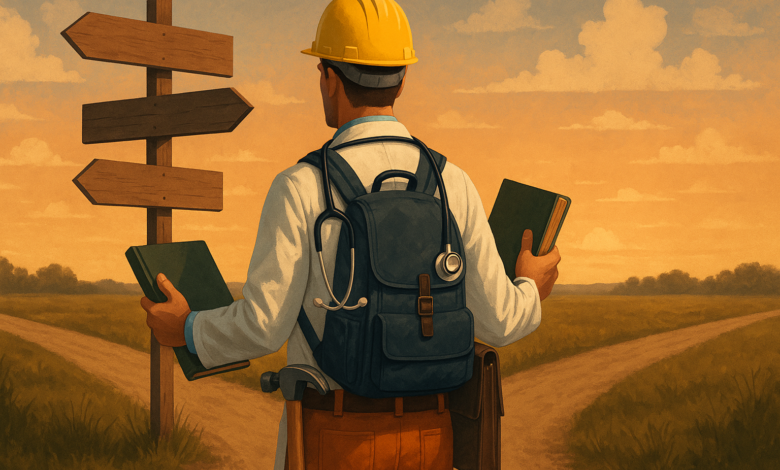
الوجهة الخاطئة: لماذا ضاعت جهودنا؟
تُقطع الأوصال والجسد حي تفور منه الدماء، واليدان أسلمت أمرها للسجان، والعينان شاردتان، تنظر مرة فتفزع وتصيح، وتغمض تارة حبسًا للآلام التي لا يوقف شدتها صمت ولا نسيان.. تلك الحال التي يذوب منها القلب كمدًا وحزنًا توجب لأهل الإيمان وقفات ومراجعات، ألم يقال لنا تعلموا علوم الدنيا لنكون أقوى وأعلى؟ ألم يدفعوا بالنساء لتشارك في الوظائف والقطاعات لكي نتقدم مثل غيرنا؟ ألم يُدفع بالشباب إلى تعلم اللغات والإدارة والحوسبة لكي يكونوا في مصاف من سبقهم؟ فأين نتاج ذلك كله؟ لماذا لم تتغير المعادلة ولماذا لم نر قوة ولا دفعًا ولا حتى غوثًا لمصاب؟
يخبرنا هذا الحال الأسيف أنّ السير كان باتجاه التيه وليس باتجاه الخروج منه، أنّ ما كنا نتعلمه ونصنعه إنما كنا نقوي به العدو، ولم نفعله لأنفسنا، فالقوة التي تخصنا أمر آخر، والقوة التي نحتاجها ليست أبحاثًا وأوراقًا وشركات وأرقامًا، بل هي قوة تضخ الروح في ذلك كله، هي أن يكون لكل تلك الحيوات؛ المدارس والجامعات والأعمال والتخصصات غاية جامعة، هدفًا تصب فيه، ومنهجًا يجمعها ويوجهها.
الرحلة المعاكسة.. تحديد الوجهة الصحيحة

كل ذلك لم يكن حاضرًا، بل كان هناك موجّه آخر وجامع آخر تنتهي إليه، وهو حياة الأفراد الخالية من القيمة والمعنى، أن تفرغ القلوب وتنطفئ الروح، وتظل الدائرة مغلقة على من يمسك بطرف خيط يشدها إليه ويبقيها في فلكه متجهة بلا وعي إليه! وعلى عكس القوة المتوهمة التي كانت تُسَّوق لاكتساب العلوم والتحصل على الشهادات وإدارة الأعمال والتوظيف في الشركات، فقد صار الضعف هو الغالب على أحوالنا، فقد سقمت القلوب واستشرت فيها أمراضها كالتحاسد والتباغض والأثرة، وكثرت تشوهات النفوس وأوجاعها من ضغوط وقلق ويأس وغير ذلك مما نعلم ونسمع.
إن أوقات الأزمات والاستضعاف والشدة المطبقة لأشد الأوقات احتياجًا إلى النظر لتحديد مكمن الخطر، فأوقات الاعتياد مظنة الغفلة والتأجيل وترك الأمور على ما هي عليه.
وكم من أمة أدركت في وقت هزيمتها واستضعافها سر القوة ومكمن الخطر، فأدارت الوجهة وأخذت قرارًا باستعادة الخيط وبدء الرحلة المعاكسة، ونحن نقرأ في التاريخ كيف قرر الغرب أن ينهضوا وأن يقفوا أمام قوة المسلمين الضاربة في عمقهم يوم سقطت أعز قلاعهم وحصونهم، يوم سقطت القسطنطينية وكان لها ما بعدها في تاريخهم وتاريخنا.
لكن الكلام يسقط ولا يجدي نفعًا إذا ظللنا نقول الأمة، ولا أمة ولا حتى جماعة، وقد قاد الغرب فلاسفتهم ومفكريهم وعلماؤهم، وأمتنا مقهورة بعزل علمائها وترهيب مفكريها، فإلى أن يُهيّئ الله لنا رجالًا وقادة، فالكلام والنداء هنا يستنفر كل فرد ليكون هو أمة بنفسه، ليختار لنفسه ما يظن أن ينجيه وينجي من معه، ما يمنحه قوة وصلابة بدل العجز والوهن والقيود المعطلة.
وقد تبين لنا أننا لا نجني من الخط المرسوم لنا قوة تدفعنا للعمل والإصلاح، وأن واجب الأفراد الخروج عن ذلك الخط أو تفريغه من أسلاكه المتشعبة وإعادة ملئه بما يتناسب مع حاجتنا؛ حتى لا يكون مرورنا فيه ضياعًا للأعمار والأوقات، ولكي لا تظل الدائرة تنتج نفوسًا لا تعرف حقيقتها ولا طريقتها فلا تحسن فعلًا ولا قولًا. فما الذي يمكننا به إعادة التناسق بين الغاية والأعمال الموصلة إليها؟
من التيه إلى البحث عن البوصلة.. 4 عناصر أساسية
لم يكن للأمة يوم ارتقت وتألقت إلا إيمانها وإلا وحي ربها المنزل إليها، فمنه تعرفت على مصادر قوتها، وبه فهمت دورها وأحسنت القيام به، ولو تتبعنا بعض آيات القرآن التي تحثنا على العمل والسعي، وتحدد لنا معيار القبول وموجبات التأييد والعون الإلهي لوجدنا أنها لا تغفل أربعة عناصر أساسية: الأصل الذي ينطلق منه الإنسان، والوجهة التي يقصدها بعمله، وحقيقة العمل نفسه، وغايته أو أثره المترتب عليه.
الأصل المنطلَق: الإيمان الذي يحرك العمل
ونعني به الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا نقصد هنا الإيمان المبدئي الذي يسمى به الإنسان مسلمًا، بل إيمان يقين وتسليم، إيمانًا يحرك النفوس فيجعلها تقدم ما لله على ما لنفسها وللدنيا {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [التوبة: 44]، قال السعدي: «ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخر، لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان، يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلًا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر»1.
نحن نبحث عن حضور هذا اليوم في النفس حضورًا يجعل متعة الانغماس في الألعاب الإلكترونية أو تناول وجبة من شركة تسهم في اقتصاد الأعداء تنقلب نفورًا وبغضًا، ويجعل وقت المسلم الدائر بين جدال فارغ وشكوى دائمة يتحول إلى دعوة إلى خير أو كف للأذى عن إخوانه، لما وقر في حسه أنه مسؤول ومحاسب، وأن كتاب أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.
ليس ذلك فحسب، بل إن يقينه بربه وإيمانه بغيب الآخرة يحمله على أن يرى ما لا يراه الآخرون الذين لا يبصرون إلا الأسباب المادية؛ فيكون في سعيه ورؤيته للعمل الواجب مرتكزًا على بُعدٍ إيماني، ونظرٍ قلبي؛ يحرضه على استسهال الصعب، وعلى ترك المنكرات، وعلى السير فيما ترجح أنه حق وإن خالفه الأكثرون.
الوجهة المقصودة: النية والإخلاص

إذا كان البعد الإيماني يجب أن يكون حاضرًا في عمل الإنسان وفي تقديره للأمور من حيث الأصل، لكنه ينسى وينخرط في الحياة المعاصرة بمظاهرها المخالفة في كثير منها لمقاصد الدين، فإن مُساءلة الإنسان نفسه عن النية والقصد يجب أن تكون أشد حضورًا في حركته، وفي رحلة حياته على اختلاف مراحلها.
والإخلاص وإن كان شرطًا أساسيًا لقبول العبادات لا يكاد يجهله أحد لما ورد عليه من التأكيد في الكتاب: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) [صحيح البخاري: 1]، إلا أن حصره في الشعائر والعبادات الظاهرة دون تعميمه في جميع تفاصيل الحياة صغيرها وكبيرها؛ مما عزز الفصل بين الدين والحياة وجعل كثيرًا من المسلمين يستلهمون حياة الغرب بدلًا من أن يصبوا في حياتهم معنى التسليم والتوجه لله في كل حركات الحياة مصداقًا لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
فالذي يحسم أمره ويقرر الهجرة لبلد غربي لا يسمح له بإظهار شعائر دينه، هل راجع قصده وعرف وجهته ورضي بها؟ هل وضعها على ميزان الحق ووجدها تتسق مع ما يريده الله لعباده، أم قد تشكلت وجهته واستند في قراره إلى معطيات كثيرة تشابكت وتعقدت فاختار منها مَظهرًا يشعر معه بالرضا والقبول؟!
والتي تختار لنفسها مجالًا معينًا وتبذل فيه غاية وقتها وجهدها، هل راجعت الوجهة والمقصد؟! إنه لأمر ثقيل على النفس أن تبحث في أعماقها عما يصّرفها إلى هذا أو ذاك، لكنه ضروري؛ لكي يحافظ المسلم على استقامته، وعلى اتساقه الداخلي، وعلى الصدق الذي يحب أن يلقى به ربه.
ونتاج هذه الوجهة إذا اتسمت بالإخلاص لله وحده وتزينت بالصدق الذي يرفع قيمة العمل وقيمة صاحبه، أن تنتفي كثير من مظاهر الفساد والإفساد في الحياة المعاصرة، فالمخلص سيعمل ما يرضي ربه؛ لأنه يرى نظر ربه إليه، وإن تجاهل الناس عمله أو صدوه عنه، فبمجموع المخلصين ترتفع هذه الأمة وتتقدم على غيرها من أهل الأهواء حتى تسبق بمسافات بعيدة بتأييد ربها لها: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [الزمر: 33].
النية وحدها لا تكفي.. صلاح العمل وتمحيصه

كما حددنا بوصلة العمل وعرفنا من نرجو بأعمالنا، يحتاج العامل أن يعرف طبيعة عمله، وأن ينظر إليه مشفقًا وَجِلًا، يرى هل هذا العمل جاء وفقًا لمعايير الوحي، أم مخالفًا لها؟ والنية الصالحة حَريةٌ أن تقود إلى صلاح العمل وشرعيته، لكنها لا تكفي وحدها أن تكون إطارًا بلا حقيقة، فكم من عائل أسرة نيته القيام بواجبه في رعايتهم وكفايتهم والقيام بحقوقهم، لكنه لا يراعي أكان نصف ماله قد لبسته شبهة الأكل الحرام بتحايل أو غش أو غبن أم قد سلم من ذلك؟! وكم رأينا من يضيع أبناءه بوضعهم في بيئات أو مدارس تخالف عقيدتهم وهويتهم، وهو يظن أنه بذلك يُصلحهم ويهيئ لهم مستقبلًا مشرقًا؟!
ولكل مجال حدوده وضوابطه الشرعية التي ينبغي فهمها ومراعاتها وتنزيلها على واقع الحياة ومتغيراتها، ولا يكون ذلك إلا بعلم صحيح يؤخذ من أهل الفقه والعلم، أو بالاستفتاء والسؤال المباشر عما يعرض من أمور وإشكالات. وتعلم الجوانب الشرعية المختصة بمجال العمل مما لا ينبغي للمسلم جهله، فلا يليق بمسلم أن يذهب للمدارس والجامعات فيدرس بها كل شيء مما قد لا يحتاج إليه أبدًا، لكنه لا يدرس ولا يتعلم ما يخصه في مجال عمله من الأمور الشرعية التي أنزلها الله وأمرنا باتباعها وسيسأل عنها.
وإذا كان المرء يمكنه أن يزعم لنفسه أنه صادق ومخلص، فتلك نية في القلب لا يعلم بها أحد إلا الله، إلا أن تمحيص العمل نفسه من شوائب الإثم وما فيه من شر ظاهر أو خفي لمن العسير في هذا الزمان لما غلب على الواقع من عزل للدين عن غالب المجالات، حتى أن الدين نفسه صار مجردًا عن حقيقته في كثير من الأحيان.
لقد أصبح من يريد استبقاء فطرته وفطرة بنيه نقية صالحة يعاني في غالب أمره؛ الأب مثلًا في اختيار مدرسة يتعلم فيها أبناؤه أو نظام يحقق له ما يريد من تعليم سوي نافع لهم، والطالب وقت تخرجه من المدرسة أو الجامعة وما يحيط بذلك من إشكالات يزيد بسببها الخرق وتشتد الغربة والمعاناة، والزوج والزوجة في تأسيس بيت يحقق السكن ولا يفجر الصراع.
وهنا يجب أن تكون المقاومة الحقة، مقاومة التيار الذي يسحبنا من جديد في الدائرة التي نريد الخروج منها، فإنسان هذا العصر لابد سيصيبه من الرذاذ ما لا يحب شاء أم أبى، فيكفيه ذلك الرذاذ بما يحمل من ملوثات تفعل فعلها في النفوس إذا ضعفت ووهنت، لكنه إن رضي أن يبقى داخل تلك الدائرة، صعبت عليه المواجهة، بل أصبح مدافعًا عنها، مظهرًا لمزاياها، ليحفظ نفسه أن تنقسم بين رؤيتين متناقضتين للحياة، والغاية المرادة لها.
التقوى والإصلاح.. غاية العمل وأثره
لو نظرنا إلى مقاصد العبادات الشرعية لوجدنا أنها تهدف جميعًا إلى التحقق بالتقوى والتخلق بصفات أهل الإيمان، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21]، وإذا كان غاية الخلق أصلًا هي العبادة بمفهومها الشامل لكل مظاهر الحياة، فواجب المسلم أن يحقق بعمله كله التقوى في نفسه وأن يترتب على عمله صلاح وإصلاح لغيره: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]. وليس الأمر بالقول والادعاء، بل هو ما يظهر أثره وتُرى نتيجته، فكم من الأعمال والمجالات والمكاسب ما يترتب عليه فساد في الدين أو الخلق، أو تضييع الأوقات والانشغال بالتوافه أو إثارة الخلافات أو غير ذلك ويزعم أصحابها أنهم بناة مصلحون؟! تمامًا كما أخبرنا ربنا عن أمثالهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: 11].
لذلك لا يقبل الله عمل من فعل خيرًا، لكنه أفسده بالمن والأذى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} [البقرة: 264]، ولا من كان ظاهر عمله خيرًا وهو يقصد به الوقيعة والفتنة: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ} [التوبة: 107]، ولا من عمل أعمالًا ذات شهرة وبريق، وتطلق عليها الأسماء والأوصاف ذات الشأن، لكنها تفسد القلوب والعقول ولو بدون قصد متعمد، ولا تحقق منفعة إلا لخصوم الأمة وأعدائها، وهذا ما نشهده بكثرة في أيامنا، بل نحن غارقون فيه منذ دخلنا جحر الضب وصرنا نقيس الحق والخير والمنفعة والمصلحة على ميزان غير ميزاننا فاختل كل شيء بعدها وتغيرت مراتب الأشياء ومضامينها.
فتضييع الأوقات إلى جانب تضييع الأخلاق هو الفن والإبداع والنجاح، وتصرف له الأموال والطاقات والجوائز، بينما مشاريع الإصلاح أو التربية أو تنمية الموارد الطبيعية وغير ذلك مما لا يجد اهتمامًا ولا يلتفت إليه أصلًا.
فواجب المسلم في هذه المرحلة بعد أن يتأكد أن العمل نفسه لا يتضمن إثمًا أو ينتهي إلى الاندماج مع واقع مخالف لدينه، أو إلى مسايرة الباطل تأثرًا أو إعجابًا، أن ينظر في أثر عمله وما يترتب عليه إن كان ينفع نفسه وأهله حقيقة أم لا ينتفع به غير من يتربصون به وبأمته ويحبون لها أن تظل على حالتها من الضعف والهوان الذي لا يرضاه الله لنا.
كما نحتاج وعي المسلم بما يجب في زمانه ووقته، فقد يكون عمله مقبولًا لو كان في زمن ووقت آخر لا تتكالب علينا فيه أمم الكفر والعدوان، بينما هو اليوم مما يزيد الآلام ويمنع التئام الجراحات.
خاتمة: مسؤولية الفرد قبل الأمة
لقد حرص الإسلام أن يجعل أفراده فاعلين مسؤولين، يرى كل واحد منهم كيف ينفع أمته أو يصرف عنها ما يسوؤها، ولو كان كفًا لأذاه عن غيره من المسلمين، أو كسبًا لقوت يومه مما أحله الله، أو تعاونًا على بر وصلاح وتقوى، ورفضًا للمنكر، وبعدًا عنه وعن أهله.
وإننا وإن كنا لا نعفي أصحاب المناصب والمسؤولين من واجبهم في حماية ثغور الأمة وليس فقط حفظها مما يتهددها، بل ورعايتها والنهوض بها لتقوم بدورها في إقامة العدل ورد الناس إلى الحق، إلا أن غياب هذا الدور يعد اختبارًا للأفراد في حمل أماناتهم، والعمل الذي يوصلهم إلى صلاح أحوالهم وصلاح حال أمتهم.
وإن كان الأمل ببلوغ ما نرجوه بعيدًا، إلا أن حسبنا أن نقوم بما نسعد أن نراه يوم يقدم كل منا على ربه ولسان حاله، اجتهدت أن أجعل سيري صالحًا نافعًا على صراط مستقيم.
هوامش
- تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي. ↩︎




