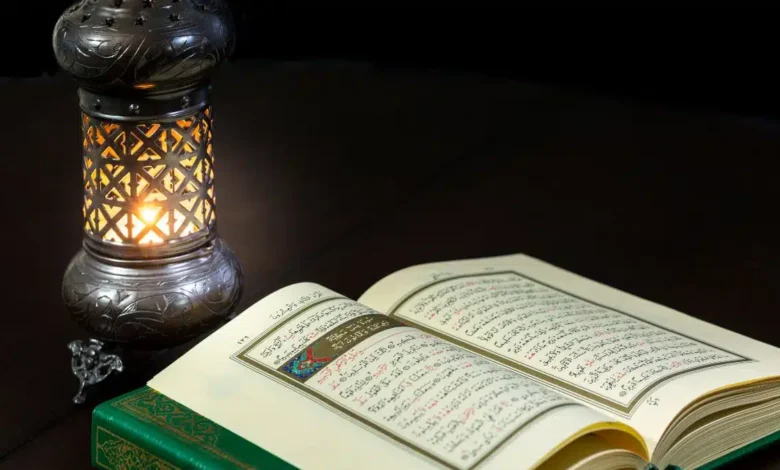
كيف عالج القرآن عقلية “الأبيض والأسود”؟
لقد أسس القرآن الكريم قواعد تمكّن المسلم من الموازنة بين المواقف ومقاربتها، وتُعزز من تكوين عقلية مرنة تستطيع استيعاب وجمع مواقف متعددة دون الشعور بالتناقض، ودون إنزال الأمور في غير مواضعها، أو الظن بأنّ هذا الفعل يخالف الشريعة، وينبذ في العديد من المواقف العقلية الحديّة أو ما يمكن التعبير عنها بـ”عقلية الأبيض والأسود”، تلك العقلية الجامدة التي لا تستطيع استيعاب وتحليل المواقف المتفاوتة أو الجمع بين بعض الأمور التي تبدو من المتناقضات، ولا يمكنها التفريق بين القطعيات والظنيات، مما يؤول إلى إشكالات ضخمة تصل أحيانا إلى الوقوع في بعض الكبائر -كالتكفير وغيره- بسبب عدم امتلاك هذه العقلية.
كيف عالج القرآن الكريم هذا الإشكال؟
ورد في كتاب الله تعالى العديد من النماذج التي تعالج إشكالية العقلية الحديّة، وسلك سُبلًا متعددة لعلاجها، ومن أهم هذه السُبل هو عرض فئة ما وتقرير حقيقة اعتقادها بجلاءٍ تام، ثم ذكرها في مقام آخر، هذا المقام له بُعد متصل بالموازنات الواقعية؛ ومن ثَمَّ إعطاء توجيه فيه مساحة أوسع من مقام التقرير، وسنعرج في هذا المقال على نموذجين.
النموذج الأول: التعامل مع خلافات الكافرين

ذكر الله تعالى في عدة مواضع من كتابه بجلاء تام كفر أهل الكتاب، وعند مواطن الحديث عن النصارى أبطل زعمهم بأنّ الله ثالث ثلاثة، فقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: ٧٣]، وزعمهم بأنّ الله هو المسيح ابن مريم، فقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: ١٧].
وزاد تبارك وتعالى متوعدًا: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢]، وفنّد افتراءهم بأن عيسى ابن الله -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وغير ذلك من الأمور التي جاءت في بعض المواطن كالصواعق المرسلة، كموضع سورة مريم حينما قال الله تعالى عن عِظَم فُحش القول بأنّ عيسى ابن الله: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا}[مريم: 90-91]، ونهى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١]، فجاء تبيان الموقف العقدي في غاية الوضوح والقوة.
لكن عندما حارب النصارى (الروم) المجوسَ (الفرس)؛ نجد أنّ الله -جل وعلا- يتحدث عن الحرب بينهما، ويُبشِّر المؤمنين بأنّ الروم ستنتصر على الفرس في الجولة القادمة، ثم يذكر سبحانه وتعالى بوضوح شعور المسلمين بهذا النصر، وهو الفرح: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ} [الروم: 4-5]؛ لأن الروم أقرب في عقيدتهم إلى المسلمين، «عن عكرِمة، أنّ الروم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض، قالوا: وأدنى الأرض يومئذ أَذْرعات، بها التقَوا، فهُزِمت الروم، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ وأصحابه وهم بمكة، فشقَّ ذلك عليهم، وكان النبيّ ﷺ يكره أن يظهر الأميُّون من المجوس على أهل الكتاب من الروم، ففرح الكفار بمكة وشمتوا، فلقوا أصحاب النبيّ ﷺ، فقالوا: إنكم أهل الكتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أمِّيُّون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنّ عليكم، فأنزل الله: {الم *غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ…} [الروم: 1-4]».1
فعند الانتقال إلى ساحة التعاملات الواقعية وجّه القرآن المسلمين نحو إدراك منازل الكفر، فهناك كافر، وهناك أشد كفرًا، وهناك عدو، وهناك أشد عدواة، فثمة بعيد وثمة أبعد، وهكذا.
لذا؛ عندما تقاتل الفرس والروم ذكر الله تعالى هذا الموقف ولم يتجاوزه، ولم يأمر المسلمين بالفرح في الفئتين، أو الدعاء بهلاك الظالمين بالظالمين، أو اتباع سياسة عدم الانحياز، وإنما ذكر شعورهم مسبقًا قبل وقوع الحدث ليكن بعدها بمنزلة الأمر، وهو الفرح عندما ينتصر الكافر على الأشد كفرًا.
هذا، ولم يكن يخفى على الله عز وجل -وحاشاه سبحانه- أنّ الحروب بين المسلمين والروم ستكون من أشد وأعنف الحروب التي سيخوضها المسلمون، وسيقتلون عشرات الآلاف من المسلمين، ولكن هذا لم يمنع من الفرح بانتصارهم على من هم أشد كفرًا، ولا يتعارض مع كون الحرب القادمة -بعد الفرس- كانت معهم بداية من سرية مؤتة في العام الثامن من الهجرة.
النموذج القرآني الثاني: التعامل مع خلافات المؤمنين
وكذا سنجد موازنة أخرى، لكنها أكثر دقة وخطورة، وهي التعامل بين المؤمنين، سنجد أنّ الله تعالى أسس التعامل بين المؤمنين على الأخوة، فقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات ١٠]، «هذا عقدٌ عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان، في مشرق الأرض ومغربها، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبي ﷺ آمرًا بحقوق الأخوة الإيمانية: ((لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره))، وقال ﷺ: ((المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضًا)) وشبك ﷺ بين أصابعه»،2 وهناك عشرات النصوص الأخرى في الكتاب والسنة توثق العلاقة بين المؤمنين، وتجعل الولاء بينهم من القضايا العظمى في الدين.
ومع ذلك لم يُغفل القرآن الكريم طبيعة النفس البشرية وأزَّ الشياطين الذي يمكن أن يوقع خلاف بين المؤمنين يصل إلى حد القتال، لذا نجد الإرشاد الإلهي إذا وقع اقتتال بين طائفتين من المؤمنين، فقد قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩]، فنجد أنّ الله تعالى لم يأمر المسلمين باعتزال القتال بين الفئتين، لكنه أمر بالسعي في الصلح بينهما، فإن أبَوْا فقتال الفئة الباغية حتى تُرَدّ عن بغيها، «والمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين، فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم، ويدعوهم إلى حكم الله. فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى، ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه، ولم تتأثر بالنصيحة وأبت الإجابة إلى حكم الله تعالى، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية، حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه وكتابه»،3 فأصبح قتال بعض المسلمين في هذه الحالة هو الصواب بل والأمر الإلهي.
ثم يأتي تقويم الله -جل وعلا- لنفوس المؤمنين، لعلمه أنّ النفس يصعب عليها العدل وقد اعتلجت بالضغينة والغضب “ولَمّا كانَ الخِصامُ يَجُرُّ في الغالِبِ مِنَ القَوْلِ والفِعْلِ ما يُورِثُ لِلْمُصْلِحِينَ إحْنَةً عَلى بَعْضِ المُتَخاصِمِينَ، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلى المَيْلِ مَعَ بَعْضٍ عَلى بَعْضٍ، قالَ: ﴿بِالعَدْلِ﴾ ولا يَحْمِلُكُمُ القِتالُ عَلى الحِقْدِ عَلى المُتَقاتِلِينَ فَتَحِيفُوا. ولَمّا كانَ العَدْلُ في مِثْلِ ذَلِكَ شَدِيدًا عَلى النُّفُوسِ لما تَحَمَّلَتْ مِنَ الضَّغائِنِ قالَ تَعالى: ﴿وأقْسِطُوا﴾ أيْ: وأزِيلُوا القَسْطَ (بِالفَتْحِ) -وهو الجَوْرُ- بِأنْ تَفْعَلُوا القِسْطَ (بِالكَسْرِ) وهو العَدْلُ العَظِيمُ الَّذِي لا جَوْرَ فِيهِ، في ذَلِكَ وفي جَمِيعِ أُمُورِكُمْ، ثُمَّ عَلَّلَهُ تَرْغِيبًا فِيهِ بِقَوْلِهِ مُؤَكِّدًا تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ مِن أعْظَمِ ما يُتَمادَحُ بِهِ، ورَدًّا عَلى مَن لَعَلَّهُ يَقُولُ: إنَّهُ لا يُلْزِمُ نَفْسَهُ الوُقُوفَ عِنْدَهُ إلّا ضَعِيفٌ: ﴿إنَّ اللَّهَ﴾ أيِ: الَّذِي بِيَدِهِ النَّصْرُ والخِذْلانُ ﴿يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ أيْ: يَفْعَلُ مَعَ أهْلِ العَدْلِ مِنَ الإكْرامِ فِعْلَ المُحِبِّ.”[البقاعي]. فأسس تبارك وتعالى أصول التعامل بين المسلمين، لكنه سبحانه وتعالى لم يترك الاحتمالات الواقعية الواردة في التعامل بينهم، لئلا يُظَن أنّ طرق التعامل والإصلاح واحدة دومًا.
لماذا شاعت هذه العقلية في عصرنا؟
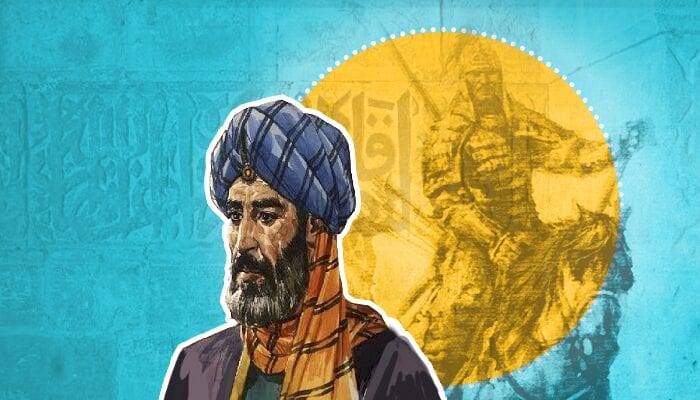
سنجد في تراثنا أمثلة لشخصيات كثيرة جمعت بين البدعة والإجرام والفتوحات والبطولات، لا سيما في العصرَين الأموي والعباسي، فنجد أنّ المعتصم كان من روّاد محنة خلق القرآن، وامتحن الناس في دينهم، لكنه كان بطلًا مغوارًا في فتح عمورية، وكذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل وصلب عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن ذات النطاقين رضي الله عنها، وقصف الكعبة، وقتل آلاف المسلمين ظلمًا وعدوانًا، رغم ذلك كانت له فتوحات عظيمة لا ينكرها أحد، فليس جديدًا علينا وجود شخصيات جدلية تحمل بين جنبيها متناقضات متعددة.
ولعل من أسباب تفاقم الجدل حول هذه الأمور في أمتنا حالة التشتت التي تعرضت لها في القرن الماضي بعد انهيار الخلافة العثمانية، ثم وقوع حروب كبرى تشكل على إثرها النظام العالمي الجديد المرتكز على أفكار تُهدد الهوية الإسلامية، بل وتهدف إلى استئصالها، فنشأ عدد من الحركات الإصلاحية كرد فعل لهذه التغيرات الضخمة، واتجه عددٌ منها نحو الاستمساك بأصول الدين وفروعه في خضم حرب الهوية هذه.
ولم يكن هنالك إشكال في هذا الخيار في تلك الحقبة، لكن المشكلة حصلت عندما أفرز هذا التوجه في بعض السياقات عقلية جامدة لا تستطيع النظر في الأمور والمتغيرات ولا تستطيع الموازنة بينها، فإما أن يكون الحق بيّنًا أبيضًا ناصعًا، وإلا نُلقي به جميعًا عرض الحائط إذا شابهُ بعض السواد، وهذا أسلوب غريب على عقلية المسلم التي استقت منهجها من الكتاب والسنة.
وثمة نصوص نفيسة لبعض الأئمة تُعالج هذا الإشكال، أذكر منها نصًا لابن تيمية -رحمه الله تعالى- حيث يقول: «قد يقترن بالحسناتِ سيئاتٌ: إما مغفورة أو غير مغفورة. وقد يتعذَّر أو يتعسر على السالك سلوكُ الطريق المشروعة المحضة إلا بنوعٍ من المحدَث لعدم القائم بالطريق المشروعة علمًا وعمًلا. فإذا لم يحصل النور الصافي: بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظُّلْمَة = فلا ينبغي أن يعيب الرجلُ وينهى عن نور فيه ظُلْمة، إلا إذا حصل نورٌ لا ظلمةَ فيه. وإلا فكم مِمَّن عَدَلَ عن ذلك = يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظُّلْمَة».4
فبسبب فوات إدراك هذه القاعدة عند البعض، نتج العديد من اتجاهات الغلوّ بأنواعها المختلفة، وبرزت العديد من الآراء الشاذة عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الأكابر، وانبثقت تنازعات مهولة بين فئات من المسلمين.
إشكالية خلط الأوراق في تقييم القضايا

من الإشكالات الكبرى الناتجة عن تلك العقلية والتي تظهر بجلاء في العديد من النقاشات إشكالية: “خلط الأوراق”، فعند الحديث عن قضية ما مرتبطة بمساحة الواقع التي أتاحت الشريعة فيها توازنات متعددة لا تتعارض مع أصل التقرير العقدي، تجد من يريد إسقاط أية موازنات ويحتج ببدعية وإجرام وضلال أحد أطراف المعادلة ليتخذها دليلًا على قوله، وكثيرًا ما تكون خلفية القول عائدة إلى مواقف مسبقة، ودوافع نفسية، وثمة شريحة كبيرة من أحاديّي النظر -ذوي نيّاتٍ حسنة- يظنون أنّ التشبث بالموقف الحدّي براءةً من ظلم الظالم بغض النظر عن موقعه في هذه الكَرّة، فيفرّون إلى الحسم مخافة أن يقعوا في موالاة الظلمة، فالأمر ليس اجتهادًا متجردًا لبلوغ الحق قدر الإمكان، وهذه الأمور مؤثرة في التقييم العام لهذه الفئة من حيث الأصل والمبدأ، لكن من حيث موازنات الواقع -كاقتتال إحدى الفرق البدعية التي ولغت في دماء المسلمين (الرافضة) مع عدوٍ صائل مجرم كافر صريح أكثر قوة وخطورة وهيمنة (الصهاينة)- سنجد مساحة أخرى يمكن النظر من خلالها لا سيما ما يتعلق بالسياسة الشرعية.
وهكذا، «حيث تقرر أنّ العلاقة مع المخالفين -بما فيهم المبتدعة- مبناها على قواعد المصالح والمفاسد، فإنّ هذا لا يقتصر على العلاقة السلبية وهي إعمال الهجر أو عدمه، وإنما يتجاوزه إلى العلاقة الإيجابية البناءة، وهي التعاون معه على وجوه البر؛ حسب ما تقتضيه القاعدة الكلية في اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه ليست خاصة بالمبتدع، وإنما تنتظم مع كل مخالف.
وأخطأ قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المبتدع ممنوعة في كل حال على كل شخص، بناءً على اعتقادهم أنّ سبب المنع نص يحرم ذلك؛ كنص تحريم الكذب والغيبة، والصحيح ما تقرر في هذه الرسالة من أنّ ذلك مبني على السياسة الشرعية وقاعدة المصالح والمفاسد؛ فما أنتجه إعمالها وجب أو جاز العمل به والمصير إليه، ولا يختص التعامل مع المبتدع بذلك؛ بل هو شامل لكل ما لم يرد فيه نص بالمنع أو الإباحة، وحصل فيه التعارض بين المصالح والمفاسد عند العمل به».5
خاتمة: نحو عقلية قرآنية متوازنة

ثمة مغالطات محدودة التأثير في الواقع ولا تمتد إلا لمساحات ضيقة، لكن هناك إشكالات أخرى متشابكة ذات تأثير ونفوذ واسع في العديد من القضايا، لذا؛ فإنّ الاهتمام والعناية بها، والتأصيل لعلاجها من خلال منهج الشريعة من الأمور التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي إذا تم استيعابها، ويمكنها التقليل من حدة الخلافات الرائجة على الساحة اليوم، لذا أحسب أنّ هذا الطرح مهم لأنه يبرز كيف أنّ الإسلام قادر على الجمع بين الموقف العقائدي الواضح، والمرونة في التعامل مع الواقع المعقد.
أسأل الله أن يُبَّلِّغ هذه الأمة رشدها.




